الوحدات الدراسية في سلكي الإجازة والماستر: توصيف ومنهاج
تقديم
منذ التحاقي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان كأستاذ مساعد داخل شعبة اللغة العربية (2020)، لم آلُ جهداً في تجويد الوحدات الدراسية التي أوكلت إليّ في سلكي الإجازة والماستر (السرد الحديث، المسرح، الشعر الحديث، نظرية الأدب، النقد الثقافي، جمالية التلقي..) من خلال عدة ديداكتيكية تراعي مدخلات الطلبة ومكتسباتهم بقدر ما تعمل على رفع كفاياتهم المختلفة وتثمينها عبر بعض الأنشطة المنجزة (محاضرات، عروض وأعمال تطبيقية، مناقشات، لقاءات تأطير أثناء إنجاز بحوث نهاية الدروس…)، كما انخرطتً في الأنشطة البيداغوجية الموازية داخل الكلية (ندوات، لقاءات مع أدباء..)، التي تعزز المحكّ المعرفي والتواصلي، وتساهم في تأطير هؤلاء الطلبة وتشبع فضولهم للمعرفة بقدر ما حفزهم على البحث عنها وتحصيلها بطرق مُيسّرة وذات جاذبية، ومواكبتهم – حضوريّاً أو عن بعد- لتذليل صعوبات هذا البحث طوال فترات إعداده، مستثمراً ما راكمته من خبرة في مجال التدريس والتواصل التربوي أثناء عملي في التعليم الثانوي التأهيلي لأكثر من عقدين من الزمن (1997- 2020)، ومستحضراً الفلسفة العامة التي يقوم عليها التنزيل البيداغوجي للوحدات المبرمجة بشعبة اللغة العربية في سياق الدرس الجامعي. وقد أوليت في سبيل تحقيق هذه المرامي والكفايات المتنوعة (لغوية، تواصلية، ثقافية، معرفية واستراتيجية)، لعملية التقويم بأنواعه (الأولي، التكويني، الختامي) ما تستحقّه من أهمية خاصة وذات اعتبار في مجموع الأنشطة والتدخلات التي أعددتها أو أشرفت عليها أو كنتُ طرفًا فيها، على نحو يتجاوز طرق التلقين التقليدية ويحقق أبعاد القراءة التفاعلية والتعاون التأويلي بحسب خصوصية هذا النشاط أو ذاك معرفيّاً وديداكتيكيّاً.
1. أنشطة التدريس
1.1. الفصل الثاني:
• وحدة الشعر الحديث
محاور الوحدة
تقديم؛
لحظات الشعرية العربية (تاريخ موجز)؛
انطلاق الحركة الشعرية الحديثة وعوامل نشأتها التاريخية والسوسيوثقافية؛
بدايات الشعر الحر وأنماطه؛
الشعر الحر ظاهرة عروضية؛
الخصائص المضمونية والفنية: الاغتراب، الالتزام، الانزياح، استخدام الرموز والأقنعة، النزعة الدرامية، بناء القصيدة الحديثة؛
الاتجاهات الأساسية التي ميّزت حركة الحداثة الشعرية وعبرت عن صراع إيديولوجي وجمالي (رومانسي، يساري ماركسي، قومي، وجودي، سوريالي، صوفي..)؛
تلقّي الشعر الحديث وظاهرة الغموض؛
نشأة الشعر المغربي الحديث وتطوره؛
الشعر النسائي: من خارج النسق إلى إثبات الذات والاحتفاء بالجسد.
توصيف الوحدة
تهدف هذه الوحدة الدراسية إلى:
– التعريف بحركة الحداثة الشعرية في المجال العربي، وقيمتها في إعادة النظر في مسائل الشعور والرؤية للعالم.
– ضبط مفاهيم الخطاب الشعري وعناصره الأساسية (القصيدة، الإيقاع، اللغة، الانزياح، البناء، الرؤيا..)؛
– التمييز بين أشكال الشعر العربي (عمودي، تفعيلي، نثري، وجيز..)؛
– رصد أبرز الاتجاهات الأساسية التي شهدتها القصيدة العربية خلال القرن العشرين وبدايات الألفية الجديدة، وما رافقها من تحولات جمالية وفنية (رومانسي، واقعي، وجودي، قومي…)؛
– استيعاب القيم الأساسية التي دافع عنها الشعراء المحدثون في المشرق والمغرب (قيم سيرذاتية، وطنية، ثقافية، إنسانية وكونية)، والمساهمة في تنميتها من خلال تفاعل الطالب مع النصوص الشعرية وتذوّقها؛
– إقدار الطالب على تحليل النصوص الشعرية، والتمييز بين أساليبها واتجاهاتها ومرجعياتها، انطلاقاً من مفاهيم وأطر نظرية ومنهجية محددة، وعلى على التفكير والتمييز والاستدلال والمقارنة أثناء التحليل النصي أو عند إنجاز مشاريعه البحثية الخاصة، وكذلك على التعبير بلغة أدبية في مقامات تواصلية معينة تجسد الشغف بالشعر وتشفُّ عن حس إنساني سليم.
منهجية التدريس
نظراً لخصوصية الوحدة، فإنّ تدريسها يتوزع بين ما هو نظري، وتطبيقي، وتقويمي.
• نظريّاً؛ تقريب الطالب من الأطر المعرفية والمرجعية التي أحاطت بولادة الشعر العربي وأثرت في نشأته وتطويره (المثاقفة، الحداثة، ضرورة التغيير..)، ومن أبرز الأسس الفنية والموضوعية التي قام عليها هذا الشعر الذي نهضت به حركة الشعر الحر في بادئ الأمر، قبل أن يتطور في اتجاهات أخرى.
• تطبيقيّاً؛ تحليل النصوص الشعرية الأكثر تمثيلية في كل مرحلة من تطور الوعاء الزمني- المعرفي للوحدة، وإشراك الطلبة في تذوّقها وتنمية حسّهم المشترك تجاه ما تطرحه من قيم ورؤى شخصية أو جماعية، وإقدارهم على فهمها وتأويلها بشكل متعاون يعزز ميولهم الإيجابية.
• تقويميّاً؛ توجيه الطلبة فرادى وجماعات لإنجاز بعض الأنشطة المتعلقة بالوحدة، والتي تتوزع بين بسط مشكلات وقضايا نظرية، وبين تحليل نصوص شعرية من خلال مفهوم أو خاصية فنية مركزية (الذات والآخر، الالتزام، الإيقاع، الانزياح، رؤية العالم..)، وعرضها على الأستاذ من أجل تقويمها قبل تقديمها في حصة حضورية لإشراك الطلبة في مناقشتها والإفادة منها.
وإذن، تتوزع مهام تدريس الوحدة بين مطلبين أساسيين؛ إغناء رصيد المعرفة الشعرية، واكتساب القدرات المهارية المطلوبة أثناء تحليل النصوص الشعرية، أو عند إنجاز المشاريع الشخصية، بقدر ما تتوزع طرق تصريفها ضمن الوسائل البيداغوجية المتاحة (سبورة إلكترونية، كتب، وثائق..).
المراجع المعتمدة:
– إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، فبراير 1978.
– أحمد المعداوي، ظاهرة الشعر الحديث، دار المدارس، ط.2، 2007.
– أدونيس (علي أحمد سعيد)، زمن الشعر، دار الفكر، ط.5، 1986.
– حاتم الصكر، مرايا نرسيس: الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المؤسسة الجامعية، للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، ط.1، 1419هـ-1999م.
– خالدة سعيد، حركية الإبداع، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت- لبنان، ط.1، 1979.
– السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث: مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، دار المعارف، ط.2، 1983.
– صلاح بوسريف، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، دار أفريقيا الشرق، الدارالبيضاء، ط.1، 2012.
– صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت – لبنان، ط.1، 1995.
– علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، الشركة العامة للنشر والتوزيع، ليبيا ـ طرابلس 1978.
عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ط.4، 2002.
– عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: ظواهره وقضاياه الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت، ط.5، 1988.
– غالي شكري، شعرنا الحديث…إلى أين؟، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط.2، 1978.
– عبد الله راجع، القصيدة المغربية المعاصرة: بنية الشهادة والاستشهاد، منشورات عيون، الدار البيضاء، ط.1، 1987.
– عبد الله الغذامي، الصوت القديم الجديد: دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، ط.1، 1420هـ- 1999م.
– عبد اللطيف الوراري: في راهن الشعر المغربي: من الجيل إلى الحساسية، دار التوحيدي، الرباط، ط.1، 2014.
الشرفة والرماد: دراسات في الشعر العربي وقضاياه، دار أبجد، العراق، ط.1، 2022.
– عبد الواسع الحميري، الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والوزيع، ط.1، 1419هـ-1999م.
– علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي، دار فضاءات، عمان- الأردن، ط.1، 2013.
– كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت- لبنان، ط.1، 1987.
– كمال خير بك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دار المشرق، بيروت، ط.1، 1982.
– نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط.3، 1967.
– محسن جاسم الموسوي، مسارات القصيدة العربية المعاصرة، ترجمة أحمد بوحسن، دار توبقال للنشر، الدارالبيضاء، ط.1، 2017.
– محمد بنيس: -ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب، دار التنوير، بيروت، ط.2، 1985.
الشعر العربي الحديث. بنياته وإبدالاتها، الجزء 3: الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، الدارالبيضاء- المغرب، ط.2، 1996.
– يوسف الخال، الحداثة في الشعر، دار الطليعة، بيروت- لبنان، 1978.
نموذج امتحان الشعر الحديث
2.1. الفصل الثالث:
• وحدة السرد الحديث
محاور الوحدة
تقديم؛
تعريف السرد لغةً واصطلاحًا، وتحديد مكونات الخطاب السردي؛
تعريف أجناس السرد الحديث من قصة ورواية وسيرة ذاتية؛
النهضة العربية وبدايات السرد العربي الحديث؛
– الكتابات السردية ذات الخطاب التراثي
– الكتابات التي تستلهم النموذج الغربي
مراحل تطوّر السرد الحديث؛
• تكوُّن الخطاب الروائي (1905- 1914)
• نحو ترسيخ فنّ الرواية (1914-1943)
• تأصيل الرواية العربية (1945-1960)
• تجديد الخطاب الروائي (1960-1980)
• تجريب آليات السرد القصصي والروائي منذ عقد الثمانينيات؛
اتجاهات الرواية العربية الحديثة: رواية التسلية والترفيه، الرواية التعليميّة، الرواية التاريخية، الرواية الرومانسية، الرواية الواقعية والاجتماعية، رواية تيار الوعي، الرواية الطليعية/ التجريبية؛
السرد النسائي العربي الحديث: من المساكنة إلى تقويض النسق الذكوري وتجسيد الرؤية الأنثوية للعالم؛
الرواية المغاربية: تاريخ موجز؛
الرواية المغربية: أصول، اتجاهات وأنواع؛
تعريف السيرة الذاتية ومكوناتها؛
السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث: نشأة وتطور؛
دراسة نماذج تطبيقية من نصوص السرد العربي الحديث والمعاصر:
• « رحلة جبلية، رحلة صعبة » لفدوى طوقان
• « المصري » لمحمد أنقار
• « ققنس » أحمد بوزفور.
توصيف الوحدة
تهدف هذه الوحدة الدراسية إلى:
-ضبط مفاهيم الخطاب السردي وعناصر تكوّنه الأساسية؛
– التمييز بين أجناس السرد الحديث (رواية، قصة قصيرة، سيرة ذاتية..)؛
– التعريف ببدايات السرد الحديث في المجال العربي، والعوامل التاريخية والسوسيوثقافية المؤثرة التي أحاطت بها.
– رصد أبرز المراحل والاتجاهات الأساسية التي عرفها السرد العربي الحديث خلال القرن العشرين في المشرق والمغرب، وما رافقه من تحولات جمالية وفنية؛
– تثمين المدونة السردية النسائية وفاعليّتها في تخطي النسق الذكوري وتجسيد رؤية أنثوية للعالم؛
– إقدار الطالب على تحليل النصوص السردية، والتمييز بين أساليبها واتجاهاتها ومرجعياتها، انطلاقاً من مفاهيم وأطر نظرية ومنهجية محددة، وعلى على التفكير والتمييز والاستدلال والمقارنة أثناء التحليل النصي أو عند إنجاز مشاريعه البحثية الخاصة.
منهجية التدريس
نظراً لخصوصية الوحدة، فإنّ تدريسها يتوزع بين ما هو نظري، وتطبيقي، وتقويمي.
• نظريّاً؛ تقريب الطالب من الأطر المعرفية والمرجعية التي أحاطت بولادة السرد العربي الحديث وأثرت في نشأته وتطوره (المثاقفة، الحداثة، ضرورة التغيير..)، والموضوعات والأسس الفنية التي قام عليها قبل أن يتطور في اتجاهات أخرى.
• تطبيقيّاً؛ تحليل النصوص السردية الأكثر تمثيلية في كل مرحلة من تطور الوعاء الزمني- المعرفي للوحدة، وإشراك الطلبة في تذوّقها وتنمية حسّهم المشترك تجاه ما تطرحه من قيم ورؤى شخصية أو جماعية، وإقدارهم على فهمها وتأويلها بشكل متعاون يعزز ميولهم الإيجابية.
• تقويميّاً؛ توجيه الطلبة فرادى وجماعات لإنجاز بعض الأنشطة المتعلقة بالوحدة، والتي تتوزع بين بسط مشكلات وقضايا نظرية، وبين تحليل نصوص سردية من خلال مفهوم أو خاصية فنية مركزية (استلهام التراث السردي، تحولات شخصية البطل، أساليب السرد، جماليات السرد النسائي، البناء الفني، الرؤية الإيديولوجية أو الجمالية للعالم، التوتر بين المرجعي والتخييلي..)، وعرضها على الأستاذ من أجل تقويمها قبل تقديمها في حصة حضورية لإشراك الطلبة في مناقشتها والإفادة منها.
وإذن، تتوزع مهام تدريس الوحدة بين مطلبين أساسيين؛ إغناء رصيد المعرفة السردية، واكتساب القدرات المهارية المطلوبة أثناء تحليل النصوص القصصية والروائية والسيرذاتية، أو عند إنجاز المشاريع الشخصية، بقدر ما تتوزع طرق تصريفها ضمن الوسائل البيداغوجية المتاحة (سبورة إلكترونية، كتب، وثائق..).
المراجع المعتمدة:
– عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، قنديل للطباعة والنشر- دبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت، ط.1، 2016.
– السعيد الورقي، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1982م.
– عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة، الطبعة الثالثة، دار المعارف، 1976م.
– محمد مصطفى هدارة، دراسات في نثر العربي الحديث، جامعة الإسكندرية، مصر، 1992م.
– عبد الرحمن بوعلي، المغامرة الروائية: بحث في تشكيل الرواية العربية وتطورها في الأدب العربي الحديث، منشورات ضفاف، وجدة، ط.2، 2004.
– أنماط الرواية العربية الجديدة، شكري عزيز الماضي، سلسلة عالم المعرفة، 355، سبتمبر 2008.
– زهور كرام، السرد النسائي العربي، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط1، 2004.
– رشيدة بنمسعود، جمالية السرد النسائي شركة المدارس، الدار البيضاء، ط1، 2006.
– رشا ناصر العلي، ثقافة النسق: قراءة في السرد النسوي المعاصر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2010.
– سعاد الناصر، السرد النسائي العربي بين قلق السؤال وغواية الحكي، مكتبة سلمى الثقافية، تطوان، ط.1، 2014.
– حميد لحميداني، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي. دراسة بنيوية تكوينية، دار الثقافة، ط.1، 1985.
– سعيد يقطين، القراءة والتجربة. حول التجريب في الخطاب الروائي بالمغرب، دار الثقافة، ط.1، 1985.
– حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي. الزمن -الفضاء- الشخصية، المركز الثقافي العربي، ط.1، 1990.
– سعيد بنكراد، الهوية السردية.. المحكي بين التخييل والتاريخ، المركز الثقافي للكتاب، ط.1، 2023.
– عثماني الميلود، التخييل موضوعا للتفكير، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط.1، 2022.
– عمر حلي، البوح والكتابة: دراسة في السيرة الذاتية في الأدب العربي، مجموعة البحث الأكاديمي في الأدب الشخصي، مطبعة وليلي، مراكش، ط.3، 2002.
– جليلة الطريطر، مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، مؤسسة النشر الجامعي، تونس، 2004.
– شكري المبخوت، سيرة الغائب، سيرة الآتي: السيرة الذاتية في كتاب «الأيام»، دار الجنوب للنشر، تونس، 1992.
– عبد القادر الشاوي، الكتابة والوجود: السيرة الذاتية في المغرب، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط.1، 2000.
– محمد الداهي، السارد وتوأم الروح: من التمثيل إلى الاصطناع، المركز الثقافي للكتاب، ط.1، 2021.
– فيليب لوجون، السيرة الذاتية: الميثاق والتاريخ الأدبي، ترجمة وتقديم عمر حلي، المركز الثقافي العربي، ط1، 1994.
– جورج ماي، السيرة الذاتية، تعريب محمد القاضي وعبد الله صولة، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة- قرطاج، تونس، 1992.
– أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر (دراسة في نماذج مختارة)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط.1، 2005.
– لطيفة لبصير، سيرهُنّ الذاتية: الجنس الملتبس، دار النايا، دمشق، ط.1، 2013.
– عبد اللطيف الوراري، السيرة الذاتية: النوع وأسئلة الكتابة، منشورات سليكي أخوين، طنجة، ط.1، 2023.
3.1. الفصل الرابع:
• وحدة المسرح
محاور الوحدة
تعريف المسرح لغة واصطلاحاً؛
عناصر بنـاء المسرحيـة؛
المسرحية بين العرض والنصّ؛
المسرح عبر التاريخ: في حضارات الشرق القديم، عند الإغريق، عند الرومان، في عصر النهضة:
اتجاهات المسرح الحديث؛
المسرح عند العرب وأسباب تأخره وجهود تأصيله؛
المسرح الشعري وخصائصه الفنية؛
تحليل مضمون مسرحية « مأساة الحلاج » لصلاح عبد الصبور، وإبراز سماتها الفنية والجمالية.
توصيف الوحدة:
تهدف هذه الوحدة الدراسية إلى التعرف على فنّ المسرح من حيث مفهومه وخصوصيته بين العرض والنص، وعناصره وخصائصه الفنية (الفكرة، الحدث، الحبكة، الشخصيات، الحوار، الصراع الدرامي) وأنواعه (التراجيدي، الكوميدي، الملحمي، الغنائي)، وتطوّره عبر التاريخ؛ في حضارات الشرق القديم، وعند الإغريق أساساً، ثم تحوله في عصر النهضة الأوربية. كما تهدف إلى التعريف بالاتجاهات الأساسية للمسرح الحديث (الرومانسي، الواقعي، التعبيري الرمزي، الملحمي، اللامعقول، التجريبي)، قبل أن ننقل اهتمامنا على المسرح عند العرب وتأخر اهتمامهم به، وجهود المسرحيين العرب من أجل تأصيله (توفيق الحكيم، يوسف إدريس، سعد الله ونوس، علي الراعي، الطيب الصديقي، أحمد الطيب لعلج، عبد الكريم برشيد..). وفي نهاية الوحدة، يتم التركيز على المسرح الشعري باعتباره نوعًا مسرحيًّا عريقًا تعاطاه المبدعون في كلّ العصور والثقافات، وهو يمزج بين الدراما والشعر في أسلوب خاصّ ورؤية متفردة للعالم. وفي هذا السياق، يأتي اشتغالنا على مسرحية (مأساة الحلاج) للشاعر المصري صلاح عبد الصبور نموذجًا تطبيقيًّا نتوقف من خلال على خصوصيات هذه المسرحية موضوعًا ولغةً وإيقاعًا وبناءً فنّياً.
منهجية التدريس
نظراً لخصوصية الوحدة، فإنّ تدريسها يتوزع بين ما هو نظري، وتطبيقي، وتقويمي.
• نظريّاً؛ تقريب الطالب من الأطر المعرفية والمرجعية للنوع المسرحي من خلال الرجوع إلى أصوله في حضارات الشرق القديم، وعند الإغريق أساساً كما تجلّتْ في كتاب « فن الشعر » لأرسطو طاليس، وإلى أشكال التحول المضموني والفني التي عرفتها أوروبا منذ عصر النهضة وخرجت من خلالها على التصور الأرسطي. إلى جانب فهم السياقات التاريخية والسوسيوثقافية التي ساهمت في بروز الفن المسرحي في المجال العربي (المثاقفة، الحداثة، ضرورة التغيير..)، وصيغ التطور والتأصيل التي صاحبته منذ محاولات أواخر القرن التاسع عشر مع مارون النقاش وأبي خليل القباني وغيرهما.
• تطبيقيّاً؛ تحليل مسرحية « مأساة الحلاج » للشاعر المصري صلاح عبد الصبور، وتقريب الطلبة من خصائصها الفنية التي جعلت منها مسرحية شعرية ولكن بأبعاد درامية، وإشراكهم في تذوّقها وتنمية حسّهم المشترك تجاه ما تطرحه من قيم ورؤى شخصية أو جماعية، وإقدارهم على فهمها وتأويلها بشكل متعاون يعزز ميولهم الإيجابية.
• تقويميّاً؛ توجيه الطلبة فرادى وجماعات لإنجاز بعض الأنشطة المتعلقة بالوحدة، والتي تتوزع بين بسط مشكلات وقضايا نظرية وأخرى ثقافية تتعلق بالفن المسرحي قديماً وحديثاً، وبين تحليل مقاطع من مسرحية « مأساة الحلاج » من خلال مفهوم أو خاصية فنية مركزية (الرمز في المسرحية، استلهام التراث الصوفي، تحولات شخصية الحلاج ومأساتها، البناء الفني للمسرحية، شعرية اللغة، التداخل بين الشعري والمسرحي، وبين الغنائي والدرامي..)، وعرضها على الأستاذ من أجل تقويمها قبل تقديمها في حصة حضورية لإشراك الطلبة في مناقشتها والإفادة منها.
وإذن، تتوزع مهام تدريس الوحدة بين مطلبين أساسيين؛ إغناء رصيد المعرفة المسرحية، واكتساب القدرات المهارية المطلوبة أثناء تحليل مقاطع من نظريتها أو من المسرحية المُستهدفة، أو عند إنجاز المشاريع الشخصية، بقدر ما تتوزع طرق تصريفها ضمن الوسائل البيداغوجية المتاحة (سبورة إلكترونية، كتب، وثائق..).
المراجع المعتمدة:
– أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة وتقديم وتعليق د. إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، (د.ت).
– – جان بيير فرنان وبيير فيدال ناكيه، الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديمة، ترجمة حنان قصاب حسن، دار الأهالي- دمشق، ط.1، 1999.
– ماري إلياس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط.2، 2006.
– نهاد صليحة، المسرح بين النص والعرض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999.
– مجيد حميد الجبوري، البنية الداخلية للمسرحية: دراسات في الحبكة المسرحية عربياً وعالمياً، منشورات ضفاف، بيروت، ط.1، 2013.
– عادل النادي، مدخل إلى كتابة فنّ الدراما، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس، ط.1، 1987.
– مجدي وهبة ومحمد عناني، درايدن والشعر المسرحي، دار المعرفة، القاهرة، 1964.
– لاجوس إيجري، فنّ كتابة المسرحية، ترجمة دريني خشبة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، (د.ت).
– مجيد صالح بك، تاريخ المسرح عبر العصور، القاهرة: الثقافيّة للنشر، ط.1، 2002.
– محمود سليم الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب (بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل الإسلام)، دار النهار للنشر، بيروت، ط.2، 1979.
– محمد حسين الأعرجي، فن التمثيل عند العرب، منشورات وزارة الثقافة والفنون، بغداد، 1978.
– حسن المنيعي، المسرح المغربي: من التأسيس إلى صناعة الفرجة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية – ظهر المهراز، فاس، 1994.
– خالد أمين، المسرح المغربي بين التنظير والمهنية، منشورات مجموعة البحث في المسرح والدراما التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تطوان، 2004.
– سيد علي إسماعيل: أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر، مؤسسة هنداوي، د.ت.
– محمد مصطفى بدوي: المسرح العربي الحديث في مصر، ترجمة أنوار عبد الخالق مراجعة وتقديم محمد عناني، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط.1، 2016.
– علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة (248)، الطبعة الثانية، أغسطس 1999.
– مصطفى عبد الغني، المسرح الشعري العربي (الأزمة والمستقبل)، سلسلة عالم المعرفة، 402، يوليو 2013.
– هيثم يحيى الخواجة، المسرح والشعر، كتاب دبي الثقافية، العدد 129، يوليو 2015.
– صلاح شفيع، تحليل الرمز في مسرح صلاح عبدالصبور: دراسة تحليلية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط.1، 2022.نموذج امتحان المسرح
4.1. الفصل السادس:
• وحدة مشروع نهاية الدروس
توصيف الوحدة
نسعى من خلال هذه الوحدة إلى تمكين الطلبة من التمرس على البحث العلمي من خلال إنجاز بحوث في الأدب العربي الحديث والمعاصر؛ فالممارسة البحثية عبر الاحتكاك بالمراجع وما تطرحه من إشكالات نظرية ومعرفية ومنهجية تشكل فرصة سانحة لدى الطالب من أجل إغناء معارفه وتعزيز كفاياته اللغوية والمنهجية في نهاية مرحلة الإجازة الأساسية من تعليمه الجامعي. وقد سعينا إلى أن تكون مواضيع هذه البحوث منسجمة مع مجال تخصُّصنا واهتماماتنا العلمية، على نحو يجعل من تواصلنا مع الطلبة وتأطيرنا لبحوثهم مفيداً ومثمراً في حياتهم الجامعية، بل يكون ما ينجزونهم ويفكّرون فيه ويطرحونه من مشكلات يغني بدوره مشروعنا العلمي ويتقاطع معه في الصميم.
وفي هذا السياق، أشرفنا على بحوث عديدة تتعلق بمفاهيم وقضايا الأدب العربي الحديث والمعاصر من خلال أجناسه الكبرى (الشعر، الرواية، القصة القصيرة، السيرة الذاتية، المسرح، المقالة..)، وتبرز ما عرفه هذا الأدب من تحول وتنوّع كبيرين مسّ بنياته الفنية ومقاصده التداولية. ولهذا، حرصنا أن تكون هذه البحوث تتناول الظاهرة المدروسة وفق تصميم منهجي واضح، وغايات مدروسة، حتى تنتهي إلى نتائج محددة. كما ألححنا على أن تكون كذلك عاكسةً لشخصية الطالب الباحث الذي يصف ويحللّ ويناقش ويدافع عن موقفه ووجهة نظره ويستدلّ على ما يطرحه من مشكلات ومفاهيم وآراء، بدل أن يكون سلبيّاً وجمّاعةً للمعلومات بلا موقف أو رأي يُذكر، بقدر ما تكون هذه الشخصية معبرة عن شغفه بالبحث في الأدب ودراسته عن ميل وتعلُّق.
منهجية الإشراف
من خلال الإشراف على البحوث ومواكبتها حضوريّاً أو عن بعد، كنا نتّبع في تأطير الطلبة والتجاوب مع تطلُّعاتهم أثناء إعدادها:
• حفزهم على اختيار موضوع البحث ضمن مجال الأدب العربي الحديث أو المعاصر، وفق إشكالية مُخصَّصة.
• إنجازهم لتقرير البحث يكون بمثابة خطة منهجية يسيرون على هديها، بعد أن ينظر فيها الأستاذ ويقوّمها على ضوء الإشكالية المطروحة.
• مساعدتهم على إيجاد مراجع ذات صلة بموضوع البحث، وحفزهم على قراءتها والاستفادة منها بحسب مراحل إنجاز البحث.
• تشجيعهم على العمل في مجموعات وفرق بحث تُعزّز لديهم قيم التعاون والتواصل والإيثار.
• مواكبتهم نفسيّاً ومعرفيّاً خلال مراحل إنجاز البحث، ومساعدتهم للتغلب على بعض الصعوبات التي يواجهونها تحت ظرف قاهر أو آخر.
• إقدار على استثمار مهارات الوصف والتحليل والتمييز والحجاج والاستدلال، وعلى الموازنة بين ما هو نظري وتطبيقي، من أجل أن تكون نتائج البحث المستخلصة ذات وضوح منهجي وفائدة معرفية.
المراجع المعتمدة:
– دليل كتابة البحوث، مختبر إعداد اللغة العربية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة، 2013.
– دليل صياغة الأطروحات والرسائل الجامعية العربية: الأخلاقيات والتنظيم والاستشهاد المرجعي، شبكة المعلومات العربية التربوية (شمعة)، بيروت، ط.2، 2023.
على هذا الرابط عناوين بحوث الإجازة
5.1. الفصل السابع (ماستر التأويليات والدراسات اللسانية والنصية)
• وحدة جمالية التلقي
توصيف الوحدة
تهدف هذه الوحدة الدراسية إلى التعرف على جمالية التلقي باعتبار أحد مناهج النقد المعاصر، التي تجاوزت مآزق التحليل الشكلاني والبنيوي؛ حيث أولت أهمية قصوى للقارئ وأشكال تفاعله المثمر مع النصوص وإنتاج معانيها وملء بياضاتها عبر فاعلية التأويل. ولهذا، يتعرف طلبة هذا الفصل على الأطر المرجعية والمعرفية التي كانت وراء بروز جمالية التلقي، أو نظريات القراءة بوجه عام، ولاسيما عندما بعض الفلاسفة الألمان ومنظري القراءة والتأويل (جورج غادامير، هوسرل، رومان إنغاردن، رولان بارت، أمبرتو إيكو..). مثلما يطّلعون على مفاهيم جمالية التلقي وأسسها المعرفية والإجرائية عند رائديها هانس روبرت ياوس وفولفغانغ إيزر (أفق الانتظار، المسافة الجمالية، القارئ الضمني..)، وعلى بعض تطبيقاتها في النقد العربي والمغربي المعاصر (عبد الله إبراهيم، محمد مفتاح، إدريس بلمليح، حميد لحمداني، عبد الفتاح كيليطو..).
منهجية التدريس
تتوزع مهام تدريس الوحدة بين مطلبين أساسيين؛ إغناء رصيد المعرفة النظرية والفلسفية الخاصة بجمالية التلقي، واكتساب القدرات المهارية المطلوبة للاقتراب منها ومساعي تطبيقها عند إنجاز العروض أو المشاريع الشخصية، بقدر ما تتوزع طرق تصريفها ضمن الوسائل البيداغوجية المتاحة (سبورة إلكترونية، كتب، وثائق..).
المراجع المعتمدة:
– هانس روبيرت ياوس، جمالية التلقي: من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، ترجمة رشيد بنحدو، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط.1، 2004.
– فولفغانغ إيزر، فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب (في الأدب)، ترجمة حميد لحمداني والجلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس، 1994.
– روبرت هولب، نظرية التلقي: مقدمة نقدية، ترجمة عزالدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط.1، 2000.
– فنسان جوف، القراءة، ترجمة سعاد التريكي، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2015.
– جين ب. تومبنكنز، نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى ما بعد الحداثة، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط.1، 1999.
– عبد الله إبراهيم، التلقي والسياقات الثقافية: بحث في تأويل الظاهرة الأدبية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط.2، 2005.
– حامد أبو أحمد، الخطاب والقارئ: نظريات التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة، كتاب الرياض، العدد 30، يونيو 1996.
– محمد مفتاح وآخرون، نظرية التلقي: إشكالات وتطبيقات، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط.1، 1994.
– حسن البنا عزالدين، قراءة الآخر/ قراءة الأنا، نظرية التلقي وتطبيقاتها في النقد العربي المعاصر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط.1، 2008.
6.1. الفصل السابع (ماستر النص النثري العربي: دراسة في الأشكال والأنواع)
• وحدة الخطاب الشعري
توصيف الوحدة
تهدف هذه الوحدة الدراسية إلى التعريف بحركة الحداثة الشعرية العربية، وضبط أهمّ الاتجاهات الفكرية والفنية التي شهدتها القصيدة العربية خلال القرن العشرين وبدايات الألفية الجديدة، وما رافقها من تحولات جمالية وثقافية، بما في ذلك بروز قصيدة النثر التي أعادت النظر في مسلّمات الكتابة الشعرية. إلى جانب، تحليل القيم الأساسية التي دافع عنها الشعراء المحدثون في المشرق والمغرب (قيم سيرذاتية، وطنية، ثقافية، إنسانية وكونية) من خلال بعض النماذج الشعرية الأكثر تمثيلاً.
منهجية التدريس:
تتوزع مهام تدريس الوحدة بين مطلبين أساسيين؛ إغناء رصيد المعرفة الشعرية الحديثة، واكتساب القدرات المهارية المطلوبة للاقتراب من متونها النظرية والنصية عند إنجاز العروض أو المشاريع الشخصية، بقدر ما تتوزع طرق تصريفها ضمن الوسائل البيداغوجية المتاحة (سبورة إلكترونية، كتب، وثائق..)، على نحو يُمكّن الطالب من التمييز بين أساليب الكتابة الشعرية واتجاهاتها ومرجعياتها الجمالية، مثلما يُمكنه من تذوّقها والتعبير عن موقفه منها في مقامات تواصلية معينة.
المراجع المعتمدة:
– إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، فبراير 1978.
– أحمد المعداوي، ظاهرة الشعر الحديث، دار المدارس، ط.2، 2007.
– حاتم الصكر، مرايا نرسيس: الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المؤسسة الجامعية، للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، ط.1، 1419هـ-1999م.
– صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت – لبنان، ط.1، 1995.
– عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: ظواهره وقضاياه الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت، ط.5، 1988.
– غالي شكري، شعرنا الحديث…إلى أين؟، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط.2، 1978.
– كمال خير بك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دار المشرق، بيروت، ط.1، 1982.
– نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط.3، 1967.
– محسن جاسم الموسوي، مسارات القصيدة العربية المعاصرة، ترجمة أحمد بوحسن، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط.1، 2017.
– محمد بنيس: -ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب، دار التنوير، بيروت، ط.2، 1985.
– الشعر العربي الحديث. بنياته وإبدالاتها، الجزء 3: الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، الدارالبيضاء، ط.2، 1996.
– عبد اللطيف الوراري، لشرفة والرماد: دراسات في الشعر العربي وقضاياه، دار أبجد، العراق، ط.1، 2022.
7.1. الفصل الثامن (ماستر النص النثري العربي: دراسة في الأشكال والأنواع)
• وحدة نظرية الأدب
محاور الوحدة
تهدف هذه الوحدة الدراسية إلى الاقتراب من أهمّ القضايا والإشكالات المعرفية والمنهجية والتصنيفية التي تطرحها نظرية الأدب، ابتداءً من تحديد الفروق النوعية بين موضوع الأدب وطبيعته ووظائفه، أو بين النظرية وتاريخ الأدب والدراسات النقدية رغم تعالقها وحاجة بعضها إلى البعض الآخر. كما تهدف إلى التعرف على الجوانب المتعلقة بدراسة الأدب من خلال ما استجدّ من المناهج الحديثة وما تقترحه مداخل خارجية وداخلية في تفسير النصوص وتأويلها، وتأثير مذاهب الأدب من كلاسيكية ورومانسية وواقعية ورمزية وغيرها، في تطور الأدب العربي الحديث. إلى جانب التعريف بنظرية الأجناس الأدبية بما هي مبدأ تنظيمي وتصنيفي للأدب وتاريخه لا على أساس الزمان والمكان ولكن على أساس الأنماط من حيث البناء والتنظيم، وما شهدته هذه النظرية نفسها من انقلاب أعاد النظر في صرامة بنيانها المعماري وأحدث التداخل بين أجناسها الكبرى.
منهجية التدريس
تتوزع مهام تدريس الوحدة بين مطلبين أساسيين؛ إغناء رصيد الطالب بما تقترحه نظرية الأدب الحديثة والمعاصرة من إشكالات ومعارف خاصة من خلال احتكاكه بالمراجع المعتمدة لأساطين النظرية (أرسطو، رينيه ويليك، أوستن وارين، تيري إيغلتون، تزفيتان تودوروف، جوناثان كالر، إيف ستالوني، رامان سلدن..)، واكتساب القدرات المهارية المطلوبة للاقتراب منها واستمداد أدواتها لتطبيقها عند إنجاز العروض أو المشاريع الشخصية.
المراجع المعتمدة:
– رينه ويليك وأوستن وارين، نظرية الأدب، ترجمة عادل سلامة، دار المريخ، الرياض، 1992.
– جوناثان كالر، النظرية الأدبية، ترجمة رشاد عبد القادر، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 2004.
– تيري إيغلتون، نظرية الأدب، ترجمة ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1995.
– رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار قباء، القاهرة، 1998.
– إيف ستالوني، الأجناس الأدبية، محمد الزكراوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط.1، 2014.
– تزفيتان تودوروف، الأدب في خطر، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، ط.1، 2007.
– حمادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، النادي الادبي الثقافي بجدة، 1990.
– سعيد يقطين، الفكر الأدبي العربي: البنيات والأنساق، منشورات ضفاف، ط.1، 2017.
– ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، دار التنوير، بيروت، 2007.
– رشيد يحياوي، الشعرية العربية: الأنواع والأغراض، إفريقيا الشرق، ط.1، 1991.
– حسين الواد، في مناهج الدراسة الأدبية، منشورات الجامعة، تونس، ط.2، 1985.
– محمد صابر عبيد، النظرية النقدية: القراءة، المنهج، التشكيل الأجناسي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط.1، 2015.
– عبد الله إبراهيم، التخيل التاريخي: السرد، والإمبراطورية، والتجربة الاستعمارية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط.1، 2011.
– أنطوان كومبانيون، شيطان النظرية: الأدب والحس المشترك، ترجمة حسن الطالب، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط.1، 2022.
8.1. الفصل التاسع (ماستر النص النثري العربي: دراسة في الأشكال والأنواع)
• وحدة النقد الثقافي
محاور الوحدة
تهدف هذه الوحدة الدراسية إلى التعرف على النقد الثقافي من خلال بحث مفهومه وأطره النظرية والمعرفية التي تنحدر من مرجعيات نظرية وفلسفية ونقدية (جماعة برمنغهام، مدرسة فرانكفورت، مدرسة النقد الجديد، نظرية ما بعد الحداثة، التاريخانية الجديدة، النقد ما بعد الكولونيالي، النقد النسوي). كما تدرس خصوصيات النقد الثقافي في المجال العربي، الذي فرض حضوره على الباحثين والمفكرين (عبد الله الغذامي، نادر كاظم، حسين القاصد، محسن جاسم الموسوي، عبد الله إبراهيم، عز الدين المناصرة، يوسف عليمات، عبد القادر الرباعي، سمير الخليل، عبد الرزاق المصباحي) منذ مطلع الألفية الجديدة، وأبرز الاتجاهات التي عبّر عنها في تحليلاتهم ورؤاهم النقدية: نقد مشروع عبد الله الغذامي، وجماليات النقد الثقافي، والنظرية والنقد المقارن، وأنساق الغيرية والتحليل الثقافي.
منهجية التدريس
تتوزع مهام تدريس الوحدة بين مطلبين أساسيين؛ إغناء رصيد الطالب بما يقترجه مجال الدراسات الثقافية من إشكالات ومعارف وتصورات متعلقة بها، من خلال احتكاكه بالمراجع المعتمدة داخل هذه الدراسات، بما في ذلك دراسات إدوارد سعيد في نقد الاستشراق، واكتساب القدرات المهارية المطلوبة للاقتراب منها واستمداد أدواتها ومفاهيمها عند إنجاز العروض أو المشاريع الشخصية.
المراجع المعتمدة:
– إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، دار رؤية، القاهرة، 2006.
– بيتر ل. بيرجر وآخرون، التحليل الثقافي، ترجمة أحمد أبو زيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط.1، 2009.
– سايمون ديورنغ، الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية، ترجمة ممدوح يوسف عمران، سلسلة عالم المعرفة، يونيو 2015.
ريتشارد وولين، مقولات النقد الثقافي، ترجمة محمد عناني، المركز القومي للترجمة، ط.1، 2016.
– آرثر إيزابرجر، النقد الثقافي: تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2009.
– تيري إيغلتون، فكرة الثقافة، ترجمة ثائر ديب، دار الحوار، سوريا، ط.1، 2000.
– سعد البازعي وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت- الدار البيضاء، ط.1، 2002.
– عبد الله الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت- الدار البيضاء، ط.1، 2000.
– صلاح قلنسوة، تمارين في النقد الثقافي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط.1، 2007.
– عبد القادر الرباعي، تحولات النقد الثقافي، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، ط.1، 2007.
– محسن جاسم الموسوي، النظرية والنقد الثقافي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط.1، 2005.
– نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربي في العصر الوسيط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط.1، 2004.
– يوسف عليمات، جماليات التحليل الثقافي؛ الشعر الجاهلي نموذجاً، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط.1، 2004.
– رضا عطية، الاغتراب في شعر سعدي يوسف: قراءة ثقافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط.1، 2018.
-عبد الرزاق المصباحي، النقد الثقافي: قراءة في المرجعيات النظرية المؤسِّسة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت- الدوحة، ط.1، 2022.
3. المشاريع البيداغوجية المستقبلية
بالنسبة للمشروع البيداغوجي، فإننا نروم داخل كليتنا العتيدة تعزيز حضور الأدب المعاصر من خلال تمثيلية أكبر لأجناسه الكبرى (الشعر، الرواية، القصة القصيرة، السيرة الذاتية، الرحلة..)، التي حدثت فيها تحوّلات جمالية ذات اعتبار، وذلك عبر مرحلتين:
1.3. في المرحلة  الأولى،
الأولى،
حفز الطلبة على تكوين أندية أدبية تهتمّ بقضايا الأدب المعاصر على الصعيدين العربي والمغربي، وتُوجِد فضاءات تتيح للطلبة فرصاً سانحة للحوار والمناقشة، وورشات للقراءة والكتابة ينشطها كُتّاب ومبدعون، كما تحتضن لقاءات مع أدباء يمثّلون أجيالاً وحساسيات مختلفة.
2.3. في المرحلة الثانية،
التنسيق مع أساتذة الأدب الحديث والمعاصر داخل شعبة اللغة العربية وخارجها ممن ينتمون إلى جامعة عبد المالك السعدي أو إلى جامعات وطنية أخرى، من أجل الترتيب لتأسيس ماستر الأدب المعاصر يكون هدفه تكوين طلبة باحثين أكفاء متخصصين في دراسة إشكالات هذا الأدب وقضاياه وأجناسه ومتونه الإبداعية المتنوعة، وفق مقاربات ورؤى وتصورات جديدة ومغايرة تستفيد من منجز نظرية الأدب المعاصرة، وتجيب على العالق والمهمل والمستجدّ داخل الدرس النقدي، ويمكن لمثل هذه المقاربات المفترضة أن تثمرها أو تحتضنها بنية بحث مواتية أثناء إعداد مشاريع الدكتوراه لما فيه مستقبل الجامعة وأخلاقها البانية.

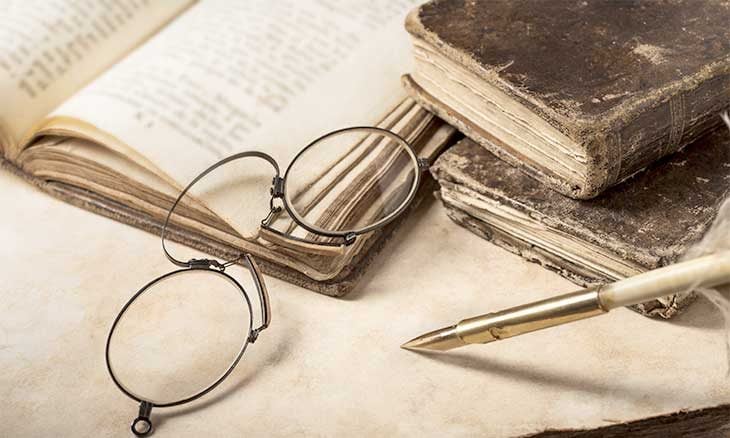

لا تعليق