تجلّيات المكون الميتاشعري
في “قرطاس” عبد اللطيف الوراريمصطفى بوتلين
الشعر على الشعر
ظلّت ماهية الشعر مبحثا متوارثا بين النقاد والشعراء سواء بسواء، ومنبع هذا التوارث يعزى إلى غموض منبع الشعر، أو ما يسم به هذا الغموض الألفاظ وما ينداح منها من معانٍ دلالات ، والشعراء وحدهم من قالوا الشعر وقالوا عنه، سواء القدامى أو الجدد؛ لأن الشعر في مختلف الألسن واللهجات ولد وظل مؤثرا في حياة الناس جميعهم. ويمكن اعتباره شكلا آخر للرسم الذي يمثل أعرق فن عبر عن خوالج الإنسان، ليسلم المشعل للشعر في عهد الإغريق حيث داخله ولدت الأسطورة والحكاية والمسرح والفلسفة والأخلاق، وبذلك نال ذيوعا شعبيا ورسميا كبيرا منح للشعراء مكانا عظيما، بل أضحى الشاعر منبع الحضارة الذي لا ينضب. وقد كتب عنه المعلم الأول أرسطو محاولا شرحه وكشف خاصيته التي ظلت، ولا تزال، صعبة على الإدراك، طالما أنه مرتبط بحالة شعورية في الزمن والمكان، ومؤثرة أو متماهية مع عالم أرحب في مواجهة آخر ضيق وأقل أمانا.
يقول أرسطو في تعريفه لماهية الشعر: “ولهذا كان الشعر أوفر حظا من الفلسفة وأسمى مقاما من التاريخ، لأن الشعر بالأحرى يروي الكلي، بينما التاريخ يروي الجزئي”. وعلى هذا المقاس في التعريف جرت توصيفات الفارابي وبن سينا وابن رشد وابن خلدون، الذي جعلوا من الملكة الشعرية ملكة كونية سامية على الألسن واللهجات، وإن تطلب تعضيد الملكة بصنعة الارتياض، أي الرياضة والمجاهدة بالتعبير العرفاني، التي تفيد تملك الكاتب لطبائع اللغة وبلاغاتها الخاصة بلهجة معينة أو لغة ما. والملكة الكونية اختلف في تصنيفها بين الإلهام والشعور والرؤيا إلى غيره من المساعي العلمية الفلسفية المتدرجة بين الإلهيات وعلم النفس، وذلك لبسط مفهوم ملكة الشعر البدائية في الإنساني كتعبير سابق عن اللغة التي طورت التصوير البدائي إلى تصوير شعري أكثر سموا وإبداعا.
والاشتغال بالشعر على الشعر ليس ظاهرة جديدة، بل هي تقليد دأب عليه جل الشعراء افتتانا بالشعري، أو عشقا له، أو بحثا عن امتلاكه كلؤلؤة مرئية ومنفلتة ومتأبية على الإمساك. يقول الأحوص الأنصاري:
وما الشعر إلا خطبة من مؤلف بمنطق حق أو بمنطق باطل
فلا تقبلن إلا الذي وافق الرضا ولا ترجعنا كالنساء الأرامل
وفي قصيدة “لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي” يقول محمود درويش:
“تخيلتها لا لشئ، لكن لأسمعها
لأسمعها شعر بابلو نيرودا، كأني أنا هو
فالشعر كالوهم. “
ولا تعوزنا الأمثلة من قديم الشعر وحديثه على هذا البعد الميتاشعري كما درج عليه النقد المعاصر، وكما درستها الباحثة اللبنانية هدى فخر الدين في كتابها: “الميتاشعرية في التراث العربي”.
سيرة شعرية
في ديوان “قرطاس: سيرة شعرية” (دار كنعان، دمشق 2022) للشاعر المغربي عبد اللطيف الوراري، وهو – كما سبق أن أشار إلى ذلك- كتابٌ شعريٌّ من حيث بنيته التأليفية، أكثر من كونه تجميعاً لقصائد متفرّقة، بحيث تتراكب نصوصه متعدّدة البناء، بين متوسطة وقصيرة وشذرية، على نحو يمنح للسيرة الشعرية، ذاتاً وموضوعاً، سيرورتها الكتابية بما تنطوي عليه من بروق روحية وصلات قرابية وتأملات ميتاشعرية والتقاطات محسوسة وكثيفة تسائل موجودات الذات الكاتبة وحياتها المستعادة من جديد، كما تسائل الشعر وانهماكاته وحضوره في العالم من الداخل بطريق الاستبطان والوعي الذاتي.
ولهذا، نكتشف تركيزا واضحا على هذا البعد ابتداءً من الفي قصيدة الافتتاحية التي وردت تحت عنوان: ” الشعر كما رايته”:
“غابةٌ بِأَكْملها- حَجَرًا.
مِنْ نيرانٍ تشتعل
في زُؤان الحقيقة اللاّمع،
تضيع الأوراق مثل أسنان القِرْش،
لكنّ الكلماتِ تَعْلَقُ بالأجنحة
وهي
إلى اليوم
تَدّخرُ ضَوْء الشِّعر.”
يعكس هذا المقطع الشعر رؤية الشاعر للشعر، رؤية لم تنج بذاتها من الغموض الذي يكتنف الشعر؛ فالشعر زؤان الحقيقة النابت في عمق النهر، وهو التعريف الذي يفيد الانعكاس التصويري للكينونة انعكاسا يعيد بناءها لتفصح عن هذا الملتبس والغامض العام الذي يلف الوجود من حيث هو وجود، أو من حيث هو ماهية تتلبس العالم الخاص بالشاعر، أو العالم العام المحيط به كدائرة واسعة. لكنه لا يلبث أن يقدم تعريفا آخر للشعر كتسامٍ نوراني يحلق بأجنحة ويضئ المظلم فينا منذ الأزل، معلنا تلك القدرية الشعرية الأصيلة والجبلة الغامضة في مطاردة الشعر للعالم سعيا إلى عرضه جميلا وبسيطا ومفهوما. إننا إزاء فلسفة شاعرية موضوعها الشعر، وقد ألمع الشاعر إلى ذلك بقوله :
“أَفْـرُكُ عينَيْ وَعْلٍ
على الصّفحة الأولى
مَطْمورةً في أسفل الدَّرَج،
ثُمّ أُبْصر
من آخر النّهار
عُصْفورًا أسودَ يضربُ بجناحيْهِ:
إِنّه قصيدة؛
إِنّه بِرْكة نَمْل.”
أما في قصيدة “سرقة النار” فتطرح قضية الذات الشاعرة وعنف صدامها مع العالم:
“مساكين هم الشُّعراء؛
ما إن يسمعوا بحريقٍ
في أقصى المدينة،
حتى يُهَرْولوا شبيهين بإطفائيّين نبلاء.
ينطفئ الحريق،
وهم لم يصلوا بَعْدُ.”
فالشاعر مطابق لشعره، ومحكوم بنزوعه نحو الافتتان بكل يمور به المحيط من نكسات وأحلام، أمنيات وكبوات؛ فهو بمثابة وعاء ينهل منه الشعر لفظه ودلالته ليقول العالم بعناصر العالم إما مقلوبة، أو غرائبية، أو رومانسية، أو ثائرة، أو ذائبة في إحساس نبيل يقدس القيمة كجمال إنساني محمود. يقول في قصيدة “الشعر سول لهم”:
“عُمْيانًا-
لم يـروا في الأحلام
سوى قارَبٍ للأطفال
وهو ينتشر ذرّاتٍ،
ثُمّ ينفعل بالضّوْء مَكْفوفًا
الحِبْرُ الذي في جَوْف البحر.
هكذا،
وضعوا العالم تحت تصرّفهم بالمجان،
فما يعنيهِمْ
قد سَكِر بالأبديّة، ونام !”
تظل ماهية الشعر غاصة بالالتباس والغموض، لكن الشاعر عبد اللطيف الوراري استطاع في ديوانه السيري- الشعري، أن يقدم رؤيته للشعر عبر قصائد بلورية لا تنقطع عن بحث المعنى اللامرئي والمجهول، فيما هو يبدو صارخا في وجه اليومي المثقل بالضآلة والقبح، ومهموما بفتنة الشعر المتعرجة في ندوب غفيرة تبدأ من سؤال الوجود ولا تنتهي عند قيمة الصيرورة كأفق ممتد ولانهائي.
خطاب مفارق
إذا كان الخطاب الشعري خطابا مفارقا للتاريخ، بيد أنه بخلاف الخطاب الأيديولوجي يعاود النظر في التاريخ ولا يسقط في تمثيل ساذج له؛ فالمفارقة يتطلّبها للتعبير عن خيبة الأفق الذي يفتحه في حاضره. أليس الشعر في هذا المنحى هو محاكاة ساخرة تنبني على المحاورة بالمعنى اليوناني الأصيل، أي أنه حجاج ساخر متلون باللغة الرسمية والشعبية ومفخخها بمعانى النكتة والإدانة والفضح والتحريض الخلاق على التمرد؟ ألا يمكن للمحاكاة الساخرة أن تحقق في هذه الحالة حجاج الشعر واحتجاجه في الوقت نفسه؟
لنتأمل هذا المقطع من قصيدة “بريد عاجل إلى بدر شاكر السياب”:
“مساء الخير يا بدر
اليوم سألنا عنك في المدرسة
سألنا البواب والدكك والحوش الصغير والحساسين
وكنا نرتجف مذعورين من وحشة المكان
فرفعنا أعيننا إلى السماء ألا يمسك يسوء
لم ننبس بشئ على مقاعد الدرس
لكن استغللنا الصمت في حصة الرسم
لنفصح عن الجليد في أناملنا
هل تصدق أن بعضنا رسمك بلا عينين”.
السياب مدرسة الشعر الحديث، حولتها القصيدة إلى طلل يعبث به شعراء فشلوا في بناء القصيدة كما بناها الرواد، وكأنهم رسموه بلا عينين، ومن غيرهما تنبأ ورأى حريق الخليج في نيران ملتهبة. فالشاعر الرائي كما جسده السياب ظل في مدرسة الشعر وانبرى يلهو بلا رؤى، بل هو ضائع وتائه في محراب الكلمة المعذبة . ولأن رؤياه احترقت، يبعثه عبد اللطيف الورراي ويبارك رؤياه وهو يحاورها ويعيد دمجها في تراجيديا الحريق، ومن دخانها يتراءى لنا حاضر بلا روح، تخترمه الإدانة والسخرية.
وفي قصيدة “ما لم تقله فدوى طوقان”، يشرئب الشاعر برؤياه إلى فلسطين تحت الاحتلال، متماهياً مع قناع فدوى ومتعاطفاً مع أحزانها الشخصية:
ها أنا أعود الآن إلى غرفتي في بيتنا القديم بنابلس
وأذرع الحشائش جيئةً وذهابًا.
ها أنا أشرف على خاصرة جبل جرزيم
حيث بذرة الأمل تذوب في عين الشّمس.
أحدّق في هذا الصّخر الذي يطلّ عليه الشّبّاك المفتوح،
وأتسمّع إلى الأنهار التي وصلتني بالشّجرة والعصفور والغناء.
منذ رحلت أناي، وأنا أجلس وحدي هنا –
أصلّي للأيّام الماطرة
وأحفظ القصائد في الآبار على زيت مصباح خافت.”
تحقق هذه القصيدة محاكاتها بالقصة، المحكي الشعري، حيث الفضاء والحدث والشخوص عناصر متعاضدة تتنامى عبر توتر درامي محايث للقصيدة. فهي بوح بلسان راو واصف للغائب في المتن الشعري لفدوى طوقان، غير أنه حاضر في القضية، ومآلات القدس، والأحلام والأمنيات التي تحتشد في كل دواوين الشاعرة الفلسطينية، أو الصوت الخفي الذي كان أفقا مأمولا للقصيدة، وحالكاً في مرات غير فليلة، لكنه ظل مع ذلك ملتصقا الأرض وعشقها، ومن ثم يؤول الشعر كما لو كان محنة جديدة للألم رغم قسوة التاريخ.
وفي نص ” Et la poésie coule” تتأسس المحاكاة على محاورة المتون الشعرية لرامبو ومالارميه وبودلير، محاورة تروم المساءلة عن سر التناغم بين الشعر والتجربة، فهناك شعراء انكتبوا شعرا، وعاشوه كرؤى تجلت في سيرهم ، كنبوءة نهاية مالارميه، وتراجيديا معركة القيم الذي حوكم بها بودلير، وتجديف رامبو الساحر تجديفا يعارك الحياة ليصطاد القصيدة طرية ضاجة بالطبيعة كما هي.
ينتهي الديوان بومضات شعرية متوزعة بين الهايكو والشذرة والومضة الحكمية، محققة الطابع السيري للشعر كاختلاف يراهن على المعنى وأثر الحقيقة.، كأننا مع هذا الديوان نقوم برحلة مع الشعر ومع الشاعر في الشعر، ونقف على مآثر شعرية، ونستمع لمدونات شعرية حيث الإيقاع نهر سيال بالكلمات، والمعاني جراح تتدلى من العناوين حتى آخر سطر. وأما التاريخ، ذلك الأشعث بلا نعال الحاضر في تفاصيل السيرة، فهو يشهر في وجوهنا جنونه وبؤسه، ويحاول يائساً أن يرتق ثيابه برؤى الشعراء وأحلامهم.
من نص إلى نص، نسافر ولا نحمل معنا سوى روحنا التي يخط عليه صوت الشاعر يوميات السفر في القصائد، وذكريات الشعر، وهمومه وقضاياه التي يتلبس فيها الفردي بالجماعي. وعندما يموت الشاعر، يسطع ضوء القمر في أزمنة الموت والفجيعة، كاشفًا لمن سيأتي أن عمل هو واجب والتزام قبل كل شيء:
“القمر مختارات لأجمل أشعار الأرض
إذا أقمرت ليلة ما
فاعلم أنها لوداع شاعر”.

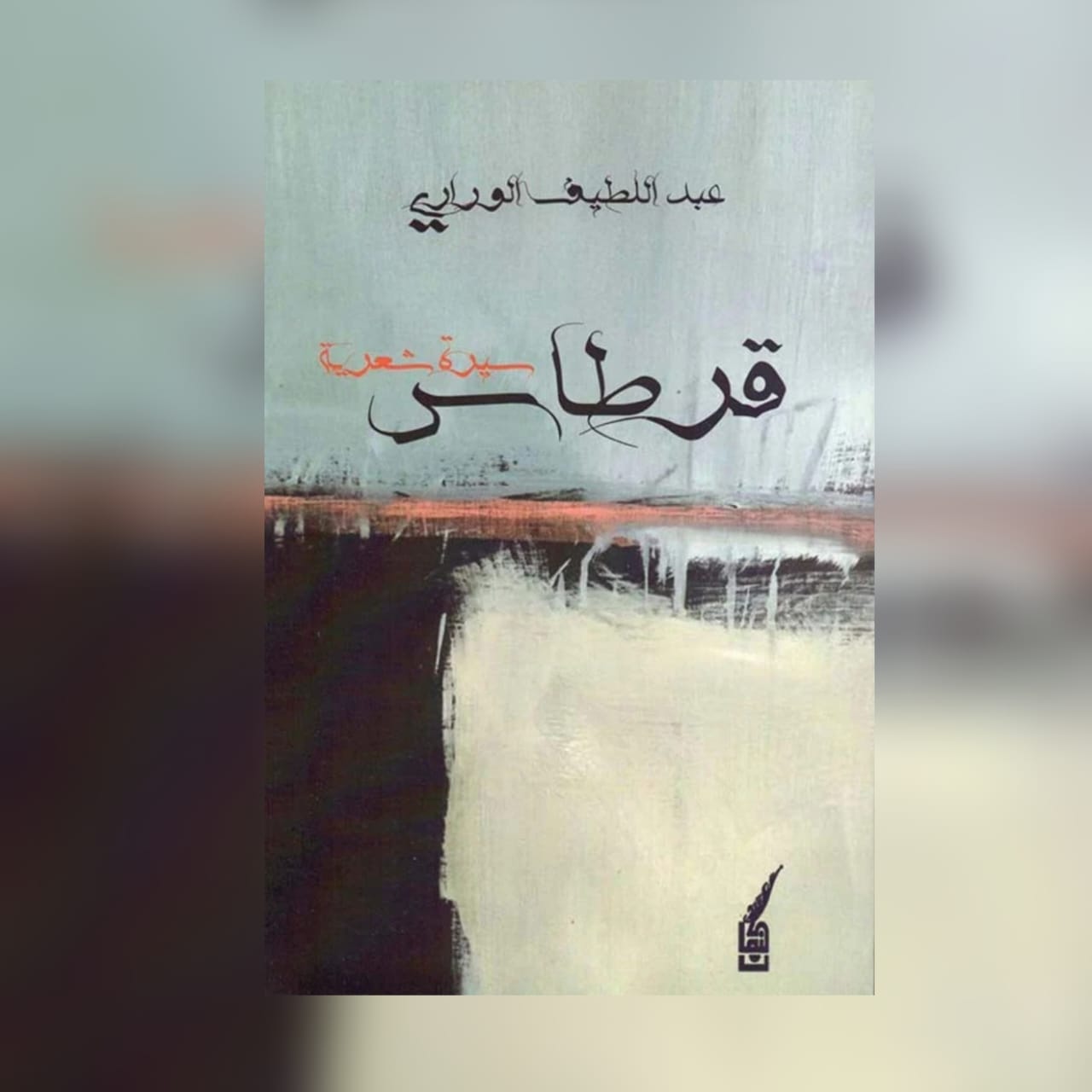
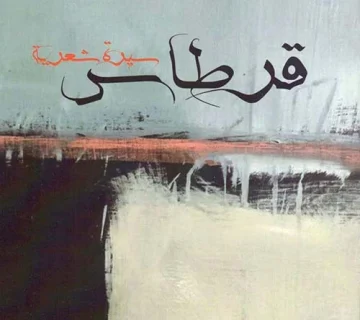
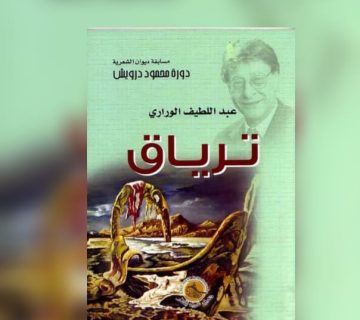
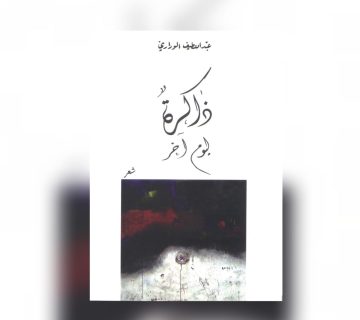
لا تعليق