صدر الكتاب عن دار فضاءات- عمان (يناير/كانون الثاني 2020)، وفي مقدمته يتطرّق المؤلف لما عرفته نظرية الأنواع الأدبية من تململ قواعديّ وتراتبيّ قاد إلى اختراق النوع السيرذاتي وتداخل الشعري والنثري.
يكتب الوراري في تقديم الكتاب: « ففي ظلِّ التداخل بين ما هو شعري وما هو نثري أو سردي، تتحوّل البنيات، سرديّةً كانت أم شعريّةً، إلى مجالٍ مفتوحٍ ومرنٍ لاستيعاب التنوُّع أو الحوار الأنواعي على صعد اللُّغة والبناء ومتخيَّل الكتابة (…) لقد أضحت السمات المهيمنة التي تعبر من نوع معيّن إلى نوع آخر سمات مشتركة تنتمي إلى الأدبية، أكثر منها إلى الشعر وحده أو إلى النثر وحده. فكما يمكن الحديث عن عبور تقنيّات السرد إلى الشعر أو نصوص قصيدة النثر تحديدًا، يجري الحديث – بموازاة مع ذلك – عن اختراق الشِّعر لعدد من الأنواع السردية التخييلة وغير التخييلية، بما فيها السيرة الذاتية، فيحدث نتيجة ذلك عنصر الهجنة الذي يُولّد سرودًا جديدة أو يصعب تصنيفها مثل الرواية الشعرية، أو المحكي الشعري، أو الكتابة عبر النوعيّة بتعبير إدوار الخراط الذي أولى اهتمامًا ذا اعتبار للسرود ذات الحمولة الشعرية، ووجد في لجوئها إلى الشعر واعتمادها عليه بمثابة الخلاص من الرثاثة والابتذال والمهانة التي يتميز بها الواقع المحيط بنا. »
وأضاف: « في السيرة الذاتية الجديدة، يحدث تطوُّرٌ يمس أطر المحكيّ بقدر ما يبلبل مفاهيم الشكل التعبيري الخاص بها. فالسيرة الذاتية تتناول بالسرد، شأن الرواية أو القصة، حدثًا ما مضى من حياة المؤلِّف، لكن الـمُعوَّل عليه هنا ليس استعادة ماضي الأحداث وتذكُّرها وحسب، بل الكيفية التي تروى بها هذه الأحداث من جهة، وطريقة النظر إليها استدعاءً وتخييلًا، وما تفصح عنه في تسريدها للذات وللعالم من جهة ثانية. »
هكذا يدرس عبر الفصول الستة للكتاب نماذج من السير التي كتبها شعراء العربية المحدثون والمعاصرون، إذ يخصّ كل فصل بمحور تيماتي وجمالي يتناول تحته عيّنة من هذه السير التي تحقق شرطي المواءمة والنجاعة المنهجية. ففي الفصل الأول يبحث السيرة الشعرية بوصفها كتابة مضاعفة من خلال « سيرة شعرية » لغازي القصيبي، و »الجسر والهاوية » لمحمد بنطلحة، و »قلب العقرب » لمحمد حلمي الريشة. وفي الفصل الثاني يقارب شفافية اللغة وعمل الذات من خلال « رحلة جبلية، رحلة صعبة » لفدوى طوقان، و »الجندب الحديدي » لسليم بركات. وفي الفصل الثالث يفكّك جماليّات محكي الطفولة من خلال « البئر الأولى » لجبرا إبراهيم جبرا، و »أوائل زيارات الدهشة » لمحمد عفيفي مطر، و »فراشات هاربة » لعبدالكريم الطبال. وفي الفصل الرابع، ينتقل إلى الحديث عن شعريّة المفارقة من خلال « رأيت رام الله » لمريد البرغوثي، و »الصعود إلى الجبل الأخضر » لسيف الرحبي.
وفي الفصل الخامس، ينظر إلى السيرة بما هي ابتكارٌ للهويّة من خلال « متاهة الإسكافي » لعبدالمنعم رمضان و »شطحاتٌ لمنتصف النهار » لمحمد بنيس. وفي الفصل السادس والأخير، يتناول السيرذاتي والشعري وتوتُّر العلاقة بينهما من المرجعي إلى التخييلي عبر المجاميع الشعرية: « تركيب آخر لحياة وديع سعادة » لوديع سعادة، و »مقاطع يومية » لصلاح فائق، و »كأنّي أُفيق » لعبدالرفيع جواهري.
وجاء على غلاف الكتاب: إنّ السير التي كتبها بعض الشعراء وجنَّسوا محكيّاتهم تحتها (ذاتية، ثقافية وشعرية)، وهي قليلة بالقياس إلى عشرات السير الأخرى التي ألّفها مؤلفون من زوايا ومشارب وأفهام أخرى مختلفة، تُعبّر عن روح جديدة في كتابتها، وعن كيفيّاتٍ مخصوصة في بنائها وتخييلها، ويتجلى فيها الشِّعر بأناه الغنائي والمجازي حاضِرًا فيها بكثافته ليس على مستوى الكون الاستعاري والتخييلي لهذه السير، بل كذلك على مستوى تشييدها فنّيًا.
لقد أثارت مثل هذه السير، مُجدَّدًا، مسألة الشعر المقيم في قلب الظاهرة السردية. والعكس صحيح؛ عندما يتعلق الأمر بالسيرذاتي وشكل استضافته داخل الفضاء الشعري.
يشار إلى أنّ هذا الكتاب يندرج ضمن المشروع السيرذاتي في مجال الشعرية العربية، الذي انخرط فيه الكاتب المغربي منذ سنوات.
سِيَر الشعراء تُفجّر أسئلة الكتابة
محمود فراج النابي
في كتابه الجديد بعنوان « سِيَر الشُّعراء: من بحث المعنى إلى ابتكار الهوية » يدرج الشاعر والكاتب المغربي عبداللطيف الوراري قراءات لسير شعراء مختلفين من العالم العربي، وصلت إلى خمس عشرة سيرة ذاتية.
وينطلق الناقد في كتابه، الصادر أخيرًا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 2020، من أن السيرة الشعرية كتابة مضاعفة تؤرخ لسيرة أنا الشاعر بقدر ما تشف – بلا قيد مرجعي ضاغط- عن تطور تجربته في الكتابة، هنا والآن، وباحثا عن روح جديدة في كتابتها، وعن كيفيات مخصوصة في بنائها وتخييلها، وأيضا لما أثارته مثل هذه السير من قضايا كمسألة الشعر المقيم في قلب الظاهرة السردية، والعكس صحيح.
أقنعة السيرة
الحقيقة أن القيد الذي وضعه فيليب لوجون في تعريف السيرة الذاتية، خشية أن تتسرب إلى الشعر أصداء السيرة الذاتية، لا وجود له، فالذاتي يطرد حضوره في أشعار الشعراء، فكتبوا حياتهم به، ووضعوا قصصا في قالب شعري، وكما يقول الوراري إن “السير الذاتي في شعرنا المعاصر لم يعد يشكل بعدا أو مكونا نصيا فحسب، بل خصوصية بنائية أو بؤرة رئيسة في البنية العامة للنص الشعري”.
الأمثلة كثيرة، وممتدة من تاريخ الشعر العربي إلى عصرنا الراهن. وهو ما يفيد تعبيرهم بالشعر عن حياتهم، إلا أن الكثير من الشعراء، انساقوا إلى إغراء الذات وكتبوا سيرا خالصة، وفقا لتلك التي حدد ميثاقها لوجون، على نحو ما فعل نزار قباني، فمرر تجربته الذاتية في أشعاره، ولم يكتف بسيرة ذاتية نثرية واحدة، بل كتب سيرتين الأولى بعنوان “قصتي مع الشعر” عام 1970، والثانية بعنوان “من أوراقي المجهولة… سيرة ذاتية ثانية” عام 2000. وبالمثل كتب صلاح عبدالصبور “حياتي في الشعر” 1969، وأدونيس “هذا هو اسمي” 1969.
وإن كان ثمة نوع من الشعراء مرروا سيرهم داخل قصائدهم، كما فعل وديع سعادة في “تركيب آخر لحياة وديع سعادة” وصلاح فائق في “مقاطع يومية”، وعبر هذين الديوانين قام الوراري باستخلاص السير ذاتي من قصائدهم. فيرى أن وديع سعادة أعاد بناء حياته من جديد، وحياته الداخلية تحديدا، وركب عناصرها تركيبا كيمائيا؛ فحول الإثنوغرافي إلى عمل تراجيدي، يمليه المحتمل السير ذاتي من شطب ومحو. كما أعاد تشغيل مهملات الحياة وبقاياها الطافية، فجاءته سيرته وكأنها متشظية.
أما صلاح فائق فكانت تجربته مثل شعره، سلسلة غرائب وطرائف لا تجمعها حبكة ما إلا بداعي الاعتبار. كما يحضر داخل الديوان “الميتا شعر” أي الشعر على الشعر، أو كما يعرفه “نوع من السيرة الشعرية تكشف حالات القصيدة ومختبر ذاتها الكاتبة” مثلما تكشف توتر هويات الكتابة، ووظيفتها ومصادرها والتباس مفاهيمها وحدودها الأنواعية، حيث التنظير لمآلات العملية الشعرية وهواجسها والجدوى منها، وهو ما يشير إلى وعي الشاعر الحاد بأدوات عمله التعبيري ومشاريعه الممكنة.
قد يكون العامل الأساسي من وراء كتابة الشعراء لسيرهم نثرا، ليس فقط سرد حياتهم الشخصية، وإنما التعرض لتجاربهم الشعرية وشهاداتهم عن التحولات التي مروا بها، وهم يروضون القصيدة، وقد تأتي كتقييم لمنجزهم الكتابي، ومواقفهم من قضايا الشعر ذاته، وما أثير حول التجديد فيه، وهناك من جعل منها وثيقة للدفاع عن هذا الشعر، على نحو ما فعل صلاح عبدالصبور في “حياتي في الشعر“. كما أن الشعراء لم يكتفوا بتمرير سيرهم وتجاربهم فقط عبر سير خالصة، بل جاءت موزعة في حوارات صحافية وتلفزيونية، ورسائل متبادلة وغيرها، من أشكال وصيغ، تقترب أو تبتعد عن السيرة الذاتية الخالصة.
شعرنة السيرة
يتوزع الكتاب على ستة فصول، وتقديم جاء كتنظير وطرح للأفكار الأولية، حيث تحدث عن تململ نظرية الأنواع. فدينامية الأنواع أدت إلى ولادة أنواع جديدة، إضافة إلى تأثيرات موجة الحداثة التي عرفتها الآداب الأوروبية، وصعود مفاهيم جديدة مثل النص والكتابة، بما أحدثته من خروقات كبيرة جدا حالت دون الاحتفاظ بنقاء النوع الأدبي واستقلاليته.
الغريب أن النص كان يعمل ضد النظرية التي سعت إلى تأطيره في تقاليد صارمة بإقامة الحدود والخطوط للحفاظ على النقاء الأنواعي، والاختراقات التي تعرضت لها، وصولا إلى تداخل الشعري والنثري، وهو ما دفع البعض إلى القول باستحالة الحديث عن الرواية باعتبارها نثرا فحسب، بعد أن اختلط الشعر بالنثر، والتاريخ بالكتابة، خاصة في ظل وجود نماذج استطاعت أن تحقق أكثر من غيرها التخلل الأنواعي كما يقول الوراري.
يؤكد المؤلف أنه ليس بصدد تحليل كل سيرة ذاتية (معلنة وغير معلنة) تحليلا مفصلا، بقدر ما أنه يركز على خاصية التداخل أو التماس الجوهري بين السردي والشعري في بعض آلياته وأطره الخاصة. وهو ما يعني أنه يهتم بتحقق الشعري على حساب السيري. حيث يولي الاهتمام إلى عمل اللغة، وجماليات المحكي الطفولي، وشعرية المفارقة، والغيرية بوصفها أساس ابتكار الهوية، ثم شعرنة السيرة.
لا يكتفي المؤلف بالتعريف الذي قدمه محمد صابر عبيد عن السيرة الشعرية في كتابه “السيرة الذاتية الشعرية: قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية”، حيث وصفها بأنها “سرد نثري يتولى فيه الشاعر تدوين سيرته الذاتية فقط -تاريخيا ومكانا وحادثة- لا يخرج فيها إلى تناول جوانب أخرى غير شعرية من سيرته، ولا على النحو الذي له صلة ما بدعم قضيته الشعرية في السيرة”.
وإنما يمرر مفهوما آخر صاغه وفق تأملاته، وإصغائه للمتون التي استعرضها، يتمثل في اعتبار “السيرة الشعرية تنفتح على الشعر الذي يمنحها حساسية جديدة، ومضاعفة في رؤيتها الذاتية للأشياء والعالم” ثم يدخل بنا مباشرة إلى قراءة النصوص التي انتخبها، وعبرت عن سير الشعراء. فيختار سير ثلاثة من الشعراء هم: غازي القصيبي، ومحمد بنطلحة، ومحمد حلمي الريشة، كتمثيلات للتأكيد على أن شعراء أطراف المركز الشعري لم يتأخروا بدورهم عن اللحاق بركب الحداثة، رغم العوامل السوسيوثقافية الصعبة التي كانوا يواجهونها، وأيضا رغم النظام التقليدي والمحافظ، الذي ألقى بظلاله الكثيفة على مساحات الفكر والحرية والإبداع. لكن انفتحوا على تجارب غيرهم وتأثروا بما كان يروج من مفاهيم الشعرية الجديدة، بل ساهم بعضهم في بلورتها والنقاش فيها.
يعي الشعراء مفهوم السيرة الشعرية المفارق للسيرة الذاتية، فيبدأ غازي القصيبي سيرته “سيرة شعرية” بالاعتراف بأن “فصل السيرة الشعرية عن السيرة الذاتية أمر بالغ الصعوبة” لما يمثله الشعر من أحد وجوه شخصيته الإنسانية. ففي تدوينه لسيرته الشعرية، يسعى إلى تأمل تجربته بأطوارها المختلفة، وتيسير قراءتها وتلقي مراحل تطورها بمنأى عن كل شعور بالغرور والاعتداد بالنفس.
تحفل سير الشعراء بالمؤثرات، التي لعبت دورا في تجاربهم الشعرية، سواء أكانوا شعراء أم كتّابا أم كتّاب رحلات والأخيرة بما تضفيه من اتساع للرؤية وانفتاح على ثقافات جديدة مختلفة عن ثقافة المنشأ وغيرها، بل تتخذ أحيانا من الظروف التي كانت أشبه بالعقبة الكؤود مؤثرا في تشكيل هذا الوعي، للبحث عن منافذ تتجاوز الإطار الضيق أو السجن، الذي وضعت فيه الذات، لتحلق بعيدا عن هذه الدائرة المغلقة على نحو ما نرى في سيرتي فدوى طوقان “رحلة جبلية رحلة صعبة“، ووديع سعادة الذي عرك حياة قاسية ومعذبة لعقدين من الزمان.
وفي بعضها تأتي السيرة كنوع من الانتصارات العابرة والمؤقتة. ومن ثم تنبع أهمية هذه السير التي تقترب من السير الفكرية للكتاب، بتوقفها عند محطات التكوين، وأيضا بتتبع التحولات الفكرية والأيديولوجية وتأثيراتها على الكتابة نفسها.
كما تحفل بعض السير بتأملات في الكينونة الشعرية، وعلاقتها بالوجود، ودورها كمقاوم، وتخطي الحواجز النفسية في مجتمع ذكوري على نحو ما اعتبرته فدوى طوقان في سيرتها، كما تتناول ماهية الكتابة وأسرارها وتحولها، فتطرح أسئلة إستراتيجية تنصت إلى عمل الكتابة، عن حدود امتدادات الواقع في النص الشعري؟ آفاق المتخيل وإمكاناته؟ ما هي طبيعة الديناميزمات التي تحكم علاقة الشاعر بالذات والتاريخ والذاكرة واللغة؟ دون أن يقلل هذا من جنوح بعض السير إلى البحث عن الهوية التي صارت متغيرة، أو موضوعا مفقودا ينبغي العثور عليه ثانيا.
ومن ثم تسعى كتابة السيرة الذاتية إلى “بناء هوية نصية موازية (معادل لغوي وذهني) لتجربة الحياة الفردية في الوجود”. وهو ما دفع البعض إلى ابتكار هوية، باعتبار أن الآخر هو الأنا لو قلبنا منطوق آرثر رامبو.
صحيفة (العرب) الدولية
السبت 2020/03/07
« سير الشعراء ».. ما بين السيرة الذاتية والتخييل الذاتي
عمر شبانة
ما السّيرة الذاتيّة؟ وما السيرة الذاتيّة للشاعر تحديدًا؟ وما السّيرة الشعرية؟ وبمَ تختلف عن سيرة الناثر، وعن السيرة النثرية؟ من يضع الحدود الفاصلة بين هذه كلّها؟
كتاب الشاعر والناقد المغربي، د. عبد اللطيف الوراري، « سِيَر الشّعراء.. من بحث المعنى إلى ابتكار الهويّة » (دار فضاءات ـ عمّان)، يشتغل على موضوع السيرة الذاتية و(الشعرية) لدى الشعراء تحديدًا، فبعد مقدمة نظرية معمّقة وموسّعة، يختار عددًا من الشعراء العرب، ضمن تجارب الشعر العربي المعاصر، فيضعهم قيد الدراسة، التفكيك والتحليل والخلاصات، ويوزّعهم في « ثيمات » وعناوين يجمع عددًا منهم في ثيمة، أو باب، أو يفرد لواحد منهم بابًا خاصًّا.
في الجانب النظريّ
في تقديمه النظريّ للكتاب، يشير الوراري إلى البُعد السّير ـ ذاتي في القصائد والبيانات والمقدمات التنظيريّة لدواوين عدد من الشعراء، ويقوم ضمن جهده النظريّ، كما التطبيقيّ، بالبحث في تعريفات لمفهوم السيرة الذاتية أساسًا، ومفهوم السيرة الذاتية الشعرية أيضًا، ويقوده بحثه إلى تعريف السيرة الذاتيّة الذي وضعه فيليب لوجون، الذي عرّفها بأنّها « حكيٌ استعاديّ نثريّ يقوم به شخص حقيقيّ عن وجوده الخاصّ، عندما يركز أساسًا على حياته الفردية، ولا سيّما على تاريخ شخصيته ». وفي التفاصيل، يضيف الناقد ما تنطوي عليه السيرة من شكل اللغة من خلال الحكي نثرًا، وموضوع الحياة الفردية، ووضعية المؤلف التي تتمثل في تطابقه مع السارد والشخصية، عدا المنظور الاسترجاعيّ للحكي.
كثيرة هي المحاور والأسئلة التي يخوض فيها الوراري، ومن ذلك، وفي باب « تخييل الهوية »، يعرض سؤال الهوية في العبور من السيرة الذاتية إلى التخييل الذاتي، حيث الهوية ستصبح سيرورة ضدية تنجم عن هويّات متعدّدة، والسيرة بدورها تبحث بشكل استرجاعي عن هوية موحدة، أما مؤلّف التخييل الذاتي فهو يخترع ذواتٍ ممكنة. ويستعير الوراري مقولة سيرج دوبروفسكي عن العلاقة بين السيرة الذاتية والتخييل الذاتي « ما يميز السيرة الذاتية أساسًا من خلال معارضتها بالتخييل الذاتي هو أن الأمر يتعلق بنوع يكتب دائمًا في الماضي.. »، ويستنتج أن الهوية ليست كيانًا مستقرًّا، بل سيرورة وضدية، ويرى أن مجد الهوية كامن في أنها متغيرة.
قراءات تطبيقيّة
ضمن هذا النطاق لمفهوم السيرة، والاستعانة بمفاهيم مكرّسة أخرى، يتحرك الناقد تطبيقيًّا، من دون أن يفارقه الجانب النظريّ، ويتصدّى لقراءة سيَر ذاتية وشعرية لشعراء عرب معروفين، بينهم شاعرة واحدة هي الفلسطينية فدوى طوقان، فربّما كانت أو تكون، في اعتقاده، الشاعرة العربيّة الوحيدة التي كتبت سيرتها الذاتية، وفي فصل حول « شفافية اللغة، عمل الذات »، والبحث عن الحافز لكتابة السيرة الذاتية؛ بين النوستالجيا والبحث عن القارئ.
يكتب الوراري عن كتاب فدوى طوقان وسيرتها « رحلة جبلية، رحلة صعبة »، مقترحًا عنوان « البوح الأسير »، ومستعينًا بكتابات عن السيرة الذاتية النسائية، مثل كتاب لطيفة بصير « سيَرهنّ الذاتية: الجنس الملتبس »، وتحليل الناقد حاتم الصكر لما يسمّيه « الصراع السيزيفي في سيرة فدوى »، وحديث الناقد محسن جاسم الموسوي عمّا يسمّيه « أخوة نسويّة شعرية ». والتفاصيل كثيرة في هذه السيرة وقراءتها.
ولكثرة المحاور التي يكتب فيها الناقد وعنها، سنشير فقط إلى أبرزها. وفي البداية، يقدم تحت عنوان « السيرة الشعريّة بوصفها كتابة مضاعفة »، والسيرة الذاتية الشعرية، بعض الكتب/ السيَر لعدد ممّن كتبوا سيرة شعريّة، بدءًا من غازي القصيبي وسيرته « سيرة شعرية »، ومحمد بنطلحة وسيرته « الجسر والهاوية »، ومحمد الريشة وسيرته « قلب العقرب ». وتحت عنوان « عمل اللغة بلا ميثاق » يقرأ الناقد « الجندب الحديديّ » لسليم بركات، حيث اللغة تقابل عنف المجتمع وبِنياتِه السوسيوثقافية بعنف مجازيّ أقسى يطلق الطاقات الإبداعية، ويكسر الحدود بين الشعري والسردي، ويهتك كل ميثاق خارج هذه اللغة بمنأى عن القول الناجز المكتمل نصيًّا. وفي أبواب لاحقة، يتناول تجربة العُماني سيف الرحبي مع الجبال، ووديع سعادة مع البؤس والفقر والمنفى.
وينتقل الناقد إلى ما يسمّيه « جماليّات محكي الطفولة »، بمثابته من جنس السيرة الذاتية، حيث الملفوظات الذاتية التي « لها معنى بالنسبة لنا، وهي قابلة للتشبّع بعواطف قوية »، و »الصعود من دون أي قطيعة مع الحاضر المعاش إلى الأحداث الأبعد في طفولتي »، حسب بول ريكور، بحيث تتحول الذكريات إلى التخييل « واختلاق صوت طفوليّ » بحسب لوجون. وفي الفقرة الأولى، من هذا الفصل، حول « البئر الأولى » لجبرا إبراهيم جبرا، وبعنوان « هندسة الخيال النّاشئ »، يتناول الناقد كيفية التصرّف بذكريات الطفولة البعيدة اختصارًا وحذفًا، واستعادة البراءة المفقودة بإعادة بنائها عن طريق الخيال.
ومن العناوين/ المحاور البارزة في الكتاب « الطفولة بوصفها تجربة »، وفيه يتوقف الوراري عند كتاب « فراشات هاربة »، وهو سيرة للشاعر المغربي، عبد الكريم الطبّال، ليكشف عن الطفولة بوصفها بؤرة للسيرة، وعن ذكريات الطفولة ما بين السيرة والخيال، مع الاحتفاظ بروح الطفولة، عبر استعادة مكان الطفولة وتفاصيله (الأم، السينما والنزوع البطوليّ الحالم والمخلّص، المجاهدون المغاربة، وأعطاب الحرب الأهلية الإسبانية)، وذلك كله ضمن روح تميل إلى الصوفية.
ومن بين كتب السيرة المؤثرة التي يتناولها الوراري، كتاب « رأيت رام الله » للشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، ويسمّي هذه السيرة « سياسات العين اللاقطة »، ومن بين تفاصيل كثيرة يلتقطها الناقد، نشير إلى رؤية البرغوثي لوطنه/ مسقط رأسه بعد منفى طويل « غبش شامل يغلّل ما أراه وما أتوقّعه وما أتذكّره »، ويعتبر الوراري أن المفارقة هنا « تصدر عن ذهن متوقّد ووعي شديد للذات بما حولها »، وقد جعل مريد منها « استراتيجية خطابية »، خصوصًا في رسمه مشهد الجسر والعلاقة مع الجندي الإسرائيلي، الشهداء، وصولًا إلى تسمية العدو بـ »الجانب الآخر ».
وفي معالجته لكتاب « متاهة الإسكافي »، وهو سيرة للشاعر عبد المنعم رمضان، يتناوله الناقد باستفاضة لم يُولِها لسواه، في ثيمة « ابتكار الهويّة »، حيث أن الشاعر، صاحب السيرة هنا، يتحرك بين وقائع حقيقية، أو الإحالة على الواقع، وبين السارد المفتون بتخيّلاته واستيهاماته وهلاوسه ومجازاته، فنحن حيال حياة أخرى يُعاد تأويلها واستنطاق تواريخ صمتها. هي سيرة الأب صاحب الكرامات والأم والجدة والأخت والصبايا والأصحاب، وسيرة الشعر والجسد، وسيرة الهوية المتبدلة في شرائطها الاجتماعية والثقافية والأخلاقية. الطفولة ومصادر التأثير المتعددة والمتناقضة، الدينية والفنية والاجتماعية المحيطة وبطلات الأفلام بأجسادهن « السينما فنّ الإيهام بالواقع، والحياة فن الإيهام بالخيال »، حيوات سرية واستيهامات، والمكتبة هي الملجأ، وأولى محاولات الكتابة. هي باختصار سيرة لابتكار الهوية المشتّتة.
سيرة الشعر والذات
من بين السيَر التي تتناول التجربة الشعرية، أكثر من التجربة الحياتية/ المعيشية، وتحظى باهتمام الناقد الوراري أكثر من سواها أيضًا، كتاب « شطحات لمنتصف النهار »، وهو سيرة شعرية للشاعر محمد بنيس، ويكتب عنه الناقد في باب « كتابة المحو وما تنقاد إليه »، فنرى القصيدة والتصور النظري لشاعرها عنها، حيث شذرات من حالة كتابية شخصية لا تتنكر لمآزقها. وهنا، في سيرة بنّيس تحديدًا، تبرز الثنائيات: المغرب والمشرق، المركز والمحيط، القديم والحديث، الذات والآخر. ومن فاس الطفولة والمراهقة والأم (السيدة محمولةً في صندوق..) حتى باريس ومدريد وبينهما مدن كثيرة، و »مشروع لا يكبر إلا بالقلق والمعاناة ومقاومة أهوال الطريق، بحثًا عن حرية مفتقدة »، و »عبور اللغات » من العربية المغربية الدارجة الى عربية القرآن الى الفرنسية، وعبور الثقافات والأيديولوجيات الكبرى، وسؤال « ما معنى أن تكتب الشعر بالعربية في المغرب؟ » مثلًا.
هؤلاء هم أبرز من أدخلهم الناقد في « مختبره » النقديّ، وكشف عن « خطاب » السيرة الذاتية والشعريّة لكل منهم. ولعلّ واحدة من الخلاصات المهمّة التي يستخلصها قارئ الكتاب هي أن الشعراء لم يقدّموا في سيَرهم الذاتية ما يمكن عَدَّهُ « اعترافات عميقة ومدهشة » بالمؤثّرات التي وجّهت تجاربهم، فليست لدينا إطلالات معمّقة على عالم الطفولة الخصب بالتصوّرات والممارسات. وهو ما يفسّر « الهروب » إلى المخيّلة والتخييل كما يرصده الوراري.
*نشر بموقع (ضفة ثالثة)، بتاريخ 25 يوليو 2022.

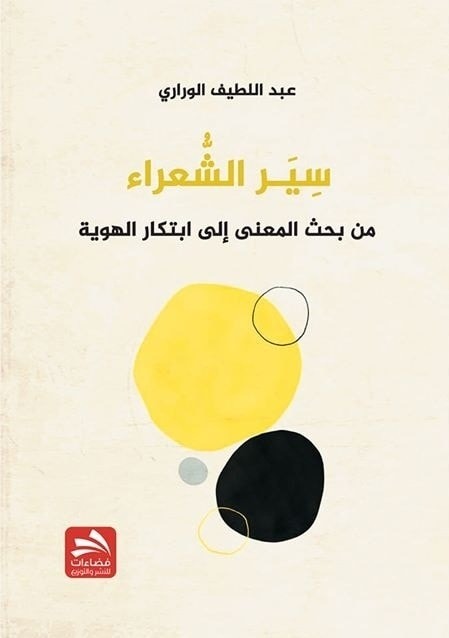
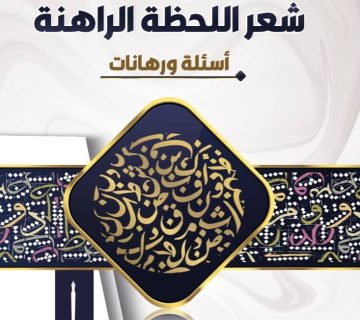
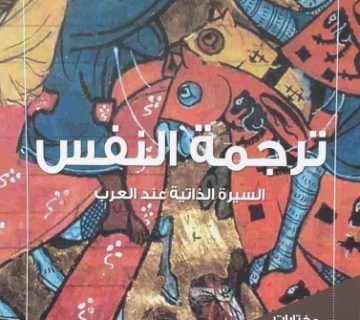
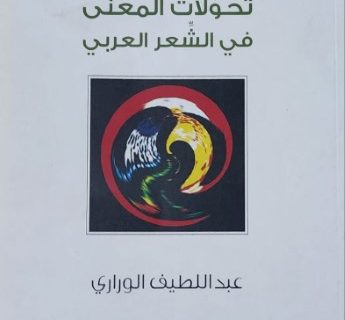
لا تعليق