عبد اللطيف الوراري
إن أيَّ دراسة علمية تتطلب تحديد المفاهيم بما فيها المصطلحات التي تستخدمها؛ فمنذ «فنّ الشعر» لأرسطو، مرورا بـ«علم الشعر» عند قدماء العرب، كانت النظرية الأدبية تسعى إلى تحديد الأشكال الأدبية وتصنيفها وتقييمها، ومن ثمّة كان كلّ نوع أدبيٍّ، تصريحا أو ضمنا، يمتلك سماتٍ مُحدّدة تُميِّزه عن الأنواع الأدبية الأخرى. ويظهر من التعاريف الأولى التي أعطيت لمعنى النوع الأدبي، أن مفهوم النوع يفيدنا في تصنيف الأعمال الأدبية وإعادة تجميعها في مختلف مقولاتها تبعا لمعايير مُحدَّدة، وهو ما عملت على بلورته نظرية الأنواع الأدبية منذ بدايات القرن العشرين. وهكذا نُظر إلى النوع الأدبي باعتباره مُؤسَّسة، وبما أنّ كل مؤسسة تستند إلى تراتبية متواضع عليها، وإذ لا واقع لها خارج التاريخ، فإنّ ذلك يصحُّ بالنسبة إلى الأدب والأنواع الأدبية. يذكر تزفيتان تودوروف، بهذا الخصوص، أنّه «في المجتمع نُمَأْسِس اطّراد خصائص خطابية معينة»، والنوع لن يكون بدوره إلا تَسْنينا لهذه الخصائص، ليعرِّفه بأنّه «طبقة من النصوص» (أجناس الخطاب). وجعل جيرار جينيت تعريف الأنواع باعتباره «الموضوع المركزي للشعرية»، لأنّ الشعرية كـ«نظرية داخلية للأدب» تتمثل مُهمّتها في تحديد السمات الشكلية، التي تُبَنْين إنتاج النصوص الأدبية وتلقّيها من قبل الجمهور. وعدا التعريف الذي يُركّز أساسا على العناصر الشكلية والانسجام الداخلي، يُنبّه جينيت إلى البعد الدلالي الذي لا يختزل الأنواع الأدبية إلى مجرد خصائص بنيوية: «معايير تعريفها تحتوي دائما على عنصر ثيماتي ينفلت من الوصف الشكلي أو اللساني البحت» (نظرية الأنواع).
وإذا كانت الثوابت هي التي تُحدِّد هُويَّة النوع بعد أن تكون قد استقرّت عبر فترة طويلة، فإنَّ النوع نفسه يمتلك حقلا غنيّا من الإمكانات المتنوعة والمتغيرة وحتى المتعارضة، وهو ما يساهم في عملية خلق البنية وتنويعاتها واتساعها، إلى الحدّ الذي يجعله في غير مأمن من الاختراقات التي تحدث من حين لآخر. فالنص- حسب عبد الفتاح كيليطو- وإن لم يحترم العناصر الثانوية «فإنَّ انتماءه إلى النوع لا يتضرر. أما إذا لم يحترم العناصر الأساسية «المسيطرة» فإنه يخرج من دائرة النوع ويندرج تحت نوع آخر، أو في الحالات القصوى، يخلق نوعا جديدا» (الأدب والغرابة).
هكذا تنشأ أنواعية النص بالأحرى من الدينامية التي تنبني بين سمات النوع التي يدلُّ عليها المؤلِّف- جماع القيود الشكلية، الثيمات، الصيغ والموتيفات، مثلما الوظائف التي تناط بها- وسيرورة تعرُّف هذه السمات التي ينخرط فيها القارئ (جريانا، تصنيفا، قراءة، إعادة تأويل).
النوع السيرذاتي
بخصوص النوع السيرذاتي، فإنّنا نجد مجموعة من المنظّرين من أمثال: جورج غوسدورف، وجان ستاروبنسكي، وفيليب لوجون، وإليزابيث بروس وغيرهم، عملوا على تحديد معالم السيرة الذاتية على نحو دقيق وصارم، في النصف الثاني من القرن العشرين. وإذا شاع أنّ البدايات «الرسمية» للسيرة الذاتية باعتبارها نوعا قائم الذات، ترجع إلى نهاية القرن الثامن عشر للميلاد، بعد نشر (اعترافات) جان جاك روسو، فإنّه تجدر الإشارة إلى أنّ ثمة نصوصا يمكن أن تنضوي تحت هذا الصنف، حتى لو أنّها لا تتفق والنموذج النظري الذي لم يكن موجودا بعد، وتترسم طرائق السيرة الذاتية حتى قبل أن تُعرف هي نفسها بوصفها نَوْعا نوعيّا، بل الأدهى في الأمر، كما ينتبه إلى ذلك توماس كليرك، أن يكون قد حصل هناك ميل عام إلى تصنيف عدد من الإبداعات الأدبية ضمن «السيرذاتي»، وهو ميل تفاقم من خلال نوع الاستعمال الشعبي للأدب، وأحيانا من طرف الكتاب أنفسهم.
ويمكن أن يكون التمييز بين هذه الأنواع من «كتابة الذات» والسيرة الذاتية مُلائما، لأنّ السيرة الذاتية تبدأ حقيقة من اللحظة التي يكون فيها هناك قُرّاء شديدو الاهتمام بحياة أُناسٍ ليسوا بالضرورة «رجالا عظاما»، غير أنّ القطع مع هذه المرحلة من الالتباس كان ذا أولوية، والانتقال إلى الحديث عن السيرة الذاتية باعتبارها نوعا أدبيّا، وباعتبارها قادرة على أن تتحدّد كنموذج للقراءة المبررة بطبيعة النصوص التي تنسجم معها، بل وحسب أدبيَّتها التي أخذت تنزع إليها وتُحقِّقها في العقود الأخيرة. وفي هذا السياق، فإن أكثر السير الذاتية عبر تاريخها لم يكتبه أفراد من المؤسسة الأدبية، وإنما من خارجها، وهو ما جعل ج. هيو سلفرمان يستخلص أنها نمط غير أدبي من أنماط النصية.
ميثاق السيرة الذاتية
أثْرت الأعمال التي قدّمها فيليب لوجون، منذ عقد السبعينيات من القرن العشرين، التأمل النظري حول السيرة الذاتية، وإن كان مثل هذا التأمل موجودا قبله، إلا أنه بقي مُقيّدا في بحوث ذات طابع موضوعاتي وتاريخي، كانت ترجئ القضايا الإبستيمولوجية إلى مرحلة ثانوية. وقد شكّل التعريف الذي أعطاه فيليب لوجون للسيرة الذاتية في كتابه ذائع الصيت «ميثاق السيرة الذاتية» (1975)، مرحلة تدشين داخل نظرية النوع، وسمح بتسليط الضوء على مختلف السمات المخصوصة التي تُميّز السيرة الذاتية عن باقي أشكال الأدب باستعمال ضمير المتكلم، أي قدّم الوصف النظري للنوع وللأشكال التي يستعملها. وكان هذا المؤسس صرّح في بدايات اهتمامه بهذا النوع أنّه «عندما نصل إلى جزيرة غير مستثمرة، فإنّ أول ما نسعى إليه هو رؤية مجموع الأرض، ورسم حدودها، ورفع خريطةٍ موجزة عنها».
بعد استقرائه للمتن الذي يغطي، تاريخيّا، نحو قرنين من الزمن (منذ 1770) ولا يشمل إلا الأدب الأوروبي، وضع فيليب لوجون للسيرة الذاتية تعريفا يتغيّى منه التحليل المنهجي لهذا النوع المثير للجدل، عبر تمييز مستويات الوصف التي يتضمنها. ففي «الميثاق السيرذاتي»، يستعيد لوجون تعريف السيرة الذاتية الذي كان قد صاغه من قبل في «السيرة الذاتية في فرنسا» (1971)، بعد أن عدّل فيه، فعرّفها بأنّها: «حكيٌ استعاديٌّ نثريٌّ يقوم به شخص حقيقيّ عن وجوده الخاصّ، عندما يُركّز أساسا على حياته الفردية، ولاسيّما على تاريخ شخصيته». ويراهن هذا التعريف على العناصر التي تنتمي إلى ثلاث مقولات مختلفة:
شكل اللغة: الحكي نَثْرا.
الموضوع المتناول: الحياة الفردية وتاريخ الشخصية.
وضعية المؤلف: تطابق المؤلف والسارد والشخصية، عدا المنظور الاسترجاعي للحكي.
لقد استدعى مثل هذا التعريف بعضَ المعايير، أهمُّها: معيار شكلي إذ يتعلّق بالحكي نثرا، ومعيار موضوعاتي إذ يعالج الموضوع حياة الفرد وتاريخه الشخصي، ومعيار مرتبط بمنظور الحكي الذي يكون استرجاعيّا في الغالب، ومعيار تلفُّظي إذ يحصل هناك تطابقٌ بين المؤلّف والسارد من جهة، وبين السارد والشخصية الرئيسية من جهة أخرى. ويفترض المعيار الأخير أن تختبر السيرة الذاتية قدرتها على التوليف بين الذات وتاريخها الشخصي، بحيث يعيد المؤلّف «بناء» حياته مانحا إيّاها معنى من المعاني.
وطالما أنّه توجد سيرة ذاتية، يجب إذن أن تتمّ الشروط في أيّ مقولة من هذه المقولات الأربع، ولا يكون ذلك في الأنواع المشابهة للسيرة الذاتية. ومع ذلك، يلاحظ لوجون أنّ مختلف هذه المقولات هي متفاوتة من حيث إجباريّتها، وأنّه يمكن أن توجد من سيرة ذاتية إلى أخرى، إن على مستوى شكل اللغة والموضوع المتناول، أو موقع السارد، من دون أن يتمّ ذلك بصورة كُلّية. لكن هذه الاختلافات ليست إلا «مسألة نسبية»، أي في الدرجة.
وإن كان لوجون يحاول أن يُوسّع تعريفه للسيرة الذاتية ليسمح ببعض درجة التنوُّع من نصّ سيرذاتي إلى آخر، فإن تعريفه ما يفتأ يعتمد على التصوُّر التقليدي والاختزالي للنوع، إذ ينظر إلى السيرة الذاتية بأنّها «سيرة الشخص الذي كتبها بنفسه». هذا التعريف للسيرة الذاتية بوصفها مختلفة عن السيرة التي تقوم على وقائع وأحداث تاريخية أو واقعية، نجده يجري عند النقاد إلى نهاية الستينيات من القرن السابق. فالسيرة الذاتية عند ستاروبنسكي هي «سيرة الشخص صنعها بنفسه» (1970). فيما يقترح جورج ماي بعد تسع سنوات، التعريف نفسه: «السيرة الذاتية هي السيرة التي كتبها هذا أو تلك ممّن هو الموضوع فيها». لكن الأهمية في تعريف لوجون قد مُنحت، بالفعل، للميثاق السيرذاتي الذي يفترض أن يكون بين المؤلف وقارئه، وهو ما سمح له بأن يُميّز بوضوح السيرة الذاتية عن السيرة، ولاسيما عن الرواية السيرذاتية، ومن ثمّة أن يفرض تحديدات صارمة تتأسس عليها السيرة الذاتية.
الميثاق السيرذاتي وإشكالية التطابق
إنّ العمل لا يكون سيرة ذاتيّة إلّا عندما يكون هناك تطابقٌ بين المؤلّف والسارد والشخصية، وكلّ سيرة ذاتية حقيقية تسعى إلى تأكيد هذا التطابق. فوجود ما يُسمّيه لوجون بـ(الميثاق السيرذاتي) يسمح بتمييز نوع السيرة الذاتية: «إن السيرة الذاتية (الحكي الذي يروي حياة المؤلف) تفترض أنّ هناك تطابُقا في الاسم بين المؤلف (مثلما يظهر من اسمه على الغلاف) وسارد الحكي والشخصية التي يجري الحديث عنها. هذا هو المعيار الأبسط الذي يُعرّف في الوقت نفسه السيرة الذاتية، كما جميع أجناس الأدب الحميمي الأخرى (اليوميات، البورتريه، المقالة)».. فهذا التطابق بين الثلاثة (المؤلّف، السارد والشخصية)، الذي يُمثّل واحدا من أسس الميثاق السيرذاتي والمعيار الوحيد الذي يسمح بتمييز السيرة الذاتية عن غيرها، ويضمنه اسم العلم، يمكن أن يتأسس من جهتين: عبر استعمال العنوان بوصفه «سيرة ذاتية» أو «قصّة حياتي» استعمالا لا لبس فيه، أو عبر التزام المؤلّف تُجاه القارئ منذ بداية النصّ. ففي حال ما إذا أدمج المؤلّف معلوماتٍ سيرية حقيقيّة فإنّ ذلك ليس يكفي، بل ينبغي أن يحصل هناك اتّفاقٌ أو تعاقدٌ مُسْبق بين المؤلف وقارئه، بحيث يلتزم الأول بأن لا يقول إلا الحقيقة ويكون مؤتمنا في ما يخصّ حياته. في مقابل ذلك، يُقرّ القارئ بأن يمنحه ثقته.
والسيرة الذاتية، مثلها مثل السيرة نفسها، هي نصٌّ مرجعيّ، هدفها ليس «أثر الواقعي» كما في الرواية، بل الحقيقة. فهي تُقدّم معلوماتٍ يمكن أن تخضع لاختبار صدقيّتها. وهذا «الميثاق المرجعي»، بتعبير لوجون نفسه، هو عموما يقع ضمن الميثاق السيرذاتي. ومن النادر أن نجد مؤلّفا قد أقسم بأغلظ الأيمان أن لا يقول إلا الحقيقة. ومع ذلك، فهو غالبا ما يلتزم بأن يقدّم الحقيقة مثلما تظهر له، أو مثلما يعرفها، ومن المفترض أنّ «ما يحكيه عن ذاته ينبغي أن يكون حقيقيّا» كما يقول توماس كليرك. لكن مع ذلك قد يُنوّه إلى ما يمكن أن يواجهه من مشاكل الذاكرة من سهو ونسيان وسواهما. وهو يتذكّر، غالبا ما ينسى المؤلف حقيقة ما مضى من ذكرياته، وقد يصفها بطريقةٍ رومانسية؛ أو بتعبير ميرو، فقد «تعيد فصول السيرة الذاتية الأولى إنتاج الكون السعيد، الزمن الثوري حيث براءة الذات، وعد الحياة المفتوحة على كلّ الإمكانات، والأوهام المتعددة بلا شكّ» (لسيرة الذاتية، كتابة الذات والصدق).
إن المؤلِّف، وهو ذات النص وموضوعه في آن، يريد أن يكون صادقا وأن يحكي ذكرياته كما عاشها، أي يعيد إنتاج الحقيقة مثلما عاشها، والعالمَ وفق رؤيته. إنّه «الشخص الحقيقي»، وهو وحده من يمكن أن يحتمل ما يقوله ويتحمّل الصدق فيه، أي يتحمّل مسؤولية تلفُّظه عند وضعه لاسمه على ظهر غلاف الكتاب. وذلك بخلاف الشخص الخيالي الذي يفترضه التخييل، فلكي يلفظ السيرة الذاتية يجب أن يكون الكائن الإنساني مكوَّنا باعتباره شخصا نفسيّا، أخلاقيّا واجتماعيّا. وهذا التشبُّث بـ«الحقيقي» يميّز بشكل أوضح السيرة الذاتية عن الرواية السيرذاتية، وإن كان التحليل الداخلي للعمل لا يمنحنا أيّ معيار سليم لتحديد النوعين معا: جميع الطرائق التي تستخدمها السيرة الذاتية من أجل أن تقنعنا بأصالة حكيها، يمكن أن تقلّدها الرواية، وغالبا ما قلّدتْها. وإذن، يفترض مفهوم «الميثاق السيرذاتي» بناء عقد يمكن نعته بـ«الأخلاقي» بين المؤلف وقارئه. لذلك يسمّيه فيليب «التصريح بالقصد السيرذاتي»، التصريح الذي يبرهن على صدق المؤلف، تبعا لمثل هذا المشروع. فالأمر بالنسبة إليه يتعلق بقول الحقيقة عن حياته، لكن بواسطة طرائق الرواية نفسها، أي عبر منحى التخييل.
إن مفهوم «الصِّدْق» مهمٌّ، لأنّه يقع في صلب المسعى السيرذاتي المفارق أساسا، بحيث يجب أن يناقش هذا المشروع الصّدْقَ المستحيل وهو يستفيد من جميع أدوات التخييل الاعتيادية. ولهذا، يعود لوجون في كتابه «مسودّات الذات» فينعت ميثاق السيرة الذاتية كأنّه «وعد بالصدق»، ويقصد بـالسيرة الذاتية جميع النصوص التي يتكلم فيها المؤلف عن نفسه ملتزما، وجها لوجه أمام الغير أو مع نفسه، بقول الحقيقة. وهو الصنيع نفسه الذي يقيمه في كتابه «أنا هو الآخر» وفي كثير من مقالاته خلال سنوات التسعينيات.
فمن غير البديهي البتّة أن يحكي المؤلف عن نفسه من غير أن يعيد اكتشافها، وهو ما يمنح لعناصر مبعثرة من مسار حياته التي لم تكتمل بعد، معنى وانسجاما. ومن هنا، فإنّ ما يسعى إليه المؤلّف هو أن يكون صادقا مع نفسه وأن يُنشئ ثقة بينه وبين القارئ تتنامى طوال العمل وسيرورة تلقّيه، والأهمّ أن تكون لديه الرغبة في أن يروي حياته على القارئ الذي يمكن، في أحسن الأحوال، أن يفهم حياته الداخلية.
إن الميثاق السيرذاتي هو اتفاق محض، قاعدة اللعب، لكن اللعب الذي لا يكفُّ عن أن يكون لعبا تحت ذريعة أنّه يخضع لقواعد محدّدة. وهذا يذكّرني بأحد الباحثين؛ وهو أريان بولزانتزاس، الذي يرى ميثاق السيرة الذاتية باعتباره مشروعا من المتعذّر تحقيقه، بحيث إنّ الكتابة وإعادة الكتابة تقيمان الدليل على وجود إعادة البناء، وبالتالي غياب الأصالة الملازم للحكي.


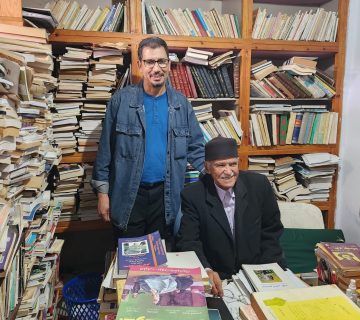
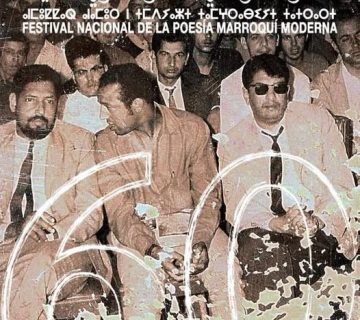

لا تعليق