(1)
ارتبط الشِّعر عندي باليُتْم والفقدان، كلُّ كلمةٍ فيه هي مجاهدة وبحث. عندما نزحتُ أنا وقريني اليتيم من قرية نائية ذات غروب، وأنا أحمل معي أصداء الغياب الكبير وشهواته المُدْماة. كلّ كلمة أزرعها في الورقة هي، بمعنى ما، أليغوريا عن استعادة فجر مسفوح وراء الأكمات.
هابطًا مثل مَجْرى نَحيلٍ من ينابيعـهِ النضّاحـة بالفقد الفـردي والإنساني، من قريتي الصغيرة إلى عالم المدينة بحشودها ومشاهدها المتناقضة، حاملاً معي « عَرَقَ » سلالة بسيطة ومنسيّة في ذلك الصقع من المغرب العميق، وحاملاً ما كانت تغدقه الطبيعة المترامية الأطراف على حواسّي الوليدة من ضوء وموسيقى وثمار. ما زلتُ أذكر كيف أنّ أُمّي الطبيعة أتاحت لي برموزها وإشاراتها وإيقاعاتها أن أطالع أكثر من كتابٍ تنشره وتطويه بين ناظريّ. نشأتْ تربيتي العاطفيّة بمرأى المشاهد الزاخرة والمفتوحة في الفضاء الطلق والرحيب، والتي كانت عزاءً لي في سنوات اليتم، وحين أتتْ تمارين الشعر الأولى ألحت عليّ وسارت معي في رِكاب الوزن والقافية والأوهام الناشئة. وهكذا، فالذي أتى بي إلى الشِّعر، ثلاثة عناصر: كتاب الطبيعة، ومزاجي القروي الخالص، والتعويض عما كنتُ أفتقده منذ يُتْمي الباكر وأبحث عنه في أثر السلالة.
(2)
بعد ثلاثين سنة من البحث ومن ملاحقة الأحلام، ومن اللعب بأطراف النسيان، أعتقد أنّ معركتي الأساسية التي خُضْتُها، بوعي أو في غفلةٍ مني، هي أن يُعطي معنىً لما أكتب، وأن يُستأنف الوعد بهذا المعني بشكل غير قابل للفصل؛ كأنّي أحاول صَقْل منظر الغروب، أو أنّي أثأر لحياةٍ صغيرةٍ مُغرَّر بها، وأوهامٍ بالكاد تخطو لِمُجرّد أن تخطو. حياتي في الشِّعر؛ حياتي الداخلية، وحياتي في ليل الكلمات، هي صدى مديد لحقولٍ من الغناء المجروح. كنت دائمًا أحاول أن أُقْنع غيري بأنّ رهان الكلمة هو وَصْلُ ما ٱنْقَطع ليضيء أكثر، إلى أن أخذتُ أُضحّي بأشكالٍ من الغرور والرضى عن النفس لأقنع ذاتي بالعمل في السرّ والغموض؛ كما لو كان دَرْسَ عزاءٍ عن ذكريات جميلة ولّتْ، وإصغاء لما هو آتٍ، ومحاورة مع أطياف الصمت بين إيقاع الكلمات.
كان مشروع َالكتابة يتحوَّل من شِبْه المُطوَّلة التي تدّعي قَوْلَ « كلّ شيء » إلى الشذرة التي تتعلّم كيف تقول “أَبْعاضًا” من سيرتي وتكتب هشاشتها بشكل كثيف. وقد أحرقتُ إليه قِطَعًا من مركبي المترنّح بين الأيّام، بعدد الخسارات والأوهام الجميلة، لا بحظوة الألقاب وعمى الحقائق المزعومة. وعلى هذا المِحكّ، كان المشروع يتبلور في وجداني ليأخذ صفة الهشّ الضروري؛ فهو لا يقودني إلى ضَرْبٍ من « البكائيّات »، أو العزف على ما فات، بقدر ما يجلو أمام عينيّ مرآة حياتي التي لم أَعِشْها، بصيغة شذرات وملفوظات مرتجفة. ثمة ٱستعادةٌ للماضي، ليس بذريعة التأسي والحنين، وإنّما هي من أجل البحث عن أثرٍ لحقيقة شخصية ضاعتْ أو تَبدّدتْ في لا شعوري السياسي من خيبات الذات والثقافة والمجتمع، والذي ما زال ينبض مثل الفجيعة في صميم الكتابة.
ولهذا، تجد أنّ ما أكتبه يتذكّر ماضيه بٱستمرار، ولكن يريد ألا يترك وراءه العلائم السهلة التي تدلُّ عليه. هذه رحلةٌ لا ٱستقرار فيها ولا طمأنينة، وإنّما القلق وحسب؛ وإلا فما قيمة الكتابة خارج شرعة البحث اللانهائي. من باكورتي الشعرية « لماذا أشهدتِ عليّ وعد السحاب؟ » (2005)، إلى عملي الشعري « قرطاس: سيرة شعرية » (2022)، أزعم أنّ ثمة سيرورةً، وثمة تحوُّلًا أحرص عليه في كلّ مغامرة أخوضها، يندفع فيها الشكل الشعري بوصفه حساسيّةً وأسلوبًا في الكتابة إلى ما تصيرُهُ ذاتي أو إليه داخل هذا العالم المتلاطم بألغازه وحوافّه. كلّ ديوان هو امتدادٌ لما سبقه على نحو من الأنحاء، وليس تواضُعًا إذا قلت إنّ علاقتي بما كتبتُه سابقًا ليست على ما يرام؛ إذ كُلّما فرغتُ من ديوان جديد قلتُ في نفسي إنّه عملي الأول. دائمًا ثمّة هَجْسٌ عجيبٌ بالبدايات، بقدر ما يوازيه شعورٌ بالنقصان وقلق الكتابة.
(3)
سُئِلْتُ أكثر من مرة: لماذا النّقْد؟
لم يكن الأمر هيّنًا في أول الأمر بالنسبة إلي، ولكن مع الوقت استأنست به وتعرّفتُ عن طريقه إلى ما به يكون الشعر معرفة وفنًّا وفضاءَ تلاقُحات. لا أنكر أنّ التأليف فيه شاقّ للغاية، ومتعبٌ بسبب ما يُلْزِمه على المشتغل به من صرامة وتدقيق وتحرٍّ، يكون في كثير من الأحيان على حساب مزاج الشاعر وفسحته.
في الذهاب- الإياب بين الممارسة والنظرية، أحرص على أن يكون نَقْدي من صميم الشِّعر، مُتخفّفًا من صرامة الآلة وضوابطها؛ فكل منهما يُلبّي حاجةً روحية وكيانية، علاوةً على ما ينهضان به من أعباء المعرفة والتأمل. أنا باحثٌ عن الشعر، وشغوفٌ بمعرفة الشعر، ولا أدّعي العلم بالشعر. يتهيّأ لي أنّ كتبي في الشعر وفي نقد الشعر هي في معظمها نتاج هذا الحوار الداخلي بينهما، وما به يكون استئناف الوعد قائمًا، بحسب تطوُّر التجربة الجماليّة مُفْردًا وجَمْعًا.

 *نُشر في مجلة الأديب العراقي، العدد 1/ السنة 64- 2025، ص177- 178.
*نُشر في مجلة الأديب العراقي، العدد 1/ السنة 64- 2025، ص177- 178.




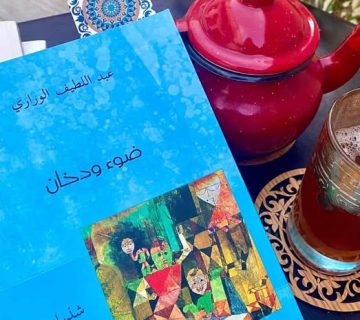
لا تعليق