يرجع الغنائي Lyrique، المصطلح الثالث من الثلاثية الأرسطية المعروفة، إلى مقولة النوع «غير التخييلي» الذي يتحدّد بأنّ «أنا ـ الأصل» فيه هو الشاعر نفسه؛ أي حين يتكلّم في خطابه بـ»ملفوظٍ واقعي» لا بـ»ملفوظ تخييلي»؛ وبالنتيجة، يرجع الأنا الغنائي إلى التلفّظ التاريخي أو المرجعي. ويستتبع ذلك تحليل طرائق بناء الملفوظ الغنائي لا في ضوء الخيارات الأسلوبية التي تلوذ بها الذات في تنظيم دوالّ الكتابة وقيمها المهيمنة الخاصّة بإنتاج خطابها الشعري، بل كذلك في ضوء اشتراطات النوع الأدبي بوصفه مؤسسة ثقافية تتبدل أعرافها وأوفاقها الجمالية من عصر إلى عصر. وهو ما يقودنا إلى اعتبار مقولة الغنائيّ تتجاوز ميدان القراءة المباشرة، فيما هي تتحدد بالتجربة الجمالية التي يمكن للقارئ أن يحدسها ويبني عليها فعله النقدي المستند إلى المعارف التاريخية والنظرية.
ولهذا، ينبغي أن يتجاوز موضوع الغنائية في الشعر مستواه الأنواعي الكلاسيكي المتمثّل في المقارنة بين الشعر والنثر، وتصنيف الشعر ضمن تصنيفات الأدب، إلى مساءلة النسق الداخلي للغنائيَّة وهي تعمل في سياق فنّي وجمالي مختلف، ما دام الافتراض يقوم على اعتبار النوع الغنائي ليس سلطة معياريّة قبلية ولا تاريخيّة متصلبة ومتعالية على الزمن، بقدر ما هو نسق داخلي مُتحوّل، لا يوجد إلا من خلال النصوص التي تَعْبُرها وتُعبّر عنها الذات في تنظيم معناها داخل الخطاب.عبد اللطيف الوراري
سمات محددة
يمكن أن نسوق، بمنأى عن كلّ وثوقية، جملة من السمات التي تنتظم النوع الغنائي:
أوّلاً ـ أنْ تأتي القصيدة في العموم قصيرةً وموجزةً وبالغة الكثافة، لكنّها قد تزيد على ذلك إذا رأى الشاعر فيه بلورةً لصوته الإنشادي وموقفه الغنائي داخل القصيدة ومعماريّتها العامة.
ثانياً ـ أنْ تعبّر عن «الأنا ـ الأصل» للشاعر الذي يتكلم بقدر ما يُفصح عن تجربته الداخلية، صوته الداخلي، عالمه الداخلي بكلّ ما يفضّ عنه من روح جيّاشة في التعبير.
ثالثاً ـ أنْ تتحرّك في سياق نوعيّ ومتنوِّع من الثيمات والرؤى المنتجة للمعنى الشعري، التي تستدخلها أنا الشاعر (الحبّ، الرثاء، الإشراق الصوفي، سخاء الطبيعة، بعد الحياة، وطأة الإحساس بالزمن، إلخ).
رابعاً ـ أَنْ تنقل مجمل القيم الخاصّة بإنتاج «كَوْنٍ دلاليٍّ» يفتح الأنا الغنائي على الأشياء والعالم، فلا تُقيم فصلاً بين الداخل والخارج، الذّات والآخر، المحسوس والمجرَّد في مزيجٍ خلاقٍ يخلق وحدة الموضوع، ووحدة البناء، ووحدة الانطباع التي تتأتي من جماع ذلك.
خامساً ـ أن تكون شفّافةً وعالية التركيز في تدبير نسقها الدّاخلي، لأنّ القصيدة الغنائية تبقى قريبة من الغناء، ومن شفافيّة الغناء بالنظر إلى نوعيّة بنائها المعماري ككلّ.
سادساً ـ أن يأخذ فيها الإيقاع وضع «الدالّ الأكبر» لأنّه ينظّم معنى الذّات في خطابها، ويُنْقذ البناء النصّي من التبعثُر والتفكُّك عبر آليّات التكرار والتقفية والتوازي والهندسة الصوتية وتذويت الدلالة.
سابعاً ـ أن تتخفّف من «الملفوظ التمثيلي» ومن السردي الذي قد يُشيع الروح الدراميّة داخل النص، وإن كان ذلك لا يمنع أن تهجر نقاءَها الأنواعي، فتستثمر الملحمي في علاقتها بالتاريخ والأسطورة والرمز. وقد رأينا قصائد كثيرة حملت دلالاتٍ وأبعادٍ غنائيّة جديدة ضمن سياق النص الشعري العربي الحديث وثقافته الجديدة. قد نتفق على طبيعة أو مردودية هذه السمات التي تنتظم «القصيدة الغنائية» بالنظر إلى خصوصية بنائها المعماري، وحضور الصوت الفردي لأنا الشاعر وشفافية التعبير عن عالمه الداخلي، وطبيعة الموضوعات والقيم الخاصّة بإنتاج كونها الدلاليٍ والرمزي، الذي قد ينفتح على ما هو «ملحمي» إلا أن هذه السمات «الاستدلاليّة» تبقى، مع ذلك، حاجبةً لما تفرّق في هذه القصيدة وأشكل عليها، قياساً إلى أنساق الكتابة والأسلوب وروح العصر؛ إذ لكلّ شاعر أسلوبه وتصوّره للكتابة كفعل وموقف. ومن هنا، يصير إدماج مفهوم الخطاب في القراءة ضرورة، لأننا به يمكن أن نقرأ أشكال الطرائق التي تسند تدبير المبدأ الأنواعي للغنائية في الشعر؛ أي علينا أن نُراعي بنية الخطاب في الشعر، التي تحمل في ذاتها عناصر تكرارها أو عناصر انحلالها وزوالها. ومن هنا، ينبغي أن نأخذ بفرضية اشتغال الغنائية أكثر من وظيفتها، والذي لا يتقوّم إلا داخل خطابها الخاص في علاقته بالقيم والخصائص المهيمنة، بما في ذلك الذات والمعنى والإيقاع أساساً.
عصب التجربة
تُشكّل الذات عصب الغنائية وحافز انبنائها داخليّاً، وقد شاع في نظريّة الأنواع الأدبية أنّ الشعر الغنائي هو شخصية الشاعر نفسها، أو هو الأثر الأدبي الذي يتكلم فيه الشاعر بمفرده، ولذلك فإن الذي يتكلم في الشعر الغنائي، إنّما هو الشاعر عبر أناه الأصلي الذي يرتبط بـ»ملفوظٍ واقعيٍ». فإذا كان كلّ ملفوظٍ واقعيّاً، على نحو ما، فإنّ «واقع» الملفوظ ينشدّ إلى تلفُّظه من خلال الـ»أنا»؛ أي كملفوظٍ لذاتٍ متلفِّظة. ومن ثم فإنّ الأنا الغنائي لا يتطابق مع الكاتب كشخص، إلا في المستوى المنطقي دون أن نحكم مسبقاً على أيّ علاقة بيوغرافية -أنّى كانت- بينهما. وبطبيعة الحال، كما تؤكّد كيت هامبورغر، «يمكن أن تكون التجربة تخييليّةً، بيد أنّ ذات التجربة، ومعها الذات المتلفظة والأنا الغنائي، لا يمكن أن تكون إلا حقيقيّةً». وفي عبورها من المحور اللساني إلى الأدب، والشعر أساساً، تمتدّ الذات من استعمال عوامل التلفُّظ إلى الانتظام في نسق الخطاب برُمّته. داخل الخطاب، تصبح الذات تاريخيّة اجتماعيّاً وفرديّاً، ومن ثمّ تتمظهر الذّات المتلفظة كعلاقة أو جدل بين الفردي والجمعي.
ومن هنا، فإنّ التمظهرات الخاصّة بالذات والذاتية التي ينتجها الأنا الغنائي ويعبر عنها داخل نظامه التلفّظي، يجب أن تُحلَّل بناءً على مبدأ نسق الخطاب كاشتغال للغة وعبرها. وهكذا تبقى الغنائية الميدان المميز لعمل الذات وتعبيريّتها، في انحيازها للغناء كشرط لشفافية التعبير عن أحاسيسها، وفي رؤيتها للعالم عن طريق السحر السامي للكلمة الشعرية.
في الصفحة الأولى من كتاب أرسطو طاليس «فنّ الشعر» يجري تحديد الشعر في ضوء مبدأ المحاكاة؛ فهو فنّ المحاكاة، وبصيغة أدقّ عن طريق الوزن واللغة والموسيقى. وفي ما بعد تمّ حصر المحاكاة في «محاكاة الفنون الجميلة» التي تخضع للمبدأ نفسه، بما في ذلك الشعر الغنائي الذي يتوزّع في فنون صغرى متنوّعة ومشتقّة منه، ووظيفته تتمثل في «رسم الحالة الوحيدة للرُّوح وإحساسها المجرَّد». فإذا كان موضوع الأجناس الشعرية، الملحمي والدرامي تحديداً، يتمثّل أساساً في الأفعال، فإنّ الشعر الغنائي يختصّ بالأحاسيس. وقد تكون هذه الأحاسيس المعبَّر عنها في الغنائي متصنِّعةً أو أصيلةً، لكنّها تخضع لقواعد المحاكاة الشعرية، بمعنى أن تكون ممكنة التحقُّق ومختارةً ومكتملة كما هي في حقيقتها. وفي هذا السياق، يجب التّذكير بأن المحاكاة في التراث الكلاسيكي لا يعني التصوير المطابق للأصل، وإنّما هو حالة من الخيال. وقد وجدنا الفلاسفة المسلمين يبنون تصوُّرهم للمحاكاة على مقولة التّخييل، وبالنتيجة على وظائف التّعجب والغرابة واللذّة التي يستثيرها الشعر في النفس، فأرادوا بمصطلح التّخييل الدلالةَ على معنى المُحاكاة الشّعرية، ونظروا إليه بوصفه العلّة الصُّورية للشّعر، وإلى المعاني التي يتضمّنها الشعر بوصفها علّته المادية. وهكذا أمكننا أن ننتقل من مجرد إمكانية التعبير الخيالي إلى وضعيّة خيالية أساسية للأحاسيس المعبَّر عنها، وأن نُوصل كلَّ قصيدةٍ غنائيّةٍ إلى النموذج الذي يطمئن للحوار الداخلي المأساوي، حتّى نتمكَّن من أن ندخل في جوهر كلَّ خلقٍ غنائيٍّ ذلك الفاصل من الخيال الذي يستحيل، بمعزل عنه، تطبيق مفهوم المحاكاة على الشعر الغنائي، كما يرشدنا إلى ذلك جيرار جونيت. ولهذا الاعتبار، رُبِطت المحاكاة بوجوه البلاغة والمجاز لتوصيل المعنى وتأدية دلالاته بطرائق خاصّة غير عادية، على مستوى التشكيل والتأثير. فهي عمليّة مرتبطة بتقديم المعنى أكثر من ارتباطه بالمعنى نفسه. لن نتتبّع المعنى في ثيماتٍ معلومة ومقرّرة سلفاً، ونختصرها في نموذجٍ لغوي فجّ. فالذي يهمُّ، هنا، ليس المعنى، بل طريقة بلوغ المعنى؛ أي أن يبحث في المعنى بالمعنى الذي يكون فيه، بالنسبة إلى شعريّة الخطاب، باثّاً الدلاليّة التي تتجاوز الدليل المعجمي للكلمات، عبر آثار تداعيها مع دوالّ أخرى، فلا ينفصل المعنى عن الذات والإيقاع. إنّها، والحالة هذه، تكون رهن علاقة تضمين متبادلة داخل الخطاب، ومتحوّلة عبره باستمرار.
وبما أننا ننظر إلى هذا النوع من الشعر داخل اشتغاله كخطاب لغويّ وتجربة جماليّة، فلا مندوحة من إدراك مركز الثّقل الذي يمثله الإيقاع، باعتباره يأخذ وضع الدال العضوي والجوهري بالمعنيين الفكري والجمالي. لكن ينبغي أن نميِّز بين العروض والإيقاع، فإذا كان العروض يُسعفنا في ضبط البنية الوزنية للبيت الشعري، فليس له ما يُقدّمه في تحليل إيقاع الخطاب باعتباره المجموع التركيبي لكلّ العناصر التي تُسهم فيه، والتي تتمظهر في كلّ مستويات اللغة الشعرية: العروضية، النّظمية والدلالية التي تُحدّد دالّ الإيقاع وطبيعة اشتغاله داخل القصيدة الغنائية. لذلك، لا يُعرَّف الإيقاع بوصفه وزنيّاً أو صوتيّاً أو نبريّاً فحسب، وإنّما يتعدّى ذلك إلى الخطاب بأكمله، حيث يمكن أن يستند إلى الأبعاد الدلالية للنّظْم بمفهومه البلاغي، تبعاً لـ»حركة المعنى» وفعاليّته في تنظيم الذات داخل خطابها، المفرد والمختلف. وهذا ما يجعلنا نعتقد أنّ الإيقاع دائماً ما كان يُشكّل مختبر المعاني والرؤى الجديدة التي لم تكفَّ الذّوات عن السعي لبلورتها والعمل عليها داخل تواريخ تفرُّدها الخاصّة. فالإيقاع ليس عنصراً شكليّاً أو مستوى أو حليةً أو مُضافاً، بل هو مبدأ بانٍ ودلاليّ يتشكّل عبر مسار إنتاج الغنائية لمعناها الذي يتجدد باستمرار، من عصر إلى آخر.
يُفيدنا مفهوم الخطاب، إذن، في التعرُّف على أشكال التجاوز التي كانت تحدث داخل مقتضيات النوع الغنائي وأنساقه العامة. ويسمح لنا هذا الشكل من التجاوز بمتابعة الغنائية باعتبارها شكـل حياة، وبرصد صيغ الثبات والتحوُّل الحادثة في البنيات أو غيرها. نكون، هنا، بصدد العبور من غنائيّةٍ إلى أخرى وفق استراتيجيّة الخطاب لدى هذا الشاعر أو ذاك، حيث لا يتمّ تحليل القصيدة إلا باعتبارها كاشفةً عن اشتغال المبدأ الأنواعي للغنائية، وعن اشتغال الدوالّ المهيمنة التي تتجلى قيمتها في مدى اختراق شعرية النوع وهي تنفتح على ممكنات كتابية جديدة.

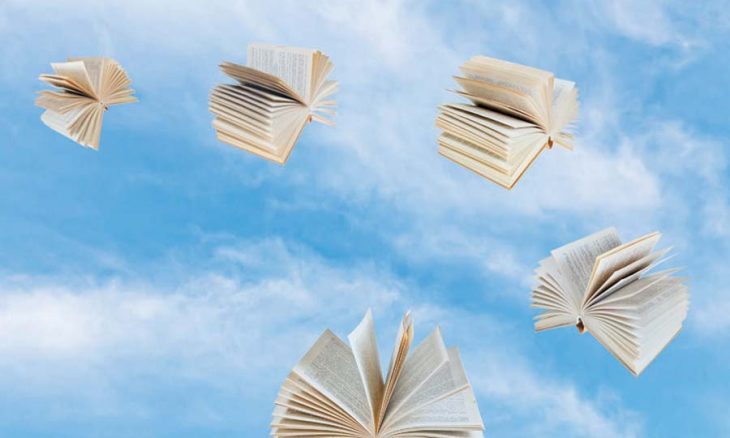
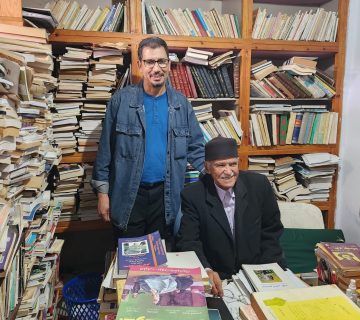
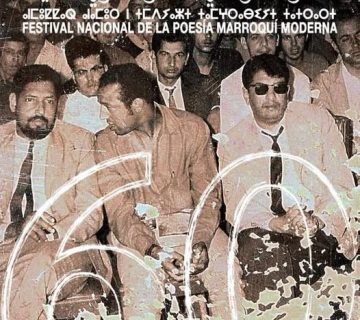

لا تعليق