حاوره: عبد الهادي روضي
س: هل لازال ندى الدفلى يسكرك فترقص وارثًا صمت الجهات؟
لقد ذكّرتَني بشذرةٍ من قصيدة كتبتُها، أوحاها إليّ خاطِرٌ من زمنٍ عصيٍّ في تجربتي داخل الكتابة. نعم، لا يزال هذا النّدى. يَعودني في أوّل الليل، وإذا تأخّر إلى الصباح نهضتُ مع حجيجٍ عابرين إلى الشّعر، حيث لا أحدٌ هناك إلّا آخري. أمّا الدّفْلى فإنّها ما فتئت تتلوّن بأصداء التراب، وتتراقص والريح على الأجناب، وليست من حيث هي كذلك. مشروع، لا وجود ولا عدم.
س: يقول أحد الشعراء المغاربة الثمانيين: (إن الكتابات التي توالتْ بعد الثمانينيات تفتقد لكثيرٍ من الخيال). إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الحكم منسجمًا مع تجربة الكتابة الجديدة الذي أنت أحد أسمائها؟. ثم ألا تعتبر مثل هذه الأحكام قاصر في رؤيته إذا ما أدركنا نصوصًا غير مفكر فيها تكتبها أسماء شعرية تحتمي بالهامش؟
مثل هذا الحكم هو حُكم قيمة، بلا شكّ. حكم متعسّف وظالم، يكشف أحد الوجوه السلبية في ثقافتنا التي يسودها عزف الكورال المنفرد، وتنتشر فيها آليات الإقصاء والنبذ المانعة لكلّ أصيل وجديد نشاز. هناك دائمًا رغبة في أن تبقى السُّلط المنتفعة على ميدانها، وتُبْقي على انسجامها الخاص مع ماضيها وخطابها. في أكثر من مناسبة، أكّدتُ أنّ التجربة الشعرية الجديدة في المغرب فجّرت جماليّات كتابية جديدة، وعكست فهمًا جديدًا لآليّات تدبُّر الكيان الشعري، ممّا يمكن للمهتم أن يتتبّعه ويتأمله في دواوين شعرائها، التي شرعت في الظهور منذ أواخر التسعينيّات، ونُشرت على نفقتهم الخاصة بسبب غياب الدعم والعماء الذي وُوجهوا به، أو في إطار سلسلة « الإصدار الأول » الذي أطلقته، على علّاته، وزارة الثقافة فيما بعد. وداخل سنوات التجربة هاته، نكتشف أنّ العلاقة التي كانت تحكم سابقًا المركز (الممثّل بالمحور: الدارالبيضاء ـ الرباط ـ فاس) بالهامش (الممثّل بأطراف كثيرة في الشمال والوسط والجنوب)، قد تلاشت فعلًا، بل صار الهامش مركزًا، وغدت حساسيّات الفعل الشعري تقدم إلينا من مدنٍ مثل وجدة وتطوان ومراكش وطاطا وآسفي وسواها. صرنا اليوم نتعرّف على شعراء مهمّين أنضجوا تجاربهم في الهامش وخارج بهرجة الأضواء التي يُناور بها الإعلام الحزبي والرسمي من حين إلى آخر.
س: هذا الحراك شعري الذي تشهده الهوامش مقابل تراجع المراكز التقليدية ممثلة في المؤسسات الثقافية الرسمية. ألا يمكن أن يمس هذا الحراك بالبعدين الفكري والجمالي للقصيدة الجديدة في المغرب؟
أجل، أن تقدم النصوص والتجارب من جغرافيّات بكر وجديدة، مشروطة بمتخيّلات ترفد حياتها وأشكال تعبيرها من الجبل والصحراء والبادية، لهو أمْرٌ من البلاغة بمكان أن يُنتبه إليه ويدرس. نعثر على هذا الشرط الجغرافي، بوضوح، في الشعر الغنائي بالأمازيغية والحسانية، واليوم صرنا نجد شيئًا من هذا في الشعر المكتوب بالفصحى، الآتي إلينا من هذه الهوامش والشّعاب المنذورة للعراء. الوعي بالمكان ضروريّ في بناء الشعر والشعرية، وكلّ إمكانات التجديد تتمّ من هنا وعبره. ولسنا في حاجة إلى التأكيد على أنّ مثل هذا الوعي يجعل أنساغ القصيدة تتأثّر بأبعاد المكان فكريًّا وجماليًّا، بشكل يؤثر، إلى حدٍّ ما، في المسألة الشعرية برمّتها. في هذا السياق، يجب أن نستحضر القولة المأثورة المضيئة عبر التاريخ، وفي زمن مُعولم وتجميعي كهذا، أنّ الشاعر ابن بيئته. لا أقلّ ولا أكثر.
س: بلا شكّ، تلاحظ مدى تنامي وتيرة الإصدارات الشعرية في المغرب. كيف تقرأ هذه الوتيرة؟ وإلى أي حد يمكنها أن تكون عامل إخصاب للقصيدة المغربية في سيرورتها؟
بلا شكّ، توالي الإصدارات الشعرية بهذه الوتيرة لافت للنظر، لكن السؤال عن قيمة الأعمال، وعن طبيعة إضافاتها، وعن الاتجاهات والحساسيات الشعرية التي تنتمي إليها، يظلّ مؤجلًّا إلى حين تداولها ومقاربتها، وذلك في غياب توزيعها وغياب تقاليد تقديم الأعمال الجديدة في الأماسي من لدن المؤسسات الثقافية ودور النشر والنقّاد. لكن ما أعرف أنّ أغلب دواوين الشعر أصدرها أصحابها على نفقاتهم الخاصّة التي يدفعونها لدور النشر، والأخيرة ما يهمّها هو الدّفع أكثر ما يهمّ إن كان هذا شعر أم لا، فمن النادر أن تجد داخل هذه الدور لجانًا لقراءة الشعر أو ما شابه ذلك. هذا أمرٌ حاصل للأسف، ويكاد يشكّل خطرًا على الشعر وقيمه الجمالية والإنسانية، إذ يبلبل أوضاع المشهد الشعري، ويميّع ما هو شعري، ويقدّمه في شكل لايليق به إلى جمهور القرّاء. هل نعود من جديد إلى قول ما قاله العقّاد: كلّما كثر الشعراء قلّ الشعر؟
لكن ما يجب أن نعترف به هو أنّ المغامرة الشعرية التي نحيا غمارها مهمّة ولافتة للنظر، وتمثّل عامل إخصاب للقصيدة المغربية في سيرورة تحديثها، وأن نعترف بأنّ حجيجًا من أفرادها قد عبر إيقاع التحوّلات وفكّر في ذاتيّته خارج الخطاطات المعروضة، إلّا أنَّها لم تسلم في بعضٍ من نصوصها من تشوُّهاتٍ في الخلقة والنموّ من جهة، وفي بعضها الآخر من التنميط عديم الموهبة والجهد الفني، فتشابهت تشابه الرمل من جهة ثانية، وذلك بسبب من أنّها كانت معرضة للإهمال والنسيان والصمت، وبسببٍ من أنّ النقد انصرف عنها إلى شعر الروّاد بأسلوب اطمأنّ إليه من المجاملة والمحاباة، وإذا التفت إليها ظلمها وصنّفها تحت هذه اليافطة أو تلك بنيّة النبذ.
س: هل القصيدة مازالت مطلوبة بالتعبير عن الجماعة والانخراط في تناقضاتها؟
دائمًا ما كانت القصيدة كخطابٍ شعريٍّ مخصوص، بالرغم من سمت الفردانية المتّشح به، في قلب الجماعة الإنسانية، مًعبّرة عن الجمعيّ وتناقضاته، وإلّا لما فهمنا لماذا يخشى السياسيُّون الشعر، ولا هذه العلاقة الحادّة التي كانت تتوتّر بين طرفي الشعر والسلطة بأنواعها. لكنّنا نلمس اليوم تغيُّرًا في معنى هذه العلاقة وترتيباتها، بعد أن انتقل توصيل الشعر وتلقّيه من الفضاء العمومي إلى الأمكنة المغلقة من مثل المقاهي الثقافيّة والنّوادي اللّيلية والمجالس الخاصّة والحميمة، متساوِقًا مع انحسار دور المجلات الأدبية الفاعلة، ومنابر النشر الحرة، وضمور محفّزات الجدل والمعارك الأدبية، فيما دخلت التّقنية على الخطّ بوسائط مغايرة. وطُرِح السّؤال ثانية: هل نشهد تراجعًا في دور الشعر، ومن ثمّ الشعراء؟ هل يعني الأمر انسحابهم من المتن الى الهامش، واستقالتهم من اختلاطات الحياة اليوميّة؟ وتساوق الأمر أيضًا مع أوهام الحداثة، ولاسيّما فيما يتعلّق بتصوّر الشّعر ووظيفته، حتّى بدا الادّعاء بأنّ الشّعر « كائن لا اجتماعي » مغريًا للكثير، حتّى بالنسبة للشعراء المنشغلين بـ »الموضات » الرّائجة. لا يمكن لنا، والحالة هذه، أن ننكر اجتماعيّة القصيدة حتى ولو امتلكت قدرًا ما من الاستقلالية والتفرّد، لأن كتابتها لا تتحقق إلاّ بعملية إدماج بين الشّخصي واللّا شخصي، بين الفردي والجمعي، وأنّ العلاقة بين رؤية الشاعر والوسط الاجتماعي ليست علاقة انعكاسٍ آليّ، كما يزعم كثيرون.
في الواقع، يمثّل الشعر، والفنون عمومًا، ذلك المرصد والمختبر الذي يُظْهر أكثر من أيّ ممارسة اجتماعيّة بأنّه داخله يتحقّق الذّاتي بقدرما يتحقّق الجمعيّ. بهذا المعنى، لا يمكن لنا أن نخوض في حداثة القصيدة، أنّى كانت، بمنأى عن الأخلاقيات والتاريخ، وذلك حتّى في استغراق اهتمامها بالذّاتي. إنّ كتابة القصيدة حتّى في الهامش تظهر سياسيّة أكثر من المتن، وفي نصّ العصيان أكثر من الـمُجْمع عليه.
س: قلت في ما مضى: إن الشعر صيرورة مفتوحة على المستقبل. ماهي ملامح هذه الصيرورة؟ وما هي هواجسها الشعرية والإنسانية؟
في هذه الأوقات العصيبة من ثقافتنا يتأكّد الدّور الطبيعي والطليعي للكتابة، الكتابة بما هي الحركة المستمرّة، الحيويّة أكثر التي تحملنا على التّفكير والحلـــــــــــم، وعلى الانتباه لجوهرنا وعمقنا الإنساني، والاهتمام بما حولنا من اختلاطات الحياة العابرة. لهذا، فكلّ كتابةٍ حقيقيّة وضروريّة هي تلك الّتي تتوجّه إلى المستقبل، خارج الأوهام الّتي تروّج لها « الموضات » وتُغري بها مرضى الاستسهال والتّسطيح. نعم، الشعر صيرورة مفتوحة على المستقبل، وهي ما تفتأ تغتذي على اللّانهائي في الإنسان والكون، وإلّا لما صمد كلّ هذا الوقت شعر طرفة والمتنبي والمعري وابن زيدون وجلال الدين الرومي وهوميروس ونوفاليس وشكسبير وسواهم.
س: هل قصيدة النثر هي الأرض الموعودة للشعراء على تعدّد حساسياتهم الجمالية؟
الشعر هو أرضهم الموعودة، وليست قصيدة النثر. لا يمكن أن يحلّ إمكان قصيدة النثر محلّ الشعر نفسه. أرض الشعر ليست أرضًا خلاءً، والأيادي التي احترثها كثيرة ونداءاتها متجاوبة منذ القديم. كلّ أشكال الشعر العربي لها الحقّ أن توجد على هذه الأرض، طالما أنّها تتدفّق في خير اللغة العربية وجمالها. لقد حلّ النقاش حول قصيدة النثر وتسميتها وشرعيّتها، وأكثره غير ذي شأن، محلّ الشعر نفسه؛ وأكثر ما نخشاه أن تتحوّل قصيدة النثر، وهي حقٌّ لا نريد به باطلًا، إلى مشجب يعلّق عليه الأدعياء وعديمو الموهبة ملابسهم الحقيقية، ويتخفّون بدلًا عنها وراء ثياب الإمبراطور.
س: بماذا تتحقق الشعرية انطلاقًا من تصوراتك النظرية والجمالية؟
الشعريّة نسبيّة ومتحوّلة. في كلّ الثقافات العريقة بما في ذلك الثقافة العربية لا نعثر على مفهوم وحيد ومحدّد للشعر والشاعر، وهو ما يجعل استحالة تعريف الشعر أمرًا مزمنًا ليس فقط بين هذه الثقافات، بل حتّى في الثقافة نفسها. وإذا عُدْنا إلى الشعرية العربية وجدنا أن مصادر الفعل الشعري كانت، دائمًا، محطّ سجالٍ بين الشعر والنقاد، وإن كانت المؤسسة تحاول أن تُخفي ذلك، وتُظهر إلى السطح ما ترغب فيه وتُقوّيه.
بالنسبة إلي، أعتقد أنّ الشعرية تتحقّق من كيمياء اللغة التي تُكتب بها، وعبر إيقاعها المحايث لأشكال تعبيرها المتنوّعة، من ذات إلى ذات، ومن نمط إلى آخر. هذا يتطلّب من الشاعر، إلى جانب موهبته، المعرفة بالشعر وتذوّقه والإصغاء إلى زمنه.
لا أثق في شاعرٍ يجهل بتراث أمّته الشعري العظيم، ولا يمتح إلّا نزرًا ضئيلًا من معجمها الغنيّ ومن خزين ثقافتها الثرّ، ولا يُحاوِر الآخر ينفتح عليه من منطلق ذلك. بعض الشعراء أُتيح لهم مثل هذا الاعتبار فقرّت أشعارهم في وجدان الناس وأحبُّوها، وبعضها الآخر تقرأ ما يكتبونه وكأنّه شعر مترجم لا روح فيه.
س: تخلص نصوصك الشعرية للرؤيا وللغة الشعريتين. ماهي المصادر التي تستقي منها تلك الرؤيا واللغة؟
الرؤيا، اللّغة، ثمّ الإيقاع. أنا أعتقد أنّ هذا الأقانيم الثلاثة بمثابة الضرورة بالنسبة إلى كتابتي الشعرية، فهي تحضر في كلّ نص من نصوص بدرجات مختلفة ومتقاطعة، وتتبادل الأدوار بمقتضى الخطاب وأجروميّة الذات. المصادر التي أستقي منها هذه الأقانيم متنوّعة، ولعلّ أهمّها المصدر التراثي الذي يُتيحه لي اطّلاعي الدائم على مدوّنة الشعر القديم، والمصدر الحداثي الذي استفدتُه من قراءاتي لتجارب الشعر الحديث العربي، وغير العربي مترجمًا أو في لغته الأصلية، ثمّ المصدر الذّاتي الذي تأتّى لي من معاناتي في أثناء سيرتي وتجربتي في الحياة وطبيعة علاقتي بمحيطي الشخصي والاجتماعي.
س: كيف تؤاخي بين ممارسة القصيدة والتنظير لها؟ وأيهما الأولى لديك؟
– أنا مُمارسٌ للشعر، وهو الأوّل والأَوْلى؛ لكن لا أدّعي أنّي مُنظِّر للشعر. التنظير للشعر يتطلّب خبرة كبيرة به وعملًا يتّجه بالنقد نحو إبستيمولوجيا الكتابة التي ترتبط، في تصوُّري، ببناء المفاهيم التي تكون نتاج تفاعل بين الممارسة ونظريّتها. لا زلت أعتبر نفسي دون ذلك، إلّا أنّ عملي على نقد الشعرية العربية وتأويل النصوص والتجارب الشعرية الجديدة مُهمّ في هذا الاتّجاه. من المعنى إلى الإيقاع.
يبدو لي اليوم أنّ أوَّل مسألة يمكن أن تُثار وتشكّل موضوع نقاش هو التساؤل عن وضعية كلّ خطاب حول الشعرية، وخاصة حول اللغة الشعرية، والبحث في الكتابة كفعاليّة لمعرفة نوعيّة تتم داخل العلاقة الضرورية مع الممارسة. ولهذا الاعتبار، أهمّ نقاد الشعر ومنظّريه هم الشعراء أنفسهم، الذي يعرفون أنّ الكتابة تذهب نحو ما لا تعرفه، نحو ما ليس لها، أي نحو مُمْكنها الذي تتنصّت عليه النظريّة.
س: فزت في السنوات الأخيرة بعدة جوائز عربية مهمة. ماذا قدمت لك تلك الجوائز؟ وهل الجائزة حافز للكاتب بالضرورة؟
-إ نّ أيّة جائزة رفيعة وجادّة مثل جائزة الشارقة للإبداع العربي، وجائزة ديوان الشعرية التي تمنحها مؤسسة شرق ـ غرب البرلينية، لا يمكن للظافر بها إلّا أن يسعد، ويُدرك أنّ زيت عزلته يضيء في أمكنة أخرى من العالم. لقد تأثّرت بشهادات المُحكّمين في الجائزتين، من مثل علي جعفر العلاق وعلوي الهاشمي وعبد الرضا علي وشوقي بزيع، ومنحتني ثقة أكبر بتجربتي في الكتابة كأيّ شابّ في بدايات مشروع حياته الكتابي. مثل هذه الجوائز تمثّل حافزًا للكتّاب على الإبداع والاستمرارية بلا شكّ، وذلك في غياب دعم المؤسسات الثقافية لمشاريعهم، وتردّي وضعهم الاعتباري، وتقهقر صورتهم الرمزية في المجتمعات العربية.
س: ماهي الطقوس التي تستدعيها لكتابة قصيدة أو نص ما؟
-لا طقوس بالمرّة. مَثَلي مثل الذي يحتمي بظلال ذاكرته وماء مخيّلته لا يحتاج إلى طقوس. عليك أن تتوقع مجيء السطر الأول للقصيدة في أيّة لحظة، ومن ثمّة أن ترعاه وتحميه من الاستسهال بجهدك، وترغب فيه بشهوتك، فإنّ الشهوة نِعْـم المعين. ولا لديّ أوهام للكتابة أيضًا. ما أحرص عليه هو واجب الإصغاء الذي يحفزني على تدبير عزلتي الكثيرة في غضون ذلك.
س: باختصار بماذا توحي لك الأسماء والعناوين التالية؟
عبد اللطيف الوراري:
هذا الذي يأخذ مكاني كلّ يوم، وينطق باُسمي، مع أنّي ما أفتأ ابتعد عنه في كلّ ولادةٍ جديدة، لأكون آخري.
الجديدة:
تلك الحكاية التي يرعى عزلتها البسطاء، بعد غروب كلِّ شمس. ولا أعرف إلى أين يتوجّهون بعد شروقها.
ترياق:
هو عنوان ديوانٍ لي اكتشفْتُ به عبورًا مختلفًا وأطرافًا من شهوة شعري، بعد الذي وجدتُه من سحاب كاذب، ومن نايٍ لم يرشدني إلّا إلى نفسي.
ناس الغيوان:
أعيد هذه الأيّام سماعهم، إنّهم سحرة وأجلّاء. من أصواتهم الجريحة والمسكونة بحجيج الحبّ والأمل يقدم صوتي البعيد. إنّه لأمر بالغ الأثر أن يظلّوا ناصعين في ذاكرة الشعب ووجدانه، برغم كلّ شيء.
عبد الله راجع:
هو شاعر، ومن حملة لوائنا إلى المستقبل.
إدريس الملياني:
هذا الشاعر المغربي.
القصيدة:
هي نداء الحياة باستمرار.
المرأة:
لا معنى لها خارج الحبّ، وخارج العطاء.
الطفولة:
مَنْ مِنّا يسْتَعيد تلك الكلمات،
ولا يَحِنُّ إلى ما أوْحَتْ لنا به
أيّام الفجر؟
ذلك ضَوْءٌ
نقرؤُه في باطنِ اليد
ولا نُصافحه،
من ساعة امتهان الحياة.
*جريدة (الزمان)، 24 مارس/ آذار2012. و(القدس العربي)، 15 ماي/ أيار 2012.

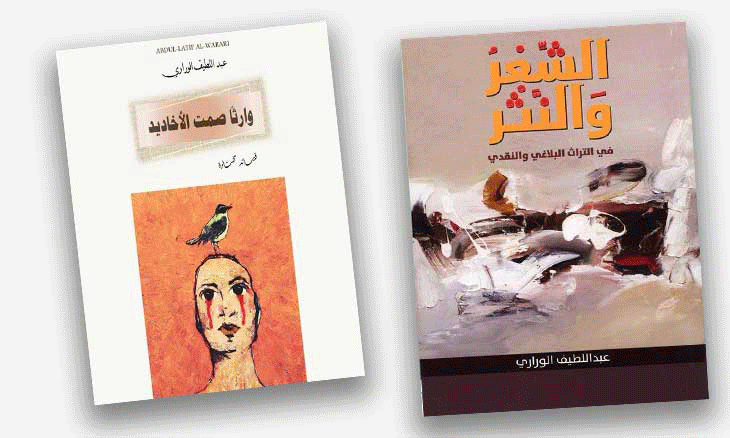



لا تعليق