يتزايد الوعي في وقتنا المعاصر بأهمية الترجمة؛ فهي تلعب دورا حيويا في التقريب والحوار بين الشعوب والأمم، والحفاظ على التنوع الثقافي الذي تزخر به، وتعبئة الإرادة السياسية لتحقيق التنمية والأمن والتفاهم عن طريق نشر التعليم والفنون والآداب. فإن تترجم العمل، سواء كان علميا أو أدبيا أو فنّيا، من لغة إلى لغة أخرى، فأنت تساهم في تعزيز ذلك الوعي وخلق المناخ الإيجابي الذي يوجد أسبابا حقيقية للتواصل الإنساني، إذ من دونها «سنعيش في مقاطعات محاطة بالصمت» على حد تعبير جورج شتاينر. ولهذا، توصف الترجمة بأنها جسر بما يدلّ عليه من معاني النقل والعبور والوصل بين ضفتين أو فضاءين متباعدين، ولكن من غير أن يسعى إلى توحيدهما أو دمج بعضهما في بعض؛ أي أنها تعزز الاختلاف والتعدد والغرابة، وليس المماثلة والتطابق. يقول عبد السلام بنعبد العالي: «إن الترجمة، شأن كل جسر، لا تقضي على الاختلاف، ولا تلغيه، وهي لا تصهر الطرفين في وحدة مطلقة، بل تربط أحدهما بالآخر».
ومن ناحية أخرى، تطرح الترجمة مشكلات معرفية ولسانية وتأويلية في علاقتها بالخطاب، وبالتالي كانت موضوع تفكير منذ القدماء؛ فالترجمة – حسب تعبير أمبرتو إيكو- هي قول «الشيء نفسه تقريبا»، وكلمة (تقريبا) تستثير عالما بكامله من الأسئلة والأسرار. فإن نترجم يعني أن نقف في مواجهة الآخر، وأن نواجه المختلف، وهو غالبا ما يكون الشرط المسبق الذي لا مفر منه لكل راغب في النفاذ إلى ثقافة كونية ومتعددة؛ ذلك أن الترجمة ليست مجرد وسيلة تواصل وحسب، بل هي مساءلة اللامُفكّر فيه من كل لغة، ومواجهة ما تحمله من ثراء والتباسات واختلافات وهي تنتقل من محك إلى آخر، ومن ضفة إلى أخرى. وقد ظلت قضايا الترجمة خلال العقود الأخيرة حديث الفلاسفة والمفكرين، ومناط اهتمام الدراسات الأكاديمية الترجمية، وظهرت أقسام متخصصة في درس الترجمة داخل الجامعات العربية، إلا أن ما نترجمه من اللغة العربية، أو إليها يبقى في مستوى أدنى. فالأدب العربي – مثلاً- لم يُترجم منه إلا النزر القليل، وسفراؤه الخُلّص صاروا مثل العملة النادرة في ظلّ الاستلاب الثقافي الذي يريد إخضاعه لمقاييس مركزية غربية منكفئة على ذاتها، عدا ما يُنقل عن العرب أنفسهم من كليشيهات مغرضة وصور بالغة الدونيّة. ولو عكف العرب على ترجمة أدبهم إلى اللغات العالمية، وعندهم أموال قارون، لأحبّهم العالم كله؛ فأيُّ زائر منا لمكتبة نوبل قد يتفاجأ، بل يُصدم، من فقر جناح الأدب العربي.
عبد اللطيف الوراري
تأويلية الترجمة
إن أي نقاش حول الترجمة ومشكلاتها في فضائنا العربي، الأكاديمي والمعرفي، يشكل في حد ذاته حدثا ثقافيا؛ مثل النقاش الذي شهدته كلية الآداب والعلوم الإنسانية في تطوان يومي الأربعاء والخميس 10 و11 مايو/أيار 2023، حيث احتضنت رحابها مؤتمرا علميّا في موضوع: «تأويلية الترجمة: المرجعيات والمنعطفات». يقول محمد الحيرش منسق مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية التابع للكلية نفسها، والجهة المنظمة لأشغال المؤتمر: «وقع اختيارنا على «تأويلية الترجمة» موضوعا لأشغال هذا المؤتمر، لكونه يتناسب مع طبيعة الانشغالات التي دأب مختبر التأويليات على تدارسها منذ تأسيسه قبل خمس سنوات، حيث ظل الاهتمام في جميع الندوات والمؤتمرات السابقة ينصب على محاور دراسية مرتبطة بالعلاقات الأفقية التي تقوم بين التأويليات وعدد من العلوم والمعارف المجاورة؛ ذلك لأن التحولات التي ما فتئت تشهدها التأويليات حتى وقتنا الراهن أخرجتها من حدودها التخصصية الضيقة التي كانت بها في الماضي مبحثا معياريا مستقلا، وارتقت بها إلى «مشترك فلسفي» تفيد من حوافزه جملةٌ من أنظار الفكر الكوني المعاصر واجتهاداته».
وافتتح المفكر عبد السلام بنعبد العالي (1945)، بعد كلمتي عميد الكلية مصطفى الغاشي ورئيس شعبة اللغة العربية أحمد هاشم الريسوني، أشغال المؤتمر الذي يكرمه احتفاء بعطاءاته الرائدة في الدراسات الترجمية المغربية والعربية، و»تقديرا لمنجزه الفلسفي الحافل وعرفانا بما أسداه للجامعة والفكر المغربيين»، وقال إن سبب اهتمامه بالترجمة يعود إلى أربعة عقود خلت، وتحولت عنده إلى قضية فلسفة؛ فهو اهتمّ بها كموضوع، شأن غيره من الفلاسفة، لأنها تزحزح الأسوار التي تفصل الدراسات بعضها عن بعض، خصوصا في علاقة الأدب بالفلسفة؛ حيث تتمّ زحزحة المفاهيم الكبرى التي تقوم عليها نظرية الأدب (الأصل، النسخة، السيمولاكر..)، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تقويض الميتافيزيقا. ومن هنا، لم يربط اهتمامه بالترجمة من باب مسائلها التقنية، بل اتخذها منفذا لممارسة الترجمة، على نحو يقود إلى نقض مفاهيم الميتافيزيقا في الأدب والفلسفة. وأكد أن الاهتمام بالترجمة ليس شيئا طارئا في ثقافتنا العربية، بل هو معهود. ورغم ما عرفته حركة الترجمة من نمو عند العرب القدماء، إلا أنهم كانوا ينظرون إلى الترجمة من طرف واحد، بل لم يكونوا يجيزون ترجمة الشعر فنهم الأرقى. ورجع إلى فلاسفة ألمانيا المحدثين، وهو يفكك معاني الترجمة ومدلولاتها الرمزية والثقافية، بما هي جسر وعبور واستنبات وتحويل وانتعاشة. لقد صارت الترجمة ـ في نظره – واقعنا المعيش، إذ لم تعد نقلا من لغة إلى لغة، بل صارت أسلوب تفكير وأسلوب حياة ونمط عيش: «أصبحنا نكتب كي نُترجم».
وفي ما يشبه تحية لفكره الاختلافي، يقول عبد الفتاح كيليطو (1945) عن المحتفى به: «يمكن أن نقول إنه، ومع استمرار ارتباطه طبعا بالتراث العربي، قفز بكلتا قدميه من الفارابي إلى هايدغر، فضمن لنفسه منذ ذلك الحين صوتا متفردا ومكانة متميزة في الساحة الفلسفية العربية»، ويلفت إلى أن لقاءه بالجمهور الأوروبي يتسم بالارتباك والفشل، لأن هذا الجمهور ينكفئ على مركزيته وليس له استعداد حقيقي لاستقبال الكلام في ثقافة يجهلها مثل الثقافة العربية، ولأن بنعبد العالي نفسه يخيّب أفق انتظارهم وهو يتحرك «بين بين» بين نقطتي حدود، وبين لغتين أو بلدين أو ثقافتين».
قضايا وإشكالات
توزعت جلسات المؤتمر إلى سبعة محاور أساسية، هي: الترجمة في المرجعيات الفلسفية، والترجمة بين المنعطف اللساني والمنعطف التأويلي، وتأويلية الترجمة: مقاربات وتصورات، وإبدال الترجمة وإبدال التأويل، والترجمة والنسبية اللغوية، وثقافة الترجمة وآدابها من منظور تأويلي، وأسئلة الترجمة في الفكر العربي. وهو ما يعكس تقاطع الموضوع مع مجالات معرفية متعددة، بعضها يتصل بالدراسات الفلسفية والهيرمينوطيقية، وبعضها الآخر يتعلق بالدراسات اللسانية والسيميائية والنصية، على نحو يؤكد تعقد إشكالات الترجمة التي تتجاوز مجهود فرع معرفي بعينه.
بخصوص إشكالية نقل المعنى وتأويل السياق، أو العلاقة بين النسخة والأصل: تساءل بناصر البعزاني: كيف ينقل المترجم المعنى وعينه على تمايز تصور نظام العالم بين لغتين، منقول منها ومنقول إليها؟ فالمترجم ـ في نظره- يتردد في اختيار الكلمات التي يظنها وفية للغرض حسب فهمه للنص الأصلي، بل إنه إذا قرأ النص نفسه في زمن آخر، قد تكون اختياراته للكلمات والعبارات مغايرة قليلا، أو كثيرا. وربما من كثرة الحرص على الوفاء للأصل يقع المترجم في هفوات تُخلّ بالأصل. ويزداد الأمر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالترجمة إلى لغة مُزوّدة بمقولة نحوية معينة انطلاقا من لغة لا تتوفر على هذه المقولة. ورغم هذه التعقيدات، فلا يجوز اعتبار الترجمة مستحيلة، لأن كل لغة مؤهلة مبدئيّاً لأن تعبر عن تجربة معرفية، عبر إضافة أقوال توضيحية، وإن كان نقل العلوم أهون من نقل المعتقد والشعر والأحاجي. يقول: «من يرى استحالة الترجمة لن يترجم أبدا، لأنه ينغلق في رؤية باطنية مؤدّاها، أنه لا تواصل صريح ولا نقل للأفكار ممكن بأمانة».
وعاد عبد اللطيف محفوظ إلى كتاب عبد السلام بنعبد العالي «في الترجمة»، وتوقف عند مضامينه التي تعتمد تدريجا مدروسا، ومحموله النظري الأساس الذي يتمثل في ربط علاقات بين التصورات التي أُنتجت حول الترجمة ومفعولها، وموضوعات فلسفة مساوقة؛ فالسؤال الرئيس الذي كان يشغل بال بنعبد العالي يتمثل في ماهية الترجمة وإمكانية تحققها أو استحالتها، انطلاقا من تصورات أهم الفلاسفة حول اللغة والتمثل والترجمة، من أفلاطون إلى جيل دولوز، مرورا بكانط وهيغل ونيتشه وبلانشو وهايدغر وبنيامين ودريدا ورولان بارت. وهو يكشف الخلفية الإبستيمولوجية المفترضة لتفسير العلاقة بين النموذج والأيقونة والسيمولاكر من منظور سيميائيات بورس، حاول محفوظ أن يقترب من المنطق الذي تحكم في توليف الكاتب بين تصورات مختلفة لفلاسفة ونقاد مختلفين، تراوحت بين: الترجمة تحويل للمعنى، والترجمة تأويل، والترجمة نقل لروح النص، والترجمة شرح تبسيط وإعادة بناء المعنى مع توضيحه، والترجمة أيقونة (بمعنى أنها صورة وفية ـ بقدر ما- للنموذج أو الأصل)، والترجمة سيمولاكر (أي إنها صورة مخادعة ومخاتلة للصورة النموذج أو الأصل)، والترجمة حياة جديدة للنص.
وبحث محمد الحيرش تأويلية الترجمة من منظور لسانيات الاختلاف، وذلك انطلاقا من الفكرة الشائعة حول الترجمة بأنها «نقل» لغة مصدر إلى لغة هدف بدرجة من «الدقة» و»الأمانة»، ولهذا ناقش حدود هذه الفكرة وكيف يُختزل فيها النقل إلى مجرد «أداة تقنية» تسعى إلى مغالبة الصعوبات اللسانية التي تثيرها العلاقة بين اللغات، والسيطرة على أسباب الاختلاف والتباعد القائمة بينها. وفي هذا السياق، ينشغل بسؤال الترجمة داخل مجالين معرفيين؛ أحدهما هو اللسانيات، والثاني هو التأويليات، باعتبارهما مجالين يتباينان في نظرتهما إلى المهمة التي تضطلع بها الترجمة وهي تزاول النقل من لغة إلى أخرى. من الإبدال النسقي إلى الإبدال السياقي، يخلص إلى «أن الترجمة لا تلغي الاختلاف بين النصوص المترجِمة والنصوص المترجمة، بل تعده حافزا من حوافز إمكان الترجمة وباعثا من بواعث استمرارها، ولذلك كان الوعي بالمسافة الفاصلة بين أفق المترجِم وأفق النص موضوع الترجمة وعيا بأبعاد زمنية ولغوية وثقافية واجتماعية يمتنع معها أن تتحقق الترجمة بما هي مماثلة أو ترادف، بل بما هي حوار بين نصين لكل منهما فرادته وسمات مغايرته للنصوص الأخرى وتميزه منها».
وناقش عبد الإله حجاج فائدة المقاربة التأويلية للترجمة بالنسبة للمترجم، وهو ما قاده إلى إبراز بعض الخصائص التي تميز التأويليات: الذاتية والإبداعية والجسدنة. ومن خلال الوعي بهذه الخصائص، يمكن للمترجم أن يفهم الكيفية التي يترجم بها النصوص من جهة، مثلما يمكنه من الأدوات التي يستعين بها لتبرير ترجمته من جهة أخرى، بل إن المقاربة ـ في نظره – توجه المترجم إلى اتخاذ النص، لا الكلمات والجمل، وحدة للترجمة، وذلك من منظور تأويلي، أي من نظرية ذرية للمعنى إلى نظرية شمولية.
وتناول مصطفى النحال «الترجمة المقيدة بالتفاوض»، وبحث أحمد الفرحان «المصطلح الفلسفي: من الترجمة الأمينة إلى الترجمة الموثوقة»، ووقف عزالدين الشنتوف عند «ممكن الترجمة في خطاب الشعرية»، وناقش حاتم أمزيل «رسالة في الترجمة: هيرمينوطيقا من قبل الهيرمينوطيقا»، وتطرق نبيل فازيو إلى «الترجمة أداة لمجاوزة الميتافيزيقيا أو عبد السلام بنعبد العالي وضيافة المترجم»، فيما تناول حمادي هباد في ورقته الطريفة «الجاحظ والكلام بلسانين»؛ أي أن الجاحظ خلص إلى أن استحالة ترجمة الشعر هي ذاتية، في حين أن استحالة ترجمة الحكمة هي موضوعية. وغيرها من المداخلات التي تقدم بها بقية المؤتمرين (محمد صلاح بوشتلة، مزوار الإدريسي، رشيد برهون، يوسف العماري، حسن كون، محمد الساهل، سعيد غردي، حمادي هباد، محمد البوبكري، السعيد لبيب، عبد الله بريمي، رشيد ابن السيد، عبد الرحيم رجراحي)، وأثارت عبر مختلف مقارباتهم وحقول تخصصهم نقاشا بين أوساط المهتمين والطلبة الباحثين، سيكون له ما بعده؛ فقد جُمعت هذه المداخلات وصدرت ضمن منشورات مختبر التأويليات، وبفضل رصانتها وعمق تناولها تتعزز الدراسات الترجمية المغربية والعربية بكتاب مرجعي دقيق في بابه، ومتميز في موضوعاته.


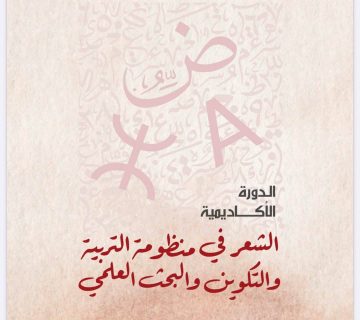
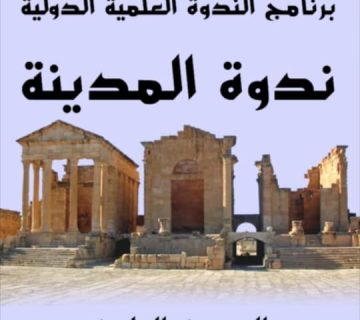
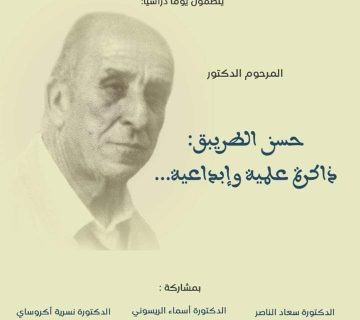
لا تعليق