هل لدينا دخول ثقافي؟ يكاد السؤال يُطرح بشكل دائم بعد الإجازات الصيفية، قياساً على الدخول المدرسي أو الجامعي أو السياسي أو الاجتماعي. يُجمع معظم الفاعلين في مجالنا العربي على أنه لا وجود لمثل هذا الدخول في حياتنا العربية، ويعود ذلك إلى ضعف أداء المؤسسة الثقافية وما في حسبانها، بسبب غياب استراتيجيات شاملة تستوعب عمليات التخطيط والدعم والمواكبة، وتتعدّى المركز إلى دائرة الجهوية الموسعة، مثلما يعود إلى إحباطات واقع «لا ثقافي» يتمثل في انقراض المكتبات وقاعات السينما ودور العرض الفني، التي أخذت تخلي مكانها لمحلات المأكولات السريعة؛ ما يجعل من المسألة الثقافية غير ذات أولوية في حياة الناس اليومية، وبالتالي يؤدي إلى تهميش المثقفين والكُتّاب وتراجع أدوارهم الحيوية المنوطة بهم لتمثيل القضايا الأساسية التي تتعلق بقيم المجتمع وهواجسه وتطلعاته، بل انحسار انخراطهم العضوي المأمول القيام به من أجل التوعية والتثقيف والتنوير والدعوة إلى التغيير. فإذا ما جرى الحديث عن «دخول ثقافي» وفي جملته «دخول أدبي» فلا يعدو أن يكون الأمر مجرد «زفّة» في شارع فارغ، لا تترك أثراً ذا جدوى. لكن الدخول الثقافي يبقى مع ذلك مطمحاً مشروعاً وحاجة حضارية تعكس عناصر قوة الثقافة وحركيّتها في عالم متحول، بله ضرورة وجودية.
سألت «القدس العربي» بعض الفاعلين: ما جدوى الدخول الثقافي؟ ما هي أبرز معيقات هذا الدخول في مجالنا العربي؟ إلى أيّ حد تتأثر صورة البلد وحركته الثقافية من غياب الدخول الثقافي، بل تتأثر حوافز الكاتب العربي للمساهمة أكثر في هذا الحركة والرقيّ بها؟
علي حسن الفواز (العراق): هيمنة السياسي على فاعلية الثقافي
يبدو أنّ مفهوم «الدخول الثقافي» سيكون مثيرا للجدل، ليس لطبيعته المفهومية، بل لعلاقته الإجرائية في ما يخصّ الاندماج والتعايش والتمثّل الثقافي، داخل الأنساق أو البني المسؤولة عن إنتاج المعرفة، بدءا من مؤسسات التعليم والفنون والعلوم، وليس انتهاء بالتعرّف على ما تمثله من قيمٍ للأفراد والمجتمع؛ إذ يتضمن الدخول الثقافي تمظهرات متعددة تخصّ سياقات عمل الوصول إلى تلك المؤسسات والاندماج فيها، على مستوى الوظائف، أو على مستوى دورها في الإنتاج الثقافي، وتأمين الفرص المتساوية لتحويل المجتمع المؤسسي إلى مجتمع معرفي تتيسر فيه آليات تداول المعارف والأفكار والقيم والاكتشافات الفنية والعلمية، كما في المعارض والمتاحف، وحتى في الجامعات ومراكز البحوث، ومراكز المعلومات والتمكين الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي، ومؤسسات الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
لكن أبرز معيقات هذا الدخول تكمن في الطابع النمطي للمؤسسات الثقافية العربية، وضعف التشريعات القانونية والحمائية للعمل المؤسسي الثقافي، فضلا عن غياب الإرادات السياسية التي تخشى من تأثير هيمنة السياسي على فاعلية الثقافي، وتحديد قدرته على إنتاج الخطابات، وعلى خلل دعم وإسناد البرامج والمشاريع التي تُعنى بالحقوق المدنية والحريات، فضلا عن أثره في تعويق تنشيط المعارف ودورها في صناعة الوعي المجتمعي والرأي العام، وغياب آليات ربط الإنتاج الثقافي بفاعليات التنمية الشاملة والأمن الثقافي، عدا الطابع اللوجستي لهذه المعيقات؛ مثل: المشكلات الاقتصادية العميقة، وغياب الدعم المالي لبرامج المؤسسات الثقافية، وبما يؤثر على غياب تفاعلها مع مؤسسات الإنتاج الثقافي، وسوء التخطيط ورثاثة التوزيع الجغرافي للخدمات الثقافية، ومحدودية أهلية برامج التوعية المجتمعية على مستوياتها المتعددة وفي مجالاتها المختلفة، حيث يمكن للدخول أن يلعب دورا في تنشيط صناعة المجال الثقافي والكائن الثقافي، مثل خدمات الرعاية الصحية، وخدمات الرياضة والنوادي الاجتماعية والثقافية، مع ضعف الأداء في العمل الإعلامي، وجهوده في تغطية النشاطات الثقافية، وصناعة جمهورها، وتشوّه دوره في تأمين منابر ومنصات تقوم على تقديم خدمات واسعة للمعلومات والبيانات والإحصائيات، وإدخالها في السياق التنموي والتعليمي الذي يخدم جمهورها المُستهدَف، بما فيه الجمهور الثقافي، الذي يضم صنّاع المعرفة من الكتّاب والأكاديميين والفاعلين الآخرين في مؤسسات إنتاج المعارف بتنوع اشتغالاتها وتعددها.
محمد جليد (المغرب)
الدخول الثقافي تقليد سنوي بمثابة فرصة لتجديد اللقاء بين الكتاب والقراء، وإعلان الأجندة الثقافية السنوية، والتعريف بجديد الإصدارات والمؤلفات والأعمال الأدبية والفكرية والفنية، والاحتفاء بالمتميز منها، وتشجيع كتابات النشء، إلخ. من هنا، فالدخول الثقافي هو مناسبة ترقى في بعض الدول الغربية، مثل فرنسا، إلى مستوى الحدث الوطني على الصعيد الثقافي، يضاهي أحداث الدخول الأخرى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والغاية منه تجديد العلاقة مع النتاجات الثقافية والإبداعية، مهما كان صنفها من جهة؛ وإطلاق الحركة الثقافية السنوية ببرمجة دورية أو سنوية واضحة من جهة ثانية.
في المغرب والعالم العربي، ثمة محاولات تسعى إلى أن تقتفي أثر الدول الأوروبية والأمريكية في هذا التقليد، لكنها ما تزال متعثرة، بالنظر إلى أن هذا التقليد السنوي أضحى حاجة اجتماعية ماسة في الغرب، في الوقت الذي ما يزال فيه الإبداع والفكر يمثلان ممارسة نخبوية محدودة موجهة إلى قارئ نخبوي بدوره. لم تتسع حتى الآن دائرة المقروئية حتى يتحول الدخول الثقافي إلى مناسبة ثابتة ومنتظمة، تصاحبها أنشطة محفزة، مثل الجوائز، ويساهم فيها جميع الفاعلين الثقافيين، من كتاب وناشرين وفنانين، إلخ. أضف إلى هذا أن الإعلام يعد ركيزة أساسية في ترسيخ هذا التقليد. هل الإعلام العربي، الذي بات الآن مهووسا بالنقرات واللايكات، قادر على أن يواكب مثل هذا الحدث، وأن يؤثر في توجهات الرأي العام، وأن يساهم في صناعة القارئ. ثمة عوامل كثيرة، بعضها ذاتي وبعضها موضوعي، من شأنها أن تساهم في أن تنتقل بهذا التقليد من مجرد الحدث الصوري إلى الحدث الفعلي المؤثر والفعال. ومن هذه العوامل حرص الحكومات على تثمين نتاجاتها من التراث اللامادي وبناء صورها الرمزية. ومنها أيضا الإيمان بقدرة الأدباء والمفكرين والفنانين على تغيير مسارات التاريخ، وتحقيق النهضة المرجوة، ومكافحة أسباب التخلف والأمية، إلخ. لكن هذا لا يعني أن نغفل دور الفاعلين المعنيين: دور النشر والمكتبات وقاعات السينما والفنون معنيّةٌ بدورها بالانخراط الملتزم في إنتاج حركية ثقافية والترويج لها، عبر الانفتاح أولا وأخيرا على وسائل الإعلام والمتلقي، والحرص على جودة الأعمال، وعلى تقديم منتوج راقٍ، لا الاكتفاء بتبرير ما يتلقونه من دعم مالي. والفنانون والمفكرون والأدباء أنفسهم مطالبون بالجدية والصرامة فيما ينتجونه من أعمال، بصرف النظر عن الإكراهات المادية والسياسية والاجتماعية، إلخ.
صبحي موسى (مصر): كساد العمل الثقافي
لا أعتقد أن بلداننا العربية تعرف ما تسميه أوروبا بـ«الدخول الثقافي» وبشكل أكثر دقة ليس لدى أي منها خطة أو برنامج ثقافي شامل للتعريف بالإصدارات الجديدة ومناقشتها، فهذا الأمر يتم لدينا بشكل عشوائي وباجتهادات فردية؛ فكل كاتب أو صاحب كتاب يقوم بالترويج لكتابه بشكل شخصي وفردي، عادة ما يدعو أصدقاءه لمناقشة هذا الكتاب في مكان ما، عملا بالمثل القائل: «إكرام الميت دفنه» والميت هنا هو الكتاب أو العمل الإبداعي، والدفن يحدث على نحو ما هو معروف بعد موت الشخص، حيث تتم دعوة مقرئ أو اثنين لإحياء ليلة وتعزية صاحب الكتاب أو أهل المرحوم. هكذا يتم الأمر مع الكتب، في غياب خطة من قبل دار النشر أو شركة التوزيع للترويج للكتاب، وفي غفلة تامة من الدولة وخططها الثقافية، وإذا ما كانت هناك خطة لشيء، فهي المناسبات الكرنفالية الكبرى مثل معارض الكتب، التي توضع على هامشها مجموعة من الندوات لجذب الجمهور، وفي النهاية ينتهي النشاط دون أثر له. كل هذا الموات أو التجاهل الثقافي للإبداع والمبدعين والمنتجين الثقافيين بشكل عام يعني موت الثقافة ذاتها، وغياب عملية التوزيع، ومن ثم موت تجارة الكتاب وخسارة كل من المبدع والناشر. وإذا كان الأخير يعوض خسارته بإلزام المبدع بتقديم مساهمة مالية في نشر كتابه، سواء عبر دفع التكاليف المالية، أو شراء نسخ من الناشر، فإن المبدع لا يعوض أي خسارة له، سواء في جمع المراجع أو الكتابة أو المراجعة والتصحيح، أو حتى المساهمة في الطباعة، ما يجعل المبدع لا يعول إلا على جائزة تعوض خسائره، أو تعلن حقيقة عن عمله، وهو ما خلق طبقة من صائدي الجوائز، وليس من المبدعين الحقيقيين، فأصبحت لدينا كتب ضعيفة يتم الترويج لها بحكم الجوائز، على حساب آلاف الأعمال والكتب الحقيقية والجادة. الدخول الثقافية فكرة راقية لا تعرفها بلداننا، حتى البلدان ذات الدخول العالية، التي تقيم عشرات المعارض وتدعو لها آلاف البشر، لكن الأمر مظهري بحت، ولا علاقة له بخطة ثقافية، ومن ثم تبدو هذه البلدان منتجة ثقافية أو داعمة لحركة ثقافية حقيقية، إلا أنها في نهاية الأمر لا تقدم سوى استعراض كرنفالي وليس فعلا حقيقيا. أتمنى أن تكون لدينا حكومات لديها أدنى درجة من الوعي بأهمية الفعل الثقافي، كي تتبنى خطط حقيقية لعمله.
فاطمة بن محمود (تونس): الحاجة لثورة ثقافية
يعني «الدخول الثقافي» رسم استراتيجية ثقافية تمتد على قرابة تسعة أشهر وتشمل كل مجالات الإبداع، فتُروّج للكتاب وتحتفي بالكاتب، من ذلك برمجة ندوات ومعارض ولقاءات، إلخ. وقد أصبح هذا الدخول طقسا احتفاليا يُنتصر فيه للمبدع، ويتوافق تماما مع خصوصية الاختيارات الثقافية لفرنسا تحديدا، ولأوروبا عامة، حيث تتم المراهنة على الثقافي الذي تعتبره أحد عناصر القوة. غير أن الدخول الثقافي ليس هو نفسه في كل البلدان العربية، فالأمر يظل استعراضيا وفق بعض المناسبات، مثل معارض الكتاب الدولية، ما يجعل من الاحتفاء بالكتاب موسميا وتقدير المبدع عرضيا.
يرتبط الدخول الثقافي عندنا في تونس بالعودة المدرسية بما تعنيه من مصاريف تثقل جيب الإنسان ـ المبدع وتزيد من ارتباكه، لذلك نجده يعيش ضغوطات الحياة اليومية المكلفة جدا. هذا ما يجعل من الدخول الثقافي في بلاد مثل تونس باهتا، ويكاد لا يلاحظ. وأعتقد أن ذلك يعود أساسا إلى مكانة الثقافة التي لا تبدو خيارا استراتيجيا، والدليل أن ميزانية وزارة الثقافة ضحلة جدا، حيث لا تتجاوز الصفر، فضلا عن البيروقراطية المقيتة وغياب البنية التحتية الضرورية، فأغلب المدن لا تحتوي على مسارح، ما يضطر بعض هيئات المهرجانات الصيفية أن تبرمج حفلاتها في فناء المعاهد الثانوية. لكل ذلك لا يمكن أن نتحدث عن الدخول الثقافي في بلاد عادت نسبة الأمية فيها إلى الارتفاع وأعداد المتسربين من التعليم في ازدياد، كما انخفضت نسبة المقروئية وارتفعت تكلفة الحياة وتاه فيها المبدع وهو يكتب تحت وطأة الحاجة وتنصّت الرقيب. وإن كان لزاما أن نتحدث عن الدخول الثقافي، أظن أنه لن يكون إلا بشكل محتشم وعفوي، لذلك أعتقد أن الثورة الحقيقية هي الثورة الثقافية ليس بالمعنى الأيديولوجي، وإنما بمعنى تثوير بنية النسق نفسه بإعادة ترتيب الأوراق وجعل الثقافة في أعلى اهتمامات السياسي، ويكون ذلك بتوفير الدعم المادي واللوجستي وتوفير كل الإمكانيات، ليتحول المبدع إلى سلطة قيمية والثقافة إلى عنصر تنموي تساهم في صنع إنسان سوي وشعب متحضر.
محمد ناصر الدين (لبنان): الإحباط في غياب الحافز
يُمثّل الدخول الأدبي في بلدان كثيرة، لاسيما فرنسا، كرنفالاَ أدبياً حقيقياً تتردد أصداؤه في القارات كافة، وفي العالم الفرنكفوني خاصة؛ وهو تظاهرة ثقافية تهمّ كل متابعي الأدب، لاسيما الرواية، إذ أنّ القضايا التي تعالجها الروايات الصادرة في كل موسم تشكّل بوصلة حقيقية للقضايا التي تشغل بال المجتمع الفرنسي والأوروبي، مثل قضايا الهوية والجندر والعولمة والمهاجرين، وتعبّر عن مزاج ثقافي في بلد لم يتوقف عن إنتاج الأفكار ومواجهة أزماته في مرآة ذاته والآخرين، ويجد في الأدب خير مثال لصقل هذه المرآة واستقبال ما ينعكس فيها من الضوء، حتى لو خفت عدد الفلاسفة في فرنسا مقارنة بحقبة الستينيات من القرن الماضي، وانخفض عدد الكتب الفكرية والفلسفية التي ما عادت تتصدر كتب موسم الدخول. الروايات التي تتصدر الدخول الأدبي لا تلبث أن تدخل في مسبار الجوائز الكبرى مثل الغونكور مثلاً أو حتى نوبل، وتثير نقاشات ثقافية جدية في بلد منتج للثقافة، في ديناميكية تشمل القيمين على هذه الثقافة والكتّاب ودور النشر، والمجلات النقدية المتخصصة، والأهم الجمهور الذي يستقبل هذا الموسم الأدبي بحفاوة ملحوظة. حبّذا لو نشهد تظاهرة ثقافية مماثلة في العالم العربي، وهو أمر تحول دونه معوقات كثيرة، أهمها الهوة الكبيرة بين المثقفين والكتاب، والجهات الحكومية الراعية للثقافة في بلدان عربية كثيرة، وعدم وجود مزاج ثقافي شعبي يتلقى هذا الإنتاج فيحتفي به ويرعاه، فمعروفٌ نوع الكتب التي تتصدر المبيعات في معارض الكتب العربية كافة، كأنما يُخيّر الكاتب بين الرمضاء والنار، بين سلطة تقمع وتصادر وتعاقب، وجمهور في الكثير من الأحيان يبحث عن وجبة سريعة لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً. غياب هذه التظاهرات قد يبعث على الإحباط في ظل غياب الحافز، ليظل الأدب الجديّ يحفر الجبل بالإبرة، ويفرض نفسه في فرادته من غير رعاية أو سياسة رسمية رشيدة، أو رؤى ثقافية نفتقد إليها في نشر الكتاب والاحتفاء به. سيظل الكاتب غريباً في المجتمعات العربية حتى إشعار آخر، حتى حضور الحرية والتنوير، ومواجهة مجتمعاتنا العربية لقضاياها الكبرى بجرأة دون خوف من الرقابة والظلامية والقمع وهيمنة السياسة على الثقافة. ربما علينا خوض كل هذه المعارك حتى نحتفي بموسم دخول أدبي عربي… حينئذ طوبى للغرباء.

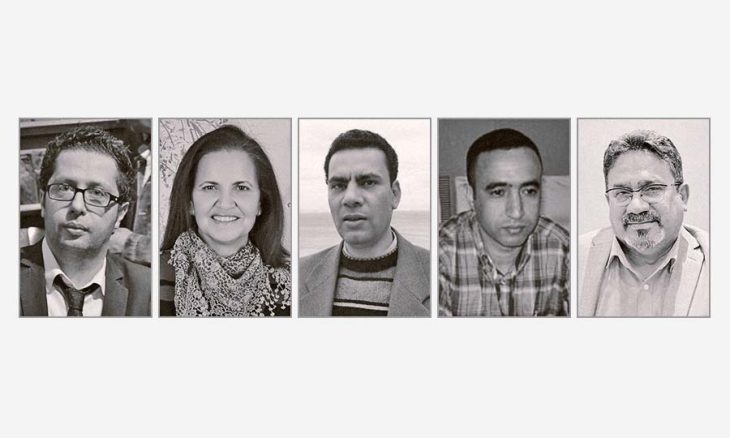

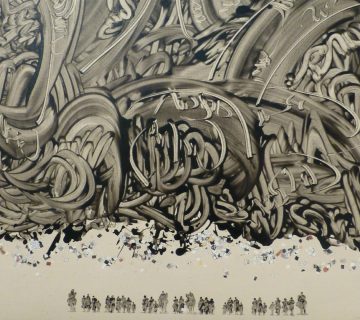

لا تعليق