عبد اللطيف الوراري
شهادة ميلاد الشاعر ولادته الطبيعية لا تكون بنصوصه الأولى والمتفرقة على سبيل «الهواية» أو تزجية الوقت والفراغ، بل بإصدار عمل شخصي واعٍ وجادّ بين دفّتي كتاب عليه اسمه وتاريخ ولادته الرمزية وسكنى بيته الثاني، ولاسيما في وقت يعد فيه مثل هذا العمل مغامرة فردية وحدثا ثقافيّا بمعنى من المعاني، إذا استحضرنا السياق التاريخي حيث صعوبة النشر وآليات المنتوج الثقافي وصورة الشاعر داخل المجتمع وعلاقته المتوترة ببنى السلطة والمؤسسة الرسمية.
بالفعل، تسبق مخاض الديوان الأول لحظات الترقب والانتشاء والخوف واللذة والألم والشعور الساذج بالعبقرية وتغيير العالم، وما إن يخرج بولادة طبيعية أو قيصرية حتى ينطلق إلى سوق التداول والقراءة والنقد، بما له وعليه، ثم إلى فضاء الحلم في عبور رمزي؛ إذا كان يليه ما يُبنى عليه في منطق الإبداع وسيرورة التحديث الذي لا يتوقف، بل ينشأ باستمرار: ثمة شعراء توقفوا وانقطعوا لسبب قاهر، لكن في المقابل شعراء جعلوا من ديوانهم الأول تحدّيا شخصيا لتجاوز أنفسهم وذواتهم المبدعة مع توالي إصداراتهم الشعرية، بما فيها من روح تخطٍّ وحصافة وإنجاز.
إلى فئة الشعراء الأولى توجّهت جريدة «القدس العربي» وسألتهم عن حكاية الديوان الأولى بما فيها من تهيُّب التجربة وتوقيعها الشخصي، والظروف الشاقة التي سبقت خروجه وأحاطت به حتى رأى النور، وتلقي النقاد، وأصوات المرحلة سياسيّا وأيديولوجيّا، وحماسة الشاعر في شبابه وتطلُّعه إلى التغيير.
أحمد بنميمون: تخطيطات حديثة في هندسة الفقر
كنت في مجموعتي الشعرية الأولى «تخطيطات حديثة في هندسة الفقر» (1974) منشغلا باللغة الشعرية أكثر من انشغالي بالإيقاع. ففي «تخطيطات حديثة في هندسة الفقر» تجد كتاباتي الشعرية تتوزع بين المنثورة والحرة، بل إن قصيدة التفعيلة انحصر حضورها في نماذج ليست بذات شأن. وأعتبر أن اجتهادي كان على مستوى القول الشعري عبر لغة تستبطن الذات، ما جعل ظهور المجموعة في ذلك التاريخ البعيد، حيث كان «على الجميع أن يدفع ضريبة الوعي بمن فيهم الشعراء» بتعبير الناقد عبد القادر الشاوي، صوتا رومانسيا يستمسك بالذات والوعي البورجوازي الصغير. وبهذا الاعتبار أقصيت مجموعتي الشعرية الأولى، وزادها حداثة سن صاحبها تأكيدا لحكم الإقصاء. فلم ينظر النقد الأيديولوجي إلى أي اعتبارات فنية، مما احتجت معه إلى نشر مسرحية شعرية سياسية محضة هي «نار تحت الجلد» ليخفف ناقد هو إدريس الناقوري الحكم في «المصطلح المشترك» إلى نوع من العفو عن شاعر خرج من شرنقته الرومانسية الذاتية إلى معانقة الصوت الجماعي والانغمار في العام، الذي كانت القصيدة السبعينية تحاول الخروج عنه ويستميت النقد الأيديولوجي في الدفاع عنه: فهذا كان نضالي الشعري، الذي تعرض لسوء فهم، وكان الشعراء وقتئذ يذهبون مع طبعهم إلى التعبير عن الذات، في حين يصر النقد الأيديولوجي، على اعتبار ذلك خيانة للعام، ساكتا عما يجب أن يخوض النقد الحقيقي فيه، رغم ما اتسم النقد البنيوي به من اعتبار النص بنية مغلقة لا علاقة لها بالتاريخ والمجتمع. وقد كانت محنتي استثنائية في وسط يغلي بالسياسي الذي كان تلاحقه عصا السلطة وهراوتها التي لكم فجرت من رؤوس وأخصت من انطلاقات، وأعادت توجيه أصحاب مواهب إلى غير ما كانوا يراهنون عليه من إنجازات فنية.
رشيد المومني: حينما يورق الجسد
كتبتُ أغلب القصائد المثبتة في مجموعتي الأولى «حينما يورق الجسد» (1973) وأنا لم أتجاوز بعد العشرين من عمري، غير أنني وبفعل حالات انفعالية هي مزيج من اعتداد البداية، ومكابدات قد تكون سابقة لأوانها، كنت أشعر خلال كتابتها بغير قليل من الإرهاق، كما لو أنني بصدد إنجاز استحالاتي المؤجلة، التي كنت أحلم بها منذ أوائل حّبْوي على مفازات القول. وأنت تعلم أن أقسى ما يمكن أن يعانيه الشاعر، هو إجباره تلقائيا، وبتأثير من نداءات داخلية غامضة وعميقة، على اقتراف عنف وجمالية الكتابة الشعرية في مرحلة جد مبكرة من حياته، حيث تأخذ الحروف على مستوى القراءة والكتابة، شكل كائنات حية تراوح في حضورها بين الظهور والاختفاء، شكل أشباه ذوات، أشباه ملائكة، وأشباه غيلان زرقاء في ليالي مدينة فاس القديمة، كائنات ملتبسة، تدمن اختلاءها بذاكرة الطفل، باستيهاماته، بتخيلاته وأحلامه، كي تتحول في نهاية المطاف، إلى ما يشبه القصائد، أو بلغة أخرى ما يشبه قولا آخر غير القول. على مشارف هذا المسار المؤطر بخصوصيته، كتبت هذه المجموعة، وخاصة حينما حظيتُ بإمكانية التطواف في عواصم الكون، فور وصولي السن القانونية، التي سمحت لي بالحصول على جواز سفري، حيث تحققت لي متعةُ إسقاط أحوالي الغامضة، المحفوفة بأصداء تراتيل ونصوص عربية وغربية، على حداثة مرئي، وحداثةِ معيشٍ لم تلبث دماؤه الساخنة أن تدفقت في أمشاج أبجديةٍ، كانت مسكونة بالتوجه إلى مستقبلها، ومنتبهة إلى مأزق الوقوع في شرك أحوال شعرية، لغاتٍ، وسجالات، لم أكن شخصيا معنيا بها، سواء في بداية السبعينيات، أو بعدها. كانت تبدو لي غريبة جدا عن دمي، وتقليدية جدا، على الرغم من الطابع السجالي الذي كانت تسعى إلى التمظهر به. وربما بسبب ذلك كان، من الطبيعي أن تُهاجَمَ المجموعة بشراسة فور صدورها، لا لشيء إلا لكونها خارج التأطيرات التقييمية، والتنظيرية المكرسة، سواء من قبل سلفيّي الكتابة الشعرية، أو من قبل المتحمسين لحداثة قاصرة جدا. حيث كان الأمر يتجاوز بؤس الامتثال لأيٍّ من الطرفين، إلى البحث عن سؤال كتابة، تصغي إلى إيقاعات جسد الكائن، وليس إلى ذاكرة ممعنة في سكونيّتها وتسلطها.
مبارك وساط: على دَرَج المياه العميقة
صدرتْ مجموعتي الشعرية الأولى، «على دَرَج المياه العميقة» سنة 1990 عن دار توبقال. ولم تضمَّ تلك المجموعة كلّ ما كنتُ قد نشرتُ من نصوص قبل ظهورها، لسبب بسيط ومثير: فحين لزم أن أسارع بموافاة الناشر بنصوص المجموعة، كانت تلك النصوص متناثرة في مجلات وأوراق وقصاصات جرائد بشكل فوضوي، إذ لم أجمعها في إضبارة أو كرّاسة، كما أنّي، مثل أبناء جيلي، لم أكن أعرف بعد الحاسوب عن قُرب، بل إنّ ضرورة الإسراع في جمع النصوص فرضتْ عليّ نفسها في وقت كنتُ فيه بصدد الانتقال من بيت إلى بيت، وكانت كتبي وأوراقي «مدفونة» في كراتين عديدة، محكمة الحَزْم بحبال لا بأس بمتانتها، وكنتُ قد أودعتها في تلك الكراتين كيفما اتّفق.. المهمّ أنّي في لحظة مُعيّنة، اكتفيتُ بما كان قد تحصّل لديّ من قصائد، وقد طُبِعتْ المجموعة في وقت قصير جدّا لاقتراب موعد انعقاد معرض الدار البيضاء للكتاب، فلمْ تُعرضْ عليّ، حينَ شُرع في طبعها، في صيغة أولية تجريبية لأراجعها، ولم يكن أمر مثل هذا بالسّهولة التي أصبح عليها الآن، في زمن الحاسوب والإنترنت، لكني سأقوم بعملية المراجعة فيما يخصّ الطبعة الثانية لـ«على دَرَج المياه العميقة» التي صدرت عن «منشورات عكاظ» سنة 2001، كما أني حذفتُ منها، في هذه الطبعة» قصيدة بدا لي حذفها غيرَ باعث على الأسف (بالنسبة إليّ على أي حال). في هذه الطبعة الثانية ظهرتْ «على دَرَج المياه العميقة» في كتاب شِعْرِيٍّ واحد مع مجموعتين أخريين: «محفوفا بأرخبيلات…» و«راية الهواء».
محمد بوجبيري: عاريا… أحضنك أيها الطين
كانت لحظة استثنائية، كما هو الحال عند كل مبدع، ورغم ما صاحبها من حبور كان ثمة خوف من خوض المغامرة، ولولا تشجيع الشاعر عبد الله راجع وأصدقاء آخرين لما أقدمت على نشر مجموعتي الشعرية الأولى «عاريا… أحضنك أيها الطين» في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، خصوصا وأن النشر لم يكن ميسرا كما هو اليوم. يضاف إلى ذلك، وأنت في البداية، أن تعول على نفسك، وأن تطبع على نفقتك. كان الطبع باهظ الثمن، ولا مفر من اللجوء إلى قرض من البنك. هذا القرض الذي لم يكن هيّنا، كما هو اليوم، بحيث يمكن الحصول على مبلغ مالي محترم في فترة وجيزة جدا. لأخذ ذلك القرض تطلب الأمر عدة وثائق، وبعد إنجاز الملف كان علي أن أقابل المسير أو المشرف على تلك المؤسسة البنكية في مركز المدينة (لم تكن آنذاك بنوك في هوامش المركز والأحياء الشعبية كما هو الآن). تفحص الملف، ثم سألني عن الهدف من القرض. لما أخبرته عن السبب، لم يستطع أن يخفي استغرابه، لأن ملامح وجهه عبرت عن ذلك، كما أنه لم يستطع أن يكتم ابتسامة عريضة عقب عليها بقوله، إنه أول مرة يستقبل زبونا يطلب قرضا من أجل طبع كتاب، ثم أضاف: هل هذا استثمار؟
بعد أن عبر عن تعاطفه معي، وأنا آنذاك شاب طموح، أخبرني بأن قرار القرض النهائي يبت فيه البنك المركزي لتلك المؤسسة البنكية الفرعية، وأن الوقت قد يطول بسبب الملفات الكثيرة التي يبث فيها القسم المكلف بالقروض، أما بالنسبة إليه فقد أعطى الموافقة، بناء على ما قُدم في الملف من الوثائق المطلوبة.
بعد شهر حصلت على المبلغ المالي المطلوب مني لدار النشر، وهو 11 ألف درهم. الديوان، كما هو معروف، قدم له الشاعر عبد راجع تشجيعا منه، ولشعراء آخرين كانوا آنذاك في بداياتهم الأولى. كل ذلك التعب، أثناء الطبع والتصحيح لعدة مرات، تبخر لما أمسكت بالنسخة الأولى بين يديَّ. هذه الخطوة شجعت آخرين على المغامرة وإصدار مجاميعهم الشعرية والقصصية على حسابهم الشخصي، بدل انتظار الذي قد يأتي وقد لا يأتي. أسرني كذلك احتفاء أصدقائي الشعراء والكتاب بهذه الديوان من خلال كتاباتهم في الجرائد والمجلات، بالإضافة إلى عدة حوارات ودعوات لقراءات شعرية في مختلف المدن المغربية (الدار البيضاء، الرباط، سلا، الجديدة، شفشاون..) .
نور الدين الزويتني: القربان والملكة
هناك أمر تنبغي الإشارة إليه، أولا، وهو أن ديوان «القربان والملكة» (2007) لا يضمُّ أيا من القصائد التي كتبتها في الثمانينيات، قصائد ذلك الديوان كتبت كلها في التسعينيات. أما جميع ما كتبته في الثمانينيات ويمثل مجموعة ضخمة، فما زال حبيس درج من أدراج مكتبي بما في ذلك قصائد الفترة العمودية. والسبب هو السبب نفسه الذي جعلني أتأخر كذلك في إصدار «الملكة والقربان»؛ ذلك أنّ هاجسا آخر كان يتنازعني في تلك المرحلة هو الهاجس الأكاديمي أي انشغالي كباحث في الجامعة، وقد كنت أستطيع التغلُّب على ذلك لو كان هذا الهاجس الأكاديمي منسجما جدا مع الهاجس الإبداعي مثلما هو الحال مع باحثين آخرين مثل الشاعر محمد بنيس مثلا، إلا أن الأمر بالنسبة لي كان يتعلّق بالاشتغال في إطار لغة أخرى وتخصص آخر هو الدراسات الإنكليزية، واهتمام آخر آنذاك هو حقل الرواية والنقد الروائي الإنكليزيين (كانت أطروحتى الجامعية الأساسية عن «عوليس» لجيمس جويس وعن الرواية الجديدة). أضف إلى ذلك اهتمامي بالدراسات الثقافية. وقد كاد هذا الجانب يعصف بي كشاعر، وهو ما حدث بالفعل لبضع سنوات، لولا صحبتي الجميلة في فترة رائعة للكاتب محمد الشركي الذي حثّني بشكل مباشر وغير مباشر على العودة إلى الشعر، فاعتبرت ذلك بمثابة نداء جهير لآلهة الشعر من خلال هذا الكاتب الرؤياوي جدا. الاشتغال الأكاديمي أيضا في تلك الفترة أدخلني في دوائر علاقات بعيدة عن زملائي الشعراء وعن اللقاءات والتظاهرات الشعرية.
ثريا ماجدولين: أوراق الرماد
ديوان «أوراق الرماد» المنشور سنة 1993 يضم قصائد عقد كامل.. القصائد التي كتبت في هذه الفترة كانت موسومة بصوت الوطن الجريح.. مليئة بالقلق.. تمثل ذاكرة الرماد المتبقي من مرحلة السبعينيات الحارقة أو بداية الثمانينيات، لكنه رماد يحيل على طائر الفينيق، حيث الشاعر يحترق ويترمد وينبت من وجعه في تكوّن أبدي ليكتب. وراء كل قصيدة كانت هناك حكاية ما.. وأول نص نشرته على صفحات جريدة «المحرر» كان عن محمد كرينة، ثم كتبت عن سعيدة المنبهي وعن عمر بنجلون.. وعن انتظاراتنا لمغرب حقوق الإنسان ومغرب العدالة الاجتماعية. طبعا لم تكن هناك حدود فاصلة بين ما هو ذاتي وما هو سياسي، فكل حكاية من حكايا الوطن كنت أكتوي بنارها قبل أن أنهمر على الورق في شكل قصيدة..
أحمد هاشم الريسوني: الجبل الأخضر
جاء صدور ديواني «الجبل الأخضر» (1997) موازاة مع بداية العمل في الوظيفة العمومية بصفتي أستاذا جامعيّا، ولربّما هذه الصفة (أستاذ جامعي) هي التي منحتني حماسة إصدار «الجبل الأخضر»؛ ذلك أنني كنت قبل هذا عازفا عن إصدار ديوان.. كنت أعيش الشعر وجوديّا في الحياة اليومية إلى درجة البوهيمية، أو إلى درجة الموبقة، كما يحلو لمحمد الصباغ أن يقول.. كنت عصرئذ قد صرت أكتب الشعر لأكثر من عشرين عاما، وأعيشه يوميّا، وأنشر بالملاحق والمجلات الثقافية، وكلّما طُلب منّي طبع ديوان إلا وفررت نحو أعماق ذاتي.. وكأنّني أحمي القصيدة من دفنها بين دفّتيْ كتاب.. وهنا أستحضر تجربتي مع نشر الشعر، وأتذكر يوم كنت رئيسا لفترتين متواليتين لجمعية الإمام الأصيلي الشامخة أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث تمّ خلالها ولأول مرة في تاريخ الجمعية ولم يتكرّر هذا لاحقا، طبع ديوانين لتجربتين استثنائيتين في تاريخ الشعر المعاصر في المغرب وهما؛ ديوان الشاعر المرحوم كريم حوماري «تقاسيم على آلة الجنون» ثم ديوان الشاعرة الفذة ابتسام أشروي «لعبة الظل».. ولم ألتفت إلى طبع ديواني حتى جاءت سنة 1997 وكانت أول أجرة لي بصفتي أستاذا جامعيا أن طبعت بها ديوان «الجبل الأخضر».. كم هو جميلٌ وطفوليٌّ أن أتذكّر الراتب الأول الذي تكفل وأتاح لي طبع ديواني الأول!
محمد عرش: أحوال الطقس الآتية
عملي الشعري الأول «أحوال الطقس الآتية» الصادر بين سنتي 1987 و1988، لم ير النور إلا بعد مشاق، فقد اقترضت مبلغا ماليا من أحد البنوك لطبعه، وأنا أستاذ التعليم الثانوي في مدينة ورزازات. هذا العمل يغلب عليه طابع التسرع، ومحاولة الخروج من القوقعة إلى الفضاء، ويغلب عليه الطابع السياسي الأيديولوجي؛ إنه نسخة لما كان يمور في الساحة الطلابية. فنحن جيل تأثر بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وقد طالنا الحظر والمنع أيام أم الوزارات.

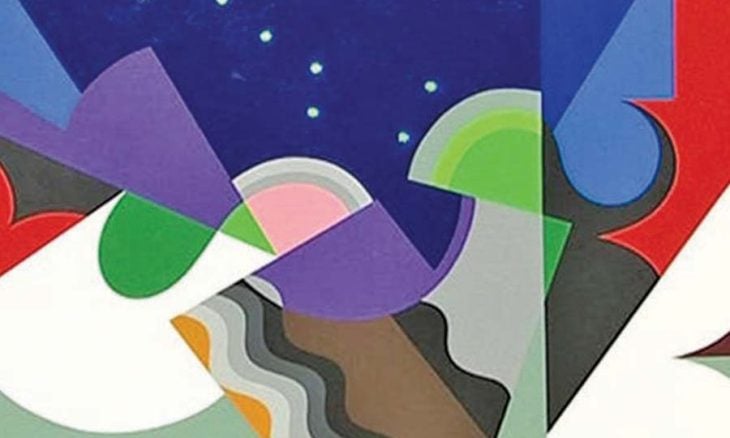

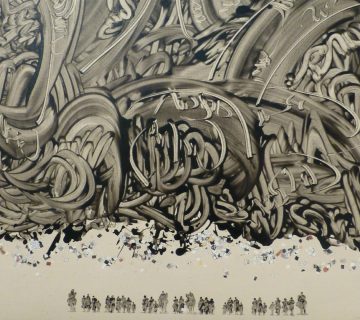

لا تعليق