عبد اللطيف الوراري
لا يُذْكر جيل الستينيات الشعري بالمغرب، إلا اقْتُرِن جاء اسم أحمد المجاطي (1936- 1995) في طليعته وغُرّة ناصيته. صنع هذا الشاعر مع ثُلّة من مُجايليه الموهوبين « مجد » القصيدة الحديثة، وكانوا في معظمهم من أبناء الطبقة المتوسطة وحُداة تطلّعاتها وآلامها، جمع بينهم هاجس التجديد الشعري، والتقوا في تشكيل متونهم النصية على هذه المُحدّدات الأساسية: استيحاء التراث الشعري، والانفتاح على المرجع الرومانسي، والانتقال من الشكل العمودي إلى البناء التفعيلي، والتأثُّر بشعراء الحداثة في الشرق والغرب. وقد توزّعت موضوعات شعرهم بين الحلم الرومانسي والموضوع الواقعي بمرجعيه الثوري والوجودي في سياق أطروحة الالتزام بالواقع السياسي والنضال اليومي، والتعبير عن مأساة الذات وهمومها الوطنية والقومية (القضية الفلسطينية)، واعتبار الشعر ضرورة للتغيير في الواقع. وفي هذا السياق، لا يمكن أن نفصل مواقف شعراء الجيل ضمن توجّهاتهم الأيديولوجية، عن الوضعية التي كان يمرّ بها الشعر العربي الحديث في هذه الحقبة، وهو ما يُنبّهنا إليه إحسان عباس في « اتجاهات الشعر العربي المعاصر »، عندما وجد أن مفهوم الشعر كان يقوم على أساس الالتزام الذي يقود نحو معنى الثورة وتنبيه الوعي من أجا « إنسانية الإنسان »، وهو جعل هذا الشعر يغلب عليه الوضوح في لغته وصوره ورموزه. ولهذا، كان التطوّر الشكلي والجمالي لقصيدة الجيل الستّيني يتأثر، إذا شئنا القوب، بـ »الإيديولوجيا العلمانية » التي كانت تنقل حصيلة الشاعر الثقافية ووعيه بالعصر وموقفه الأيديولوجي الحاد من الواقع السياسي والاجتماعي.
شاعر الدُّوار الوجودي
يقف أحمد المجاطي في طليعة رموز القصيدة المغربية الحديثة، وإليه يعود الفضل، ضمن آخرين قلائل، في تثمين حداثتها وترسيخ مجالات تداولها في فضاء النقاش الثقافي، لكنّهُ لم يكتب عنها نَقْدًا، ولا عن تجربته الشعرية نفسها، بقدر ما ٱنشغل بنقد الشعر العربي الحديث في توجُّهاته الكبرى، أو نقد أزمة حداثته كما في أطروحتيه الأكاديميتين: « ظاهرة الشعر الحر في الأدب العربي الحديث1947- 1967″ (1971)، و »أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث » (1992). نشر نصوصه الأولى من طبيعة عمودية- رومانسية في (دعوة الحق) منذ الخمسينيات، لكن قصائده التي نشرها في مجموعة من الصحف والمجلات المغربية منذ بدايات الستينيّات إلى متصف السبعينيّات (1962- 1977)، هي التي تُمثّل ذروة الشعر الحديث بالمغرب في مجمل خصائصها الفنية لغةً وإيقاعًا وبناءً ورؤيةً (نصاعة العبارة وتماسكها، استيحاء التراث، الأداء بالصور، بلاغة الأضداد أو الجمع بين المتناقضات للتكنية عن حالة أو موقف، التفضئة، التدوير، المزج بين البحور..). غير أن هذه القصائد لم تُجمع بين دفّتي ديوان يتيم إلا في عام 1987، تحت عنوان « الفروسية » بديلًا عن عنوانه الأصلي « خمارة » الذي استبعد لأسباب أيديولوجية، عن منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، ونال عنه جائزة ابن زيدون التي كان يمنحها المعهد الإسباني العربي بمدريد عام 1985، ثم جائزة المغرب للآداب في عام 1988. وكتب الناقد السوري محيي الدين صبحي في دراسته الملحقة بالديوان: « لقد ظفر الشعر العربي الحديث من ديوان المجاطي بحلقة جديدة في السلسلة الذهبية التي شكلها جيل الرواد في الخمسينات، فبعد السياب والبياتي وخليل حاوي يتبوأ الشاعر أحمد المجاطي مكانته بين رواد الشعر الحديث الذين طوروا الأداء واللغة الشعريين بالعربية. أما بالنسبة لشعراء المغرب العربي في السبعينات والثمانينات، بين القاهرة والجزائر، فهو رأس الطليعة التي تستحق لقب شاعر ».

تُمثّل القصائد؛ مثل « حين عاد المرجفون » و »كبوة الريح » و »دار لقمان عام 1965″ و »القدس » والسقوط » و »سبتة »، ٱنعكاسًا لما كان يمور في الواقع المغربي والعربي، وهو يحلم بتغييره وبقدرة الشعر عليه بقدر ما يعاني أشكال الحزن والاغتراب والشعور بالقلق واليأس من صمت الشعراء وخذلانهم ومن ضياع الأوطان، صادرًا عن « وعي مأساوي » لأنا مأزوم ومفتون بعذاباته، سقط في رؤيا الاستقالة الجماعية حاملًا أوزار الماضي ورموزه. فمنذ أواسط السبعينيّات، اعتزل أحمد المجاطي كتابة الشعر ويئس مما يأتي منه، بل دخل في « عزلة قاسية » كما يصف أحمد اليبوري، من ركونه كثيراً إلى الصمت الذي يحمل معنى الترفع عن دنيا مليئة بالأوهام وأنواع التراضي والمساومات الرخيصة. وبعد سنين عددًا، أشرقت كلمةٌ كانت تكبر في وجدانه، وتعقد محجًّا لتطهير الذات ومصالحتها مع العالم، عابرًا أزمنة الرماد والدُّوار الوجودي و »بلقنة القضية »، كأنها تجسيد سيرذاتي لفجيعة مشروع لم يكتمل: « وأنا أُراوِدُ كلَّ شاردةٍ
لأَسكنَ
في حِماها،
وأطوفُ سَبْعًا
حولَ دانِيةِ القُطوفِ
تمطُّ ألسنُها الحروفُ
بِمَا تَشابَهَ
من صَهيلِ مَلاحِمِ التَّأسِيسِ
حيثُ الرُّؤْيةُ
اكْتَملتْ
وحَصْحَصتِ البَدائِلُ
في مَداها
وأنا أُراوِدُ
كلَّ آبدةٍ
أُطوِّفُ ما أطوفُ،
فيا صليلَ ملاحِمِ
التَّفتِيشِ
في زَمَنِ التَّفاعيلِ
المُدوَّرةِ
استَفِقْ
واخلعْ نِعالَكَ
قَبْلَ
أن تَلِجَ البُحورُ السَّبعُ
دائرةَ الكُسوفْ ».
في ذكرى رحيله الثلاثين، نستعيد اسم أحمد المجاطي وملامح من تجربته الشعرية مع بعض النقاد الذي واكبوها وكتبوا عنها.
« قُدْس » أحمد المجّاطي: نجيب العوفي
كان الشعراء المغاربة في مقدمة هؤلاء الشعراء الذين عزفوا على وتر القدس وقبسوا من نارها ونورها منذ نكبة فلسطين 1948 وهزيمة يونيو 1967 إلى طوفان الأقصى الذي جعل القدس شعاره ودِثاره وتكبيرته وتعويذته. ويُعدّ الشاعر الكبير أحمد المجاطي في الطبقة الأولى من هؤلاء الشعراء المغاربة، ومن الرّواد الذين تفاعلوا مع القدس شعريا والتحموا بها إبداعيا، وذلك من خلال قصيدته الرائعة الرائدة (القدس)، إلى جانب قصيدته التاريخية الباذخة (أكزوديس في الدار البيضاء)، التي رصد فيها بزخم شعري وإيقاع درامي هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل. وقصيدة (القدس) كان قد كتبها عقب هزيمة 1967، حيث اكتمل حِداد القدس وأطبق عليها ليل الأسر الصهيوني. وهي واحدة من روائع وجِياد قصائد أحمد المجاطي. وقصائده برمّتها، كما هو معلوم، رائعة وجيدة، لأنها صادرة عن شاعر كبير ومتمرّس، تخْرُج الكلمة من سويدائه بعد امتلاء واصطِلاء، فتنفذ كالطلقة من الأذن إلى الوجدان، بلا استئذان.
وخلافًا لكثير من الشعراء الذين غنّوا للقدس بصوت جهير أو كسير رثاء وبكاء، أو غضبا ساطعا وهجاء، فإن المجاطي تعامل مع القدس بطريقة إبداعية خالصة وخاصة، رهيفة وشفيفة. لقد جعلها بعبارة، موضوعا شعريا وهمّا لغويا وأدبيا بامتياز. ومن هنا خلود وصمود هذه القصيدة الاستثنائية الرائعة. يقول الشاعر في فاتحة هذه القصيدة: « رأيتكِ تدفنين الريح/ تحت عرائش العتمة/ وتلتحفين صمتكِ/ خلف أعمدة الشبابيك/ تصُبّين القُبور وتشربين/ فتظمأ الأحقاب/ ويظمأ كل ما عتّقتِ/ من سُحُبٍ ومن أكواب/ ظمئنا والرّدى فيك/ فأين نموت يا عمّة؟ ».
تصير القدس هنا، عبر حروف المجاطي وكلماته الشجيّة البهيّة وبوحه الغنائي الحميم، أيْقونة شعرية تكثّف فجيعتها وغربتها ويُتْمها في محيط عربي وغربي ُمتواطئ على الإثم والعدوان. تصير مُتعة شعرية وإبداعية، إلى جانب كونها هاجسا نضاليا وإنسانيا، يهمّ كل المدن المقرورة والمأسورة في هذا العالم. تصير القدس في جذبة استعارية، عمّة تصبّ القبور وتشرب، وتظمأ على مرّ الأحقاب. ويصير الشاعر طفلا يشرب معها ويظمأ، ويتساءل بالتياع ولهفة وعلى امتداد القصيدة كلازمة – غُصّة: فأين نموت يا عمّة؟
وإذا كانت القدس نار قِرَى شعرية، تشخص إليها الأبصار، ومتاعا رمزيا مشاعا بين الشعراء العرب، فإن القدس التي نقرأها هنا، هي قدس المجاطي تحديدا وتخصيصا تحمل بَصْمته ونبرته وحُرقته.. لقد أنشأ قُدّاسا شعريا للقدس بلا جلبة أو هُتافية، وبلُحُونٍ وشجُون هي أقرب ما تكون إلى تراتيل القُدّاس وصلواته. فسلاما على روح الشاعر أحمد المجاطي. وسلاما على العمّة/ الغُمّة الجليلة الأسيرة، القدس. سلاما عليها حتى مطلع الفجر.
الشاعر المُقلّ: محمد بودويك
كان أول عهدي بمعرفة أستاذي أحمد، سؤالي له داخل المدرج الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس العام 1974، عن رأيه كشاعر فيمن تميل كفته الشعرية، ويسمق جماليا ولغويا ورياديا: هل هو السياب أم البياتي، أم أدونيس، أم درويش؟ إذ أن دواوينهم الشعرية كانت تملأ نقاشيا الرحب والساحات الجامعية والمدرجات… لم ينبس ببنت شفة. أبقى الجواب طيّ الصدر والحشا، ونصحني بمتابعة الدرس الجامعي الذي كان يدور حول شعرية السياب من خلال عمله: (شناشيل ابنة الجلبي). لكن لما انتهى الدرس، وخرجنا، تبعته، من دون أن أفكر في إزعاجه، وملحا في السؤال. ولست أدري لِمَ طرحته أصلا إذ غابت عني ـ الآن ـ أسباب ودواعي طرحه آنئذِ: هل قرأت لهؤلاء. وكم من عمل شعري قرأت لهم؟ وما انطباعاتك أنت الأول؟ باغتني سؤاله. اصطكت له ركبتاي، وأخذتني رعدة وهزة أخرجتني من تعالمي وصفاقتي. لم أحر جوابا. طمأنني أنهم شعراء، ولكل وجهته، وطريقته، وشأوه الشعري. بعد يومين، أحضر لي ديوان: (نهايات الشمال الإفريقي) للشاعر سعدي يوسف، ونصحني بان أكب عليه قارئا، مستقرئا، ومستغورا، ووالجا إلى أعماقه، ودهاليزه، وأفضيته.
لم أكن قد قرأت سعدي يوسف بعد، وقد يكون دس أحمد لديوان سعدي في يدي، ووضعني أمام امتحان جديد، آيةً وبرهانا على مكانة سعدي الشعرية في نفس أستاذي الشاعر. هكذا خمنت، وأصبت. فبعد أشهر، وكان المجاطي يغيب لأسباب شخصية وعائلية حيث يمخضه القطار مخضا، وحافلة » الستيام » ذهابا وإيابا من فاس إلى الدار البيضاء، رَجَّني، وأنا في بيته البعيد/ القريب من محطة القطار، بمعية أنور المرتجي، وعبد الهادي خيرات، وعبد الله البوشتاوي، وأستاذ الرشديات الراحل العلوي، رجّني بسؤاله لي عما أفدته وحصدته من قراءتي لسعدي يوسف، وماذا رأيت فيه؟ قلت بسرعة، وكأنني كنت منتظرا السؤال: حصدت الجديد والجميل والمختلف. غمرني بنظرة حنو ومحبة شعريين، ثم طلب مني نصا شعريا كتبته، إذ أخبرته في سياق آخر، وفي مناسبة أخرى، بأنني « أقترف » جريرة الكتابة الشعرية، وأن بعض نصوصي أذيعت، قرأها الشاعر الراحل إدريس الجائي، والمذيعة فريدة النور. أدهشني معرفته بذلك لأنه كان، وهو الشاعر الكبير، أحرص على القراءة والإنصات لما يكتبه الشعراء اليافعون القادمون إلى المشهد الشعري الصعب، وهم زغب الحواصل بحاجة إلى ماء ومرعى، ورعاية، ويد ممدودة. وما هي حتى دسست في حافظته الجلدية نصا شعريا لي، وأنا وجل مرتجف أخاف حُكْمًا يُرِديني. فرحت فرحة ما بعدها فرحة، وأنا أرى ذات يوم من العام 1975، نصي الشعري منشورا على الصفحة الأولى، والعنوان بالبنط العريض، بالملحق الثقافي لجريدة « المحرر » الغراء. كان النص يحمل عنوان: (فاتحة القهر في كتاب الدخول)، وقد ضمه ديواني الشعري الأول: ( جراح دلمون).
لا يذكر المجاطي، ويرد اسمه في الندوات أو في المحافل الثقافية والإبداعية التي تقام هنا وهناك، إلا تساوى الخلق في مدحه، وإكبار تجربته الشعرية، وعدها بادئة وماهدة للحداثة الحق. ولسانا إبداعيا واعيا بما سطر صاحبه من آي الجمال الشعري، مع أنه كان مقلا لم يخلف إلا عملا شعريا واحدا أسماه (الفروسية)، خفيفا في العنوان ثقيلا في عيار الشعر والميزان. فهل للإقلال يدٌ في النبوغ؟ هل للشرارة النارية التي سكنته مثلما سكنت أنداده وخلانه الشعراء الأفذاذ مثل: رامبو، وتراكل، وطرفة بن العبد، وأبو تمام، وجبران، والشابي، تمثيلا، دمغة قدسية في ما أنجز وأوجز، وطوَّع حتى اعتبر محككا، عبدا للشعر، حوليا. واعتبر مدبج القصيدة الشعرية الأولى في تقديري على الأقل. أيْ ذات الملمح المغربي، والسمت العربي، والقاع الأمازيغي والإفريقي، والهوية المحلية المركبة في اتصال عضوي واندغام معرفي بالشعر العربي الذي هبَّ قشيبا بهواء جديد، وماء نمير، خمسينيا وستينيا من الشام والعراق ومصر والأمريكتين.
محاورة الأسلاف: صالح لبريني
أعود إلى الشاعر أحمد المجاطي باعتباره أجلّ ثمرة حديثة للشعر المغربي الحديث، وأعمق تجربة يمكن مجاورتها والحفر في أراضيها الشعرية، للكشف عمّا تزخر به من غنى في التجربة وأصالة في رؤياها الممتدة خيوطها ما بين القصيدة المفعمة بروائح الأسلاف وظلالهم. والنص الشعري المفتوح على آفاق رحبة لكتابة تتأسس من التجربة في الحياة والإبداع، خصوصا وأن الشاعر يسترفد وجوده الشعري من الحوار الذي نسجه قراءة ودراسة مع الإبداع العربي بتجلياته العمودية والتفعيلية والنثرية؛ الأمر الذي صقل رؤيته الشعرية وأيقظ لاوعيه الشعري المثقل بالأصوات والظلال، المتخفّف من وهج الصنعة البديعية. فجاءت تجربته الشعرية جانوسية الهوية، أي تستمد أحقيتها الشعرية من الموروث والموجود الإبداعيّ المعاصر، فأبدع نصّا شعريّا لا يتخلى عن جذوره الأولى وظلالها الممتدة، ولا يفرّط في حداثة شعرية دون إلمام وإدراك من أعطالها وأعطابها. بعبارة أخرى، إن أحمد المجاطي لم يكن مفرطاً في حداثته ولا مسرفا في التشبث بالماضي على أساس أنّه المنتهى، بل عدّه طاقة مجدّدة لدم القصيدة التفعيلية وروحها ووجودها. بدون هذه الهوية لا يمكن الحديث عن الاستمرارية، ما دامت القطيعة وَهْمًا من أوهام بعض شعراء الحداثة المتطرفين. وهذا الحكم لا ينطلق من فراغ، وإنما من مبدأ جوهري في سيرورة الإبداع وصيرورته، إذ لا يمكن أن يكون للحديث وجود دون قديم كان جديدا في عصره. لذا فالمجاطي صنع وجوده الشعري من ذاته وتجربته في الحياة والكتابة، ومن الغوص في متاهات القصيدة بما تحمله من شرارة تقدح في الذاكرة، وتغدو على البياض احتراقا ومكابدة. ولعل في كلمته الصغيرة عنوانا والرحبة دلاليّا وجماليّا، ما يجعلنا نقرّ بأن القصيدة المغربية المعاصرة توهجت وامتدت أغصان شجرتها الإبداعية، بفضل هذا الشاعر المقلّ نصوصًا والكثير وجودًا وشعرًا في الذاكرة الشعرية. وهنا مكمن جدارة تجربته وقدرتها على التجدّد بتجدّد آليات القراءة النقدية. يقول:
« الكلمة الصغيره/ تُقال/ أو تُخطّ / فوق الماء/ تمشي بها الرياح/ وتبثّها الرّمال/ في الصحراء/ تولد/ أو تكون/ أو تصوغها/ مصادفات الصّخب/ والضوضاء/ الكلمة الصغيره/ يسكبها الصباح/ أو تهمي بها/ الظهيره/ ما بالُها تكبر/ في الهواء/ تحجب وجه الشمس؟ / تُلْقي ظلّها؟/ تغمرني/ بالرّجع والأصداء؟/ ما بالُها؟/ مملكتي مملكة الصمت/ اخسأوا/ أمقتها كلمة/ قيلت لغير المدح/ والهجاء ».

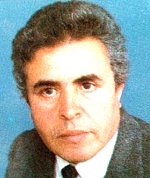
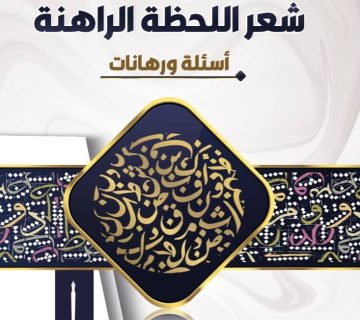
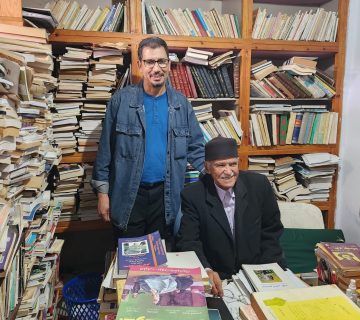

لا تعليق