مراتب الرؤيا:
فاطمة الميموني تقارب « جماليّات القصيدة المغربية المعاصرة »
عبد اللطيف الوراري
في كتابها « جماليات القصيدة المغربية المعاصرة » (مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، فاس 2024)، تقدم الشاعرة والباحثة المغربية فاطمة الميموني قراءات في أعمال الشعراء: محمد السرغيني، وعبد الكريم الطبال، ومحمد الميموني، وأحمد الطريبق أحمد، ومليكة العاصمي، ومحمد بنيس، ومحمد الشيخي وأمينة المريني، من منظور جمالي نصّي. وبما أنّ هؤلاء الشعراء ينتسبون إلى أجيال ورؤى مختلفة داخل المشهد الشعري المغربي، وأنّ لكل شاعر(ة) خصوصيّته التي تمليها عليه تجربته الشعرية من حيث الشكل والبناء ومصادر الكتابة التي يرفدها (رومانسية، صوفية، حديثة..)، فقد تنوعت مداخل المقاربة الجمالية وعناصرها في اجتراح أدوات تحليلها النصي، من متن شعري إلى آخر، أو بالأحرى من سياق إلى آخر ضمن سيرورة تحديث القصيدة المغربية.
أشعار أولى مؤسسة
لا يخفى على الدارس المتتبع ما للأشعار الأولى من قيمة خاصة بالنسبة إلى تجربة الشاعر ككل، لأنها بمثابة اللبنة الأساسية التي تقيم مشروع هذه التجربة وتضيء أبعاده المضمرة. وإذا كان بعض الشعراء، بمن فيهم الروّاد، قد تنكروا لمثل هذه البواكير ولم يدرجوا ضمن أعمالهم الكاملة؛ بسبب ما فيها من تعثُّر الخطوة الأولى وتقليد أصوات السابقين على نحوٍ ما، فإنّ بعضهم الآخر حرص على العودة إليها وتدوينها، مثلما صنع الشاعر محمد السرغيني. فمن المعلوم أن هذا الشاعر؛ وهو أحد أهمّ شعراء الجيل الستيني، قد تقدم به الزمن إلى عام 1987؛ حين أصدر ديوانه الأول: « ويكون إحراق أسمائه الآتية ». لكنه عاد إلى قصائده التي نشرها منذ أربعينيات القرن الماضي في بعض المجلات والصحف الوطنية وقتذاك، مثل: الأنيس، و »كتامة، والمعتمد والأنوار، وأدرجها في الجزء الأول من أعماله الكاملة ضمن مجموعتين شعريتين: « ما قبل الأشعار الأولى » و »الأشعار الأولى »، مع ما في هذه التسمية من تعبير كنائي عن بدايات التجربة قبل أن يتقوّم عودها وتعثر على صوتها الخاص والمختلف.
تعود الباحثة إلى هذه الأشعار الأولى التي كُتبت في الأربعينيات، وتجد أنها تعبر – تحت تأثير تلك الحقبة ونزوعها الجمالي- عن روح رومانسية تعنى بتصوير حالات وأحاسيس ذاتية بقدر تصوير قلق الذات وحزنها وتوقها الكبير إلى الحرية، داخل السمات الجمالية التي ميزت القصيدة الرومانسية (توظيف لغة سهلة، التعبير عن ذات الشاعر وتشخيصها، توظيف الخيال والطبيعة الانزياح عن الإيقاع التقليدي مثل تنويع القوافي وتعدد الروي والتقفية الداخلي..)، مع ما في هذه القصائد من رغبة لـ »تجاوز القيم الشعرية التقليدية ». وقد تبلورت هذه الرغبة حين أخذ الشاعر يغترف من الموروث الإنساني، قديمه وحديثه، عربيه وغربيه،على نحو وسّع أفقه الشعري « من حيث جغرافيا النصوص، وتعدد الدلالات، وثراء المرجعيات الدينية والفلسفية والفنية والرمزية والثقافية من أدب وتاريخ وتصوف وثقافة شعبية.. »، ما منح القارئ أفقا دلاليا منفتحا ومتشعبا من جهة، وأدى إلى تشكيل رؤية إبداعية شعرية جديدة من جهة أخرى، ليس بالنسبة إلى الشاعر نفسه، بل كذلك الشعر المغربي الذي كان يتلمس طريق حداثته وقتئذ.
كما تعود الباحثة إلى « رومانسية » عبد الكريم الطبال، التي أضاءت قصائده الأولى في مطلع خمسينيات القرن الماضي، ثم تلوّنتْ يأبعاد رمزية وصوفية، قياسًا إلى الموضوعات التي نهضت للتعبير عنها، من ذاتية ووجدانية ووطنية، ما يفصح عن رؤيا أصيلة نابعة من القيم النبيلة والجديدة التي عبرت عنها الحركة الشعرية الحديثة في دفاعها عن الحرية، والفردية، والوجدان، والخيال. وهكذا بقيت تجربة الشاعر عبد الكريم الطبال في سياق التي عبرتها التحولات، ومن إخلاصها لقيم الشعر الحديث، « تقوم على تصوير العمق الإنساني الصادق، وعلى ثقافة جامعة، وتأمل حكيم في الإنسان والكون والحياة ». كما بقيت قصائده الأولى شاهدةً على تحول القصيدة المغربية وانزياحها على مستوى المعمار الخارجي، واللغة، والصورة الشعرية، والإيقاع الشعري، والرؤية الشعرية. فقد كان من الشعراء الأوائل الذين ساهموا في تأسيس تجربة الشعر الحر بالمغرب إلى جانب مجايليه من شعراء الستينيات (محمد السرغيني، أحمد المجاطي، محمد الميموني، مصطفى المعداوي، وغيرهم)، وواكبوا تحولاته وانعطافاته التالية، من خلال منجز شعري يعبر عن تراكم نوعي قبل أن يكون تراكما كمّيا، لغزارة ما كتبه الشاعر بدءا من ديوانه الأول « الطريق إلى الإنسان » الذي صدر سنة 1971. وخلال هذه التجربة الشعرية الغنية والمديدة، كان « الشاعر – كما تقول- يعقد مع ذاته، ومع العالم، ومع الشعر، رهانا كبيرا، يسعى من خلاله إلى تطويع اللغة الشعرية، لتصبح قادرة على التلون بنكهات الحياة، واليومي، والتفاصيل التي تلتقطها عينه، أو يحس بها، او يحلم بها، مهما دقت أو عظمت، فكل شيء في هذه الحياة يصبح صورة، ومرآة ، سؤالا وجوديا لأنه يقتفي أثر الإنسان ، وينظر إليه بعين تشبعت بالجمال ، وجالت في الزمان، فتسربلت أشعاره بالحكمة ، والمعرفة، وامتدت تجربته الشعرية منسوجة في بحر الواقع، مرتمية في حياض التصوف ».
على ضفاف الرؤيا والحلم
لا يُذكر هذان الشاعران إلا اقترن اسمهما باسم شاعر أساسي داخل « بانثيون » الجيل الستيني؛ يتعلق الأمر بالشاعر محمد الميموني. ساهم بدوره في تأسيس القصيدة الحديثة بالمغرب، وأطلق ديوانه الأول « آخر أعوام العقم » (1974)، شرارة مشروعه الشعري حتى « بداية ما لا ينتهي » (2017)؛ سنة رحيله. رغم إخفاقات الحقبة التي عاشها، كان شاعرًا حالمًا يؤمن بالتفاؤل وبجدوى الحياة، على نحو ما تستقرئه الناقدة فاطمة الميموني من عناوين مجاميعه الشعرية التي تؤكد البعد الرؤيوي. ومن خلال عنوان ديوان « موشحات حزن متفائل » (2008) وبعض نصوصه، تفكك إواليات هذا البعد ضمن استراتيجيات الكتابة التي ينهجها وما تحمله على استنفار قدرات القارئ التأويلية، حيث تدفعه إلى التشبث بالأمل والتفاؤل وإلى سد فراغات الحيرة. وتمتدّ هذه الدلالة العامة، التي تؤشر على رؤيوية قصيدة الشاعر محمد الميموني ونزوعها الحالم، إلى أطراف الجسد الشعري للديوان، سواء تعلق الأمر بالمعجم المهيمن، أو بالدلالات الجزئية المبثوثة في القصائد. من التوحد بين الذات الشاعرة والآخر/الإنسان على مستوى الفعل والإحساس والرغبة في التغيير، إلى تبني صوت الرفض والتبشير بمعانٍ جديدة كفيلة ببعث الحياة في الوجود، تتأسس لغة الحلم في شعر محمد الميموني، وتتسم « برحابة الزمن الذي يمتد فتمتد معه زاوية الرؤية بعيدا، تنفتح على زمن كوني يطل عليه الشاعر من شرفة زمنه الخاص، المنجذب نحو الحياة، نحو الحلم ».
بالنسبة إلى أحمد الطريبق أحمد، أحد شعراء الجيل السبعيني، تركز الباحثة على بعض السمات المهيمنة في شعره، والمتمثلة في الاحتفاء بالمكان، من خلال تصوير الرحلات التي قادته إلى بعض البلاد، بما في ذلك مصر التي خصّها بديوانه « اهبطوا مصر.. سلاما سلاما » (2006) على نحوٍ يوازيه اعتماد لغة حكائية تعبر عن افتتان الشاعر بالمكان القاهري واستحضاره أسماء ذات دلالات رمزية في التاريخ العربي، متآلفا مع الأفضية التي ينزلها ويلتقطها بروح مشبعة بالتفاصيل الدقيقة، التي لا ترتبط بحياة الشاعر الخاصة وحسب، بل بتاريخ الأمة العربية، على نحو يغذي فضاء القصيدة بالسؤال الوجودي. فارتباط الشاعر بالمكان يتعدى كونه ارتباطا نفسيا ووجدانيا، ليكون ارتباطا وجوديا، لا سيما في علاقته بالمدن العريقة التي نشأ فيها أو تأثر بها أثناء مقامه فيها، مثل طنجة وفاس وتطوان. يتحول المكان هنا إلى دفتر تاريخ شخصي يسجل فيه الشاعر ذكرياته، بل يتقاطع مع تاريخ الجماعة، مما ينقل المكان إلى قضيّةٍ حين يصف الحاضر ويصف إحساسه بالاغتراب الموجع في هذا الحاضر، بلغة إيحائية يغلب عليها النفس الصوفي الذي يتدخل حتى في إعادة توزيع أشطر القصيدة وفق بناء خطي وبصري متوتر كما لو أنّه في حالة جذب أو شطح.
وفي شعر محمد الشيخي، لا سيما في ديوانه «الأشجار» (1988) الذي كتبت قصائده بين عامي 1983 – 1986، تدرس المكونات المعجمية المهيمنة في قصائد الديوان، والتي تترابط ترابطا دلاليا يفضي إلى تشكيل مجموعة من الصور الرؤياوية التي لا تقوم على المجاز اللغوي والتعبير الرمزي بقدر ما تقوم على علاقات تصاعدية بين قصائد الديوان. فالنسق العام التصاعدي للصور المشكلة للمعنى الشعري، يعبر عن التحول الدلالي والرمزي الذي يأخذه شجر محمد الشيخي سياقيّاً، وهو شجر الحياة، والمحبة والانتصار للأمل، متحدّراً من أعماق الأسطورة المرتبطة بالموت والانبعاث، في المجاهدة على استرجاع أنفاس الحياة التي يرمز إليها النهر وهو يتدفق بمعاني الخصب والتجدد في جذوع الأشجار الميتة، واستعادة الآمال الخوالي في ذاكرة المكان الجريح (الدار البيضاء، بيروت، غرناطة..)، وهو يلمح إلى هيمنة نسق التضادّ مُتساوقاً مع إيقاع القصيدة النفسي. « لذلك ظل محمد الشيخي يحلم بأن يصير الحزن جمرا مشتعلا يوقظ الهمم، بأشجار يتفيأ تحت ظلالها الحب، وبأزهار تضمد جراح الوطن ».
وهي تتجاوز التوجه الأديولوجي الذي غلب على هذه الحقبة الحرون، أخذت الكتابة الشعرية تتسع لما هو إنساني وكوني، كما عند محمد بنيس في ديوانه «مواسم الشرق» (1985)، بسبب ما عرفته من إبدالات على مستوى البناء النصي والتشكل الدلالي. يتكون الديوان من تسعة مواسم/ قصائد، وجاء ترتيبها مماثلا لترتيب المقامات التي يشهدها الصوفي في رحلته الروحية، ويرمز الطريق عبر هذه الرحلة إلى ما يعرفه العارف من تدرج في السلوك والمجاهدة. تمتد رحلة المواسم – في نظر الباحثة- « بين الحال، والحضرة، والموت، والمشاهدة، مما يؤشر على أن الشاعر، الرائي، عبر خلجان المدن عبورا صوفيا وهو يشاهد بقلبه قبل عينه، حال الأمة العربية الحاضر، والآتي ». فذات الشاعر مرتبطة عضويا بالمكان، يسكن ذاكرتها ومخيلتها، ويسكن أحلامها. وهو في رحابته وتعدد مدلولاته، يتحول من مجرد مكان ثقافي تتبدل جغرافيته وملامحه، إلى دلالات وسياقات تبني الصورة الشعرية في أبعادها المختلفة التي تأخذ منحى إشاريا، وتؤثر في هندسة النص/ القصيدة بصريّاً، حيث تنتشر الكلمات على مسافات مختلفة وفي أشكال هندسية تمتدّ في فضاء الكتابة بشكل لانهائي.
ذات الأنثى والمجاهرة بالصمت
تتوقف الباحثة فاطمة الميموني عند صوتين أساسيين في مدونة الشعر النسائي المغربي المعاصر، لكلٍّ منهما لهجته وفرادته الخاصة. فمن جهة أولى، تبحث مصادر الكتابة عند الشاعرة مليكة العاصمي التي اعتمدتها في إثراء تجربتها الشعرية، واستلهمت عناصرها الغنية بصور متنوعة، مثل التضمين، والمعارضة، والإحالة، والتحوير (القصص الديني، الأسطورة، الأمثال الشعبية، الأشعار القديمة والحديثة، التصوف، التاريخ المغربي والعربي…). وقد صاحب هذا التنوع توظيف أساليب متعددة (التكرار، الاستفهام، النداء، الأمر، إلخ) ساهمت في تشكيل الصور الإيقاعية والدلالية لنصوصها الشعرية، إلى جانب تثمين تعددها اللغوي، بما في ذلك لغة التصوف: « ترمي الشاعرة من وراء هذا التنويع الأسلوبي، إلى خلق مقصديات دلالية تنسجم مع قصيدتها بشكل عام، وهي مقصديات تكاد لا تغيب إلا في بعض قصائدها الغنائية، حيث تنجح الشاعرة في مد قارئها بنفس حماسي (…) مصورة الواقع، منتقدة لأعطابه، داعية إلى التغيير والمقاومة ومؤمنة بتحقيق النصر ».
ومن جهة ثانية، تكشف مشاغل اللغة الصوفية عند الشاعرة أمينة المريني كما في ديوانيها المكابدات » (2005) و »مكاشفات » (2008)؛ حيث تحولت الكتابة الشعرية إلى مكابدة من أجل تطويع العبارة، والارتقاء إلى حياض الإشارة، مما يفرض على قارئ شعرها معرفة باصطلاحات الصوفية وإشاراتهم، وهي اصطلاحات تقوم مقام العبارة في تصوير مواجيدهم. فالتعرف على التأويلات الممكنة التي تتصل بهذه الاصطلاحات ومرجعيتها العرفانية، لا غنى عنه في مقاربة المتن النصي الكلي للديوانين، اللذين بينهما علاقة وصل تتساوق مع ترتيب المقامات والأحوال الصوفية وتُملي مناخاتها الخفيّة، « فلا كشف من غير مكابدة، والمكابدة/ المجاهدة أسبق من حصول المكاشفة، فهي الطريق التي توصل السالك إلى رحيق التفاني والتعالي، إلى الكشف والمكاشفة وتحقيق الرؤية عن طريق البصيرة، وتحصيل المعرفة والوصول إلى الحقيقة المتعالية ». داخل هذه المسافة، ينبني نسق الكتابة على بلاغة الوجد، من مقام إلى مقام، على نحو يرتفع بهذه الكتابة إلى « جنان العرفان ».

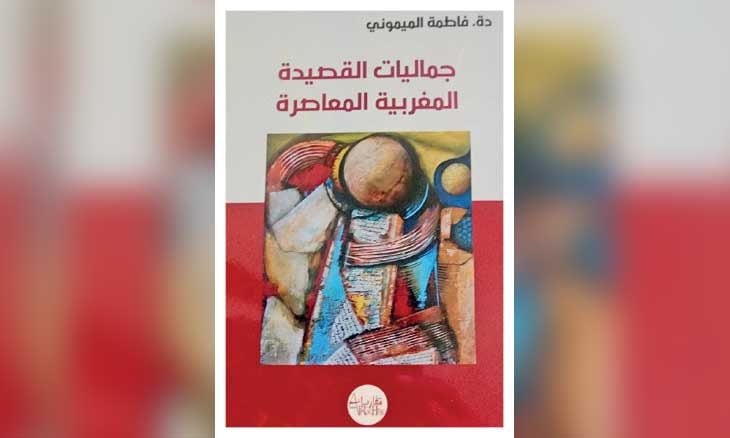
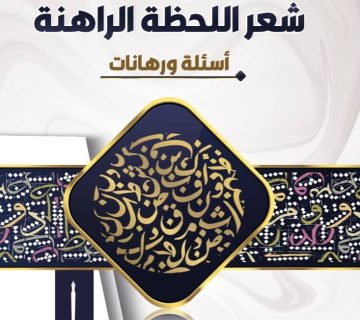


لا تعليق