عبد اللطيف الوراري
ساد في مجال الكتابة السردية العربية الحديثة منذ قرن؛ أي منذ عصر جرجي زيدان، ما سُمّي بـ »الرواية التاريخية »، ولكن يظهر أنّها أخلت مكانها على الأرجح لما صار يُسمّى بـ »التخييل التاريخي »؛ ذلك لأن هذا الخير يستجيب أكثر لطبيعة هذه الكتابة التي تستلهم التاريخ، بل يقود – فنّيًا- إلى تخطّي مشكلة الأنواع الأدبيّة وحدودها ووظائفها، بقدر ما هو يفكّك ثنائيّة الرواية والتاريخ ويعيد دمجهما في هُويّة سرديّة جديدة.
تخييل الواقعة
داخل نظرية السرد يجري التمييز بين القصة والخطاب؛ بين المادة الخامّ التي تحتوي على سلسلة من الأحداث والأفعال والوقائع، فضلًا عمّا يمكن تسميته بالموجودات (الشخصيات، عناصر المكان والزمان)، وبين طريقة تنظيم هذه المادة وصياغتها وفق وسائل تعبيرية يتمّ نقل الرواية بمقتضاها. ومن هنا، لا تتحدّد طبيعة العمل الروائي وبنيته النوعية إلا بالقياس إلى آليات اشتغال خطابه الداخلي. وبالتالي، لا يهمّ ماذا تحكي الرواية، ولكن كيف تحكيه بشكلٍ يصنع اختلافها ويعرض رؤيتها للعالم.
فالتخييل fiction كأيِّ نص يُبْنى على وقائع متخيلة أكثر منه على وقائع حقيقية، والشخصيات التي تكون فيه هي بمثابة «شخصيات خيالية». ويمكن أن يكون عمل التخييل شفاهيًّا أو مكتوبًا، وفي مجال الأدب أو السينما أو المسرح، أو في المجال السمعي البصري، والرقمي بصورة أوسع. بيد أن الوقائع الممثَّلة في التخييل ليست كلُّها بالضرورة متخيلة، كما الحال بالنسبة إلى الرواية التاريخية التي تتأسس على وقائع تاريخية مؤكدة، بل تلك التي تستفيد من فراغات التاريخ من أجل أن تُدخل فيه شخصيات وأحداثًا مستوحاة من خيال المؤلف. وإذا كانت الأحداث أو الشخصيات متخيّلة، فلا ينبغي بالقدر ذاته أن تكون غير واقعيّة irréels. لكي يشتغل التخييل، يبدو ضروريًّا أن ينخرط ناجز التخييل في ما يصفه، أن يصير جزءًا من نسيجه وسداه. ومن جهة التلقي، ينبغي أن يخلق التخييل أثرَ الواقعيّ: الفرد الذي يتوجه إليه التخييل عليه أن يعتقد، لفترة محدودة من زمن الحكي، بأنّ هذه الوقائع ممكنة.
كثيرةٌ هي الروايات العربية الجديدة التي تعيد استثمار المادّة التاريخية وتشكيلها من جديد عبر التخييل السردي؛ وهو ما ينعته الناقد العراقي عبد الله إبراهيم بـ«التخيُّل التاريخي» الذي «لا يحيل على حقائق الماضي، ولا يقرّرها، ولا يروّج لها، إنّما يستوحيها بوصفها ركائز مفسّرة لأحداثه، وهو من نتاج العلاقة المتفاعلة بين السرد المُعزّز بالخيال، والتاريخ المُدعّم بالوقائع، لكنّه تركيب ثالث مختلف عنهما». والأخطر في هذا الزواج بين التاريخي والتخييلي (تخييلًا أو تخييلًا ذاتيًّا) سيشكّل وسيلةً تسمح بإعادة كتابة تواريخ سردية جديدة لأفراد وجماعات، بل تسمح كذلك بجعل حياة أولئك الذين لم ينتموا إلى فئة «المُهمّين في هذا العالم»، ولا مكان لهم في التاريخ، تبدو – بتعبير سيرج دوبروفسكي- مهمّةً في عيون القرّاء، بعد أن يصير لها مكان بديل داخل الرواية. وبالتالي، يمكن القول إنّ وظيفتها الأساسية هي دمقرطة الكتابة عبر منحنى التخييلية التي تجعل من كل حياة تستحقُّ أن تُرْوى. وفي كلّ الأحوال، ينبغي أن نميز بين التاريخ الذي يقوم على «المطابقة» مع الواقع، وبين الرواية التي تستنجد بـ«التخييل» فيما هي تنحاز إلى التلفظ التخييلي باعتباره جوهر السرد الحكائيّ.
أمسى عمل التخييل ذا اعتبار لدى الروائي المعاصر وهو يعرض مادّتها الحكائية، بل مُهَيْمنًا، ومتعدد الروافد بحسب طبيعة النص الروائي وطرق سييرورته ومواثيق اشتغاله الداخلي. فإلى جانب التخييل التاريخي، والتخييل الذاتي الذي ازدهر في الآونة داخل المجال العربي وأثيرت حوله سجالات لم تنقطع، يمكن أن نتحدث عن التخييل العرفاني.
سرديّات بديلة
تُجْمع معاجم اللغة على أن دالّ العرفان مشتقٌّ من «عَرَفَ»، ويعنى به المعرفة. لكن إذا قصرنا على أحدها، وهو (مقاييس اللغة)، نجد أن: العين والراء والفاء صحيحة، يدلُّ أحدها على تتابع الشيء مُتّصلًا بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة. وهذا التحديد يُذكّرنا بمعنى السرد نفسه في اللغة؛ إذ هو: تَقْدمة شيء إلى شيء تأتي به مُتَّسقًا بعضُه في أَثر بعض متتابعًا. هل يعني أن ثمة علاقة بين السرد كخطاب والعرفان كتجربة؟ نعم، ثمة علاقة، لكنها لا تشتغل، أصلًا وتجوُّزًا في آن، إلا حسب آليّة التخييل الذي يعيد بناء هذه التجربة النوعية ويقوم بتسريدها ضمن نصٍّ تعاقُبيٍّ تحكمه حبكة روائية متصلة يحكمها نزوع السفر لغاية المعرفة وتحصيل القرب واليقين، ولكن تتخلّلها وقفات «السكون والطمأنينة» التي تفترضها التجربة نفسها (رؤيا، مشاهد برزخية، مُبشّرات..)، ليس باعتباره تجربة ماضية تمّتْ وانقطعتْ في التاريخ، بل دائمة التدفق وفق مقولة «الشهادة بالحضور» التي هي عماد الرواية العرفانية، أو ما يقع دائرة فعلها السردي؛ حيث ٱهتمّ كتّاب القصة والرواية، ضمن مرحلة التجريب السردي، بالتراث الصوفي العربي- الإسلامي (كتب المناقب، طبقات الصوفية، كرامات الأولياء وأخبارهم..)، وأحيوا سرديّات العرفان بعودتهم إلى هذا التراث.
ينقطع فاعل الخطاب أثناء كتابة الرواية ذات السمت الصوفي أو العرفاني، إلى المخطوطات والمصادر الكبرى لأجل أن يُتثبّت من المعلومات ويستقرئ منها المادة الغُفْل التي يعمل عليها ويعيد تخييلها سرديًّا وتأويل دلالاتها المتعيّنة، أو يبتدع تقنية العثور على مخطوط ويبني عليه. فهو، بهذا العمل، ينخرط في تسريد التجربة حاضرًا فيها وشاهدًا عليها؛ وليس مثل المؤرخ الذي يدّعي أن لا علاقة له بأحداث الماضي ويضرب حولها سياجًا من «الموضوعية»، بل الذي يجعل هذا الماضي مستمرًّا في الحاضر ومنفتحًا على الآتي داخل ما ينتجه الفضاء الفني والجمالي للرواية من إمكانات معرفية وتقنيات كتابية، لغوية، وأليغورية، تستثير أسئلة الحاضر وهمومه. فهذا هذا النمط من الكتابة السردية يستفيد من منجز الرواية كما تواضع عليه الدرس النقدي في جُمّاع مبادئه وخواصّه الكتابية، ويتداخل مع جنس الرواية التاريخية من حيث العودة إلى التاريخ قبل أن يفترق عنها في طريقة الحكي وصوغ الكون الدلالي- الاستعاري، فلا يُضرب عن المعنى التاريخي ودروسه، بقدر ما ينفتح على سجلّ الماضي الحدثي المُغيِّر وعبره على شخصياته التاريخية القلقة التي صنعته وشهدت عليه قبل أن يحتطبها في مجراه الجارف؛ ومن ثمة، فهو يعكس رؤيا وجودية خاصة في النظر إلى الظواهر والأشياء.
تخييل عرفاني
تتميز الرواية العرفانية عن غيرها من أنماط الحكي، مثل الحكاية الخرافية، أو التاريخية، أو العجائبية وغيرها، رغم استثمار بنيتها لعناصر هذه الحكاية أو تلك. إلا أن طرق استيحائها للتراث الصوفي تختلف من عمل إلى آخر على امتداد السرد العربي الحديث، أي منذ كتابات نجيب محفوظ الذي وطّنها بمقدار ما يفيد معاني الانعزال أو الاحتيال أو الاتزان والتوجيه الروحي، التي ترتبط بأوضاع شخصياته الروائية؛ مثل شخصية علي الجنيدي في رواية « اللص والكلاب ». ثم تَطوّر الأمر من توظيف اللغة الصوفية واستحضار مفاهيم أهل العرفان ومقاماتهم في المحبة والكشف والرؤيا والعدالة، إلى أن صارت هذه الرواية نمطًا قائم بذاته. فمثلاً، تقوم رواية عبد الخالق الركابي « سابع أيام الخلق » (1997)، بعد العثور على مخطوط (السيد نور)، على تسريد عرفان المعنى ووجد الحضور ومسالك العارفين المتخيَّلة. ويستوحي أحمد التوفيق في روايته « جارات أبي موسى » سيرة ولي صوفي أندلسي يترك كراماته أثرًا عميقًا في مصائر الجارات ومدينة سلا معًا، مُحيلًا على كتب المناقب المغربية، إلى أن بلغ هذا النمط من الرواية أَوْجَه مع عبد الإله بن عرفة ابتداءً من عمله « جبل قاف » (2002)، ضمن مشروعه الروائي العرفاني الذي ينهض على مفهوم الكتابة بالنور ويعبر به من عالم الواقع إلى عالم الخيال، بقدر ما يستلهم مصدره من القرآن وأسرار حروفه وتجلّياته بحره، فينكشف للذات العارفة من علوم ومعارف واستيهامات ما ينقل نص الرواية إلى ضفاف لا تتوقّعها. مثلما يُسند أحداث الرواية إلى مفهوم آخر؛ هو مفهوم الحاضر أو شهادة الحضور الذي يستوعب الماضي والمستقبل معاً، فيعيد طرح قضايا سابقة وقعت في مجرى التاريخ الجماعي، وبخاصّة تلك القضايا الملحة التي لا تزال ماثلةً أمامنا تخاطب الوجدان والمعرفة والمخيال الجمعي. إن هذا الأثر الكتابي هو ما أوثر تسميته بـ«التخييل العرفاني»، وهو ليس لا تاريخيّاً أو سرديّاً أو ذاتيّاً؛ إنّه تخييلٌ آخر، مُفارق بحكم طبيعة اشتغاله داخل الخطاب الروائي، وعليه تقوم سيرورة بناء الجمالية العرفانية؛ وقد وظّفه عبد الإله بن عرفة واستثمره في رواياته كلّها، وربّما مثّلْنا على عليه بقصة خزانة قاف أو حكاية السمسمات السبع كما في رواية «بلاد صاد» (2009).
إنّ التخييل العرفاني ليس مجرد عنصر من عناصر تسريد التجربة، ولا هو مستوى أو مقولة تبرز وتخفت تبعًا لطبيعة المحكيّ ونموّه في صلب العمل الروائي/ السيري وحسب، بل هو « الدالّ الأكبر » الذي يؤثر بشكل حاسم في دائرة أفعال الرواية العرفانية مبنى ومتنًا، أو زمانًا ومكانً، ويصبغ شخصيّاتها بمقامات بالغة الخصوصية. فلا يمكن أن نتحقّق من عمل التخييل إلا في علاقاته البلّورية بكلّ من المادة الحكائية، وشخص السرد، ولغة الكتابة بالحال، وبلاغتها الخاصّة. ويظلُّ مرجع الكتابة داخله، حتى حين يُحيل على الماضي، أو على أحداث من التاريخ الجمعي والشخصي ولّتْ، مَرْجعًا لا زمنيًّا يستوعب في ديمومته الماضي والمستقبل، من دون أن يأسره الزمن، وفيه يعوِّل على الإنسان الحُرّ عن كل ما سوى الوجود الحقّ؛ الإنسان الذي يُنتِج الفهم الحقيقي للتاريخ بقدر حضوريّته وانخراطه في الأحداث، هنا والآن.
هكذا يظهر لنا أنّ استراتيجية التخييل العرفاني في الرواية تقوم على استدعاء التاريخ وإعادة بنائه نصّيًا على النحو الذي لا يصادم حقيقته على وجه الإمكان والاحتمال، ويجعل ذاكرة الحدث ضرورة من أجل الحاضر والمستقبل، ويجعل الجنيد بمثابة «الشاهد الآني» الذي لا تنقطع شهادته في ديمومة الوجود.


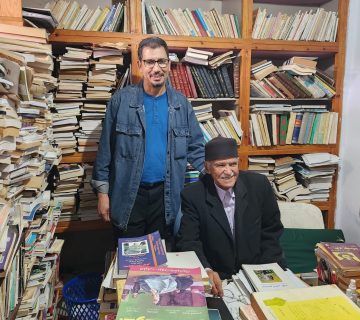
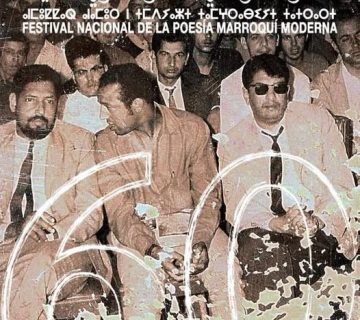

لا تعليق