عبد اللطيف الوراري
لا يفتأ النقاش حول النوع الأدبي يتجدد حول حدوده ووظائفه وعلاقته بالنص وتحولاته عبر العصور والثقافات، ولا سيما في مرحلة الحداثة ثم ما بعد الحداثة، التي شهدت انقلابات تصورية وجمالية بلبلت فهمنا لنظرية الأنواع الأدبية وطرق اشتغالها.
ففي كتابه «شعرية النص العابر للأجناس: من هاجس التأصيل إلى سؤال الحدود» (منشورات دائرة الثقافة، الشارقة 2025)، يعنى الباحث المغربي إبراهيم الكراوي بـ»المسألة الأجناسية» داخل نصوص الشعرية العربية الجديدة وممارساتها الدالة، ويقترح مصطلح «النص العابر للأجناس» بديلا عن «الجنس»، من خلال دراسة علاقاته البلورية بالخطاب، أو النظر إليه بوصفه خطابا رمزيا دالا، من منظور «الشعرية المعممة» حسب اصطلاح الفرنسي فرانسوا راستيي François Rastier.
يعالج الباحث مجموعة من القضايا النظرية والمنهجية التي يثيرها تَبنيه لهذا المصطلح، سواء من حيث أصوله ومرجعياته ومسالك تطوره داخل الخطاب النقدي، وكان السؤال الإشكالي الذي يوجهه: هل النص العابر للأجناس نتاج صيرورة تحولات أنساق النوع الأدبي، أم شكل أدبي تولد عن تحولات الأنواع الكتابية الحديثة؟ وفي تأويل آخر، هل يمكن اعتباره نوعا مستقلا مُتولدا عن تحولات هذه الأنواع، وعاكسا لأنساق وسنن وتبدلات العصر كما يظهر من خلال العولمة والمثاقفة؟
الوظيفة المهيمنة
تنحدر نظرية الأنواع الأدبية إلى أرسطو في كتابه «فن الشعر» حيث قسم الأنواع، من خلال مفهوم المحاكاة، إلى ملحمة وتراجيديا وكوميديا، وعلى خطاه توجهت هذه النظرية، ابتداء من ديوميد، وبوالو، وانتهاء بنورثروب فراي في «تشريح النقد»، إلى قواعد ومعايير صارمة في التصنيف خاصة بكل نوع بإرجاعه إلى الخصائص البنيوية والسمات فيه. ثم أخذت هذه المرحلة المعيارية تتململ، بعد بزوغ الرومانسية الألمانية وطلائع الأدباء المبتكرين. وفي خضم الحداثة وما بعدها، ونتيجة صعود مفاهيم الكتابة والحوارية والتناص مع رموز النزعة النصية (موريس بلانشو، رولان بارث، فيليب سولرس، جوليا كريستيفا..)، حدثت اختراقات في معمار النظرية، تجاوزت مفهوم النوع الأدبي. وقد انبثق «النص العابر للأجناس»، أو ما على شاكلته من مصطلحات مثل الكتابة عبر النوعية والعمل المفتوح وغيرهما، نتيجة هذه الاختراقات النوعية التي تمت في المرحلة الحداثية.
نعم، لا يُنكر عمل المنظرين الكبار؛ من أمثال تزفيتان تودوروف وجيرار جينيت وغيرهما، في الدفاع عن قيام نظرية تتحرر من صرامة المعايير وتتسم بالمرونة والانفتاح في توصيف الأعمال الحديثة وما فيها من خروج على سلطة المعيار. فعلى سبيل المثال، دافع جيرار جينيت عن «جامع النص» Architexte، الذي يحيل إلى مجموع الأنواع المتداخلة في إطار التعالق النصي. كما أقرتْ جوليا كريستيفا من آلية التناص بتداخل الأنواع داخل النص الواحد، وبأن الحوار بين هذه الأنواع هو قانون جوهري داخل النصوص الشعرية الحديثة عبر ثنائيتي الهدم والبناء، والانفصال والاتصال. وحتى داخل المقابلة بين الشعر والنثر، فقد غامت الحدود بينهما، ولم يعد معيار الانزياح، كما في شعرية جان كوهن، ذا جدوى كبيرة في التحليل. فالحوارية والتناص وتداخل الأنواع هي ما يولد شكل «النص العابر للأجناس» بالنسبة إلى الشعر الذي يتوارى ليكشف هُويته في فضاء الكتابة. ولهذه الغاية التي تفيد استراتيجية التحليل، يُسند الباحث إلى «الشعرية المعممة» وظيفة توسيع دلالات المصطلح بشكل شمولي غير تجزيئي؛ وذلك بـ»أن تنظر إلى القصيدة بوصفها استعارة تركب العالم في تفاصيله التي ينحتها، وتربط بين جمالية صورة القصيدة ككل وبين السياق الثقافي، والعالم والوجود وطقوس الكتابة التي ينقلها النوع العابر للأجناس، وتنعكس على خطابه». مثلما يعيد أجرأة مفهوم الوظيفة المهيمنة ودمجه ضمن الأنساق التي تشتغل على وصف النص الشعري العابر للأجناس.
إعادة تأويل
لا يتبني الباحث مصطلح النص العابر للأجناس بديلا عن غيره، بل يعيد تأويله بسبب خلفيته الفلسفية والأنثروبولوجية واللسانية (الاختلاف والائتلاف، التنافر، الانسجام، المعنى اللانهائي، فعل الولادة واستمرارية الحياة، التوليد، الإبداعية..)؛ فهذه المعاني تتوافق ونسيج النص الشعري بما يحتمله من تعدد وحوار وانبثاق متجدد، كما أنه يظل مقترنا بـ»مقصدية الذات المنتجة لفعل الكتابة». بالنسبة إلى الخطاب الشعري الحديث، فقد تحكمت فيه مقصدياتٌ ترتبط بالذاكرة والموت والهوية، في علاقتها بالذات المتمركزة داخل الخطاب. وقد ارتبط كل ذلك بتأثير الوقائع التاريخية الحاسمة مثل هزيمة 1967، والانتكاسات التي شهدها ماضي الشاعر العربي وحاضره، والحروب التي لم تهدأ إلى اليوم.
يتوقف التحليل، ضمن هذه الاستراتيجية، على إبراز البنيات وأنساق المتخيل التي تؤثث مشهد القصيدة الحداثية، ابتداء من عتبة العنوان، وترتبط في الغالب بالموت، وخلاله يحاول البرهنة على كون النص العابر للأجناس كان «ثورة على الأيديولوجيا المغلقة التي تتربص بالذات وتلغي وجودها». فالبناء النصي أمسى يخترق حدود النوع ليعانق فضاء أرحب، من خلال حضور السردي والسيري واليومي والرحلي والميثولوجي، وكل هذه العناصر البانية تتوحد لتؤسس انسجام الخطاب واتساقه، انطلاقا من البؤرة الشعرية حيث يقوم الشاعر بإعادة تشكيل الحدود، فتطفو الحياة على السطح، وتختفي الذات الأحادية فيما هي تلجأ إلى الذاكرة اللامحدودة، بأنساقها الثقافية والفكرية والجمالية. وفي سياق هذا الفهم، يقول: إن الصراع بين الأجناس داخل القصيدة لا يمثل نسقا شكليا يحملنا على تفسيرات ضيقة، بل هو تمطيط لتخييل النص الشعري، وتعبير عن الصراع الداخلي بين الهويات في ظل المنفى الذي تعيشه الذات».
عبر تجارب الشعراء المعاصرين (نوري الجراح، وديع سعادة، سيف الرحبي، عباس بيضون، أدونيس، مبارك وساط..) التي درسها، يكشف الباحث عملَ اللغة بما هي مستودع لطقوس وممارسات التعدد، وإلغاء الحدود، والفوضى الخلاقة والاحتفاء برمزية الإنسان وتجذره في الأرض. وتنطوي بنية السؤال داخل هذه التجارب الكتابية على هاجس إعادة ترسيم حدود النوع أو تدميره من أجل تركيب العالم بشكل مختلف، وفتحه على سردية التاريخ والذاكرة والمتخيل، وتقاطعات الأنا والآخر، وسردية المكان بوصفه سلطة رمزية تعيد بناء معمارية جديدة للخطاب عبر كثافة الوقائع وبلاغة الفضاء ذاته، على نحو يمنح الذات الشاعر معنى لوجودها بقدر ما ينتشلها من الموت الرمزي.


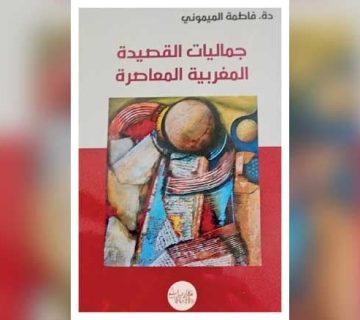
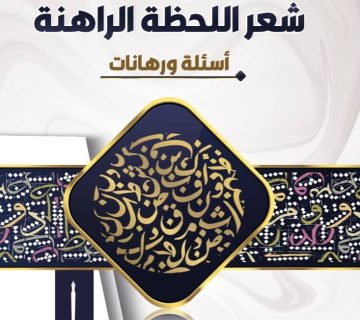

لا تعليق