سيرة من نمط خاصّ
ارتبط مصطلح الـ«بورتريه» بفنّ الرسم، ثم اتسع معناه ليشمل وصف شخصية ما في حقل الكتابة الأدبية، ذات وضع اعتباري أو لها قرابة بالمؤلف. يتجاوز الوصف ما هو خارجي ومبذول إلى الداخل الذي يعني فكر الشخصية ومزاجها وتفكيرها وفلسفتها في الحياة. وتنشدّ كتابة البورتريه إلى المرجع، لأن هذه الوجوه التي يصفها الكاتب هي جزء من تاريخ ذاكرته وسيرته الذاتية وتجربته في الحياة، إلا أن ذلك لا ينفي أثر المخيلة عند نقل تسريد البورتريه واستدعائه في المحكي الذاتي وتشخيصه بطريق اللغة وألاعيبها الفنية، ولاسيما إذا كان الكاتب ناقدا حريصا على موضوعية شهادته من جهة، وشاعرا مسكونا بفتنة المجاز من جهة أخرى. ولهذا، يمكن النظر إلى أدب البورتريه باعتباره من أجناس التلفظ التاريخي، لكنه كأي كتابة ذاتية تتوتر بين ما هو مرجعي وتخييلي.
في «قبيلة من الأنهـار: الذات، الآخر، النص» (منشورات راميتا، 2024) يرسم الشاعر والناقد العراقي علي جعفر العـلاق بورتريهات/ وجوها عن شعراء وكُتّاب فتح وعيه عليهم في بدايات تجربته الأدبية، أو التقى بهم في محطات من عمره في الحياة والكتابة والمنفى، ولا يفوته اليوم أن يتذكّرهم وتتقاطع سيرته مع سيرهم. هكذا تتقاطع سيرة الذات وسيرة الآخر، وتتصادى داخل نص السيرة لغة الشاعر المأخوذة بفتنة الخيال مع لغة الناقد العالمة بشكل تشفُّ فيه عن ضروب الوصف والتأمّل والمعرفة. فاجتماع هاتين الملكتين، الشعرية والنقدية، يحدث المضاعفة التي نكتشفها ونتذوقها، بما هي مبعثٌ للراحة والشعور بالانتشاء العارف، لكن للأسئلة المقلقة والتوتر الخلاق بين الغريزة والعقل، وبين العاطفة والواجب، وبين الحال والمآل. إننا نجد أنفسنا معه في ملتقى حركتين متعارضتين ومثمرتين في آن: حركة تنعطف على الذات، فيما هي تتذكر وتحلم وتُؤنْسن الكائنات والأشياء بشغف، وحركة تتوجه إلى الآخر فيما تُحلّل وتستقصي ما حدث بلا جردة حساب.
فالاستراتيجية التي اعتمدها العـلاق وبنى عليها فكرة الكتاب، أنّه كان يقرأ ذاته في مرآة الآخرين، ويتأمّل سيرتها في سيرهم التي لم تنقطع عن الحنين والتذكر والشهادة، ولم يكن يستطيع أن يمضي في هذا الحكي بعيدا عن ضوء أرواحهم الذي كان يضيء العتمة ويُبدّد سحب الغياب؛ فهو ـ كما قال- «لا يكتفي بذاته، ولا ينغلق على مكوّناتها، بل ينتمي بعمق، أو يُشير بقوّة إلى تلك القبيلة من الأنهار التي ترفل بالماء، أو الضوء، أو الكوارث».
التقاطات شعرية
من ذاتٍ إلى ذات بوصفها آخر، كان العـلاق يحكي سيرته بقدر ما يحكي سيرة الآخرين الذين انتسجت صداقاته معهم، بعد أن انبثقت إمّا من لقاء بالصدفة، أو من رغبة وحلم، أو من موقف طافح بالوفاء والمحبّة، أو في سياقٍ محتدم بالحرج والغيظ. كانت هذه الصداقات تغنم روح الوفاء والتنافس المثمر في لحظة البناء والمسؤولية، قبل أن تحلّ الفاجعة التي فرّقت الأصدقاء ووزّعتهم أيادي سبأ بين منافي الوطن واللغة والشعر. فهو يهتمّ في نسج بورتريهات شخصياته بكلّ ما هو إنساني وبسيط، حتى إنْ بدا في الظاهر مبذولا وتافها، ويستخلص هذا الوصف من مصفاة مشاهداته العيانية ومعرفته بتجاربهم الإبداعية، بواسطة لغةٍ تجري بماء الشعر؛ كأن يصف السياب بأنّه «جديد كشجرةٍ موغلة في القدم، ونازك الملائكة بأنّها «اقتحمت البحر، وتقدَّمت جيلا بأكمله» ومحمد الماغوط بـ»نسر شعري بمخالب منقوعة بالدموع» ومحمد شكري بـ»قمر يبزغ من أسمال طفولته». وما نلمسه كذلك في ثنايا الكتاب من جمل وعبارات وصفية تشبيهية وإيحائية كثيرة، تنحو بالمجاز منحى تشخيصيّا ومرئيّا مُؤثِّرا يمنح الملفوظات شحنة تعبيرية مضاعفة نابعة من ذائقة الكاتب، وموقفه النقدي الذي لا يخلو من تضامن مع هذه الشخصية أو تلك؛ كأن يُشبّه أدونيس بأنّه «ملاك مثخن بالضوء والطعنات، فأيقظ بلغته الجهنّمية ورؤياه المحرقة ماء اللغة» ويصف يوسف الصائغ أثناء محنته حيث «كانت الريح تهبّ قبالة روحه، مثقلة بالدم والوحشة، وكان يجلس وحيدا على سريره البارد وليس معه ما يُضيء به سهره الطويل إلا مخيِّلة مكتظة بالكوابيس وجثّة امرأة لا تريد مفارقته» ويشخص أيام رشدي العامل الأخيرة بأنّها لم تكن سوى «نافذة بالغة الضيق، وسرير بارد، وعكّازة واهنة». ولمّا مات محمد الماغوط وصفه بالصادق الكبير الذي «اجتاز ساعات الكذب الأولى من نيسان/أبريل بقليل، تاركا لموته أن يغمر هذا الشهر بالحزن والعشب والرغبات».
تتخلل لغة العـلاق مشاعرُ الحزن والشعور بالاغتراب والفقد، فكانت النبرة بليغة بقدر ما هي صادمة، فيما هو يتحدّث عن أغلب أصدقائه الذي كابدوا في ظروفٍ لا إنسانية صعبة مرارة عيشهم وزمنهم المنقوع بالخسارات في الحياة والكتابة وقضوا في الجوع والغربة واليأس، ويعكس درجة تفجُّعه بموتهم الهامس والصادم واحدا تلو الآخر، فجعل ذاكرة الكتاب تتوتّر بين الغياب والحضور، وشهادة حيّة على معذّبي الوطن الذين انقطعت خطاهم: «يتناثرون على طرقات العالم، أو تحت نجوم الله الخافتة، ويأكلهم الحنين إلى وطنهم المعذَّب، دون أن تظهر لهم في الأفق نجمة أو بشارة».
كما لا يخلو وصف البورتريهات بملامح أصحابها الخارجية والداخلية، وهيئاتهم المتوتّرة، من مقصد بليغ يقرأ التحوّلات كما ارتسمت، قويّة وحارّة، على الأصوات والعيون والشفاه والأيدي والمشي والقامات والأمزجة والأرواح، ويتبيّنها وجها لوجه أو على أسلاك الهاتف أو من مرأى بعيد، فيما يصلح ليكون التقاطات فوتوغرافية روحية، حميمة وطريفة ونادرة في آن، بل عابرة للأزمنة. فعلى سبيل المثال، يصف صوت هذا أو ذاك كأنه يقيس مداه ويقرأ لويناته وما أثر عنه ويسافر به في التاريخ؛ فهذا صوت محمد مهدي الجواهري «المثخن بعذاب الواقع ودويّ التاريخ» وبلند الحيدري «كان صوته مثخنا بعذابٍ قديم، وكان ليوسف الصائغ «صوته المليء بالشروخ مع ما فيه «من ثراء إنشادي ابتهالي» و»لم يكن صوت مظفر أقلّ تأثيرا، غير أنّ الخدوش والتغضُّنات كانت بادية عليه» وهذا صوت فوزي كريم المفعم بالعذوبة «يفوح من جدران القاعة محملا بوعود الستينيات وأمطارها البعيدة» ووجد في نبرة عبد العزيز المقالح «تموُّجا حميما» و»لا تراه في أحاديثه إلا هامسا حتّى لو كان ينادي كوكبا نائيا أو غزالة ضائعة».
ومثل ذلك العيون والوجوه والقامات والأمزجة التي في وصفه إيّاها روح إعجاب ووفاء وقرب، وأحيانا لا تخلو من محاكاة ساخرة أو هجاء مبطن؛ فهذا جبرا إبراهيم جبرا كانت له «عينان متأمّلتان وملامح شديدة الرهافة، وغليون لا يفارق يده أو شفتيه» وكان عبد الوهاب البياتي «مثل شجرة برّية: شائكا، ومهيبا، وقادرا على الإيذاء» وكان لسعدي يوسف «وجه مكدود ترابيّ متغضِّن.. وعينان متعبتان، وشفتان مزمومتان على الدوام» ولمؤنس الرزاز «قامة فارعة تملأ العين، وجسد كجسد الرياضيين يطفح وسامة وعافية وشبابا، وكان مزاج محمد شكري في نظره يعبر عما في كتابته من متناقضات، فهو صاحب «رقّة لا تخلو من عنف، وقسوة بيضاء كالطفولة، وكأنّه الأضداد مجتمعة في حوار عجيب».
أخلاقيّات الصداقة
في مقالات الكتاب التي تنيف عن العشرين، ثمة احتفاء بالصداقة وقيمها الإنسانية الرفيعة بشكل يتداخل فيه الذاتي والموضوعي بصدق ودون حرج، حين يُلقي الواجب بضوئه العارف على شاعرٍ هنا وكاتبٍ هناك، على نحو ما يكشف عن خصوصيّته في الكتابة ومعاناة الحياة على حوافّ العمر المثخن بخيبة الأمل والوعي بالانحدار الفاجع إلى مهاوي التاريخ. ففي أحايين كثيرة، يتّخذ الحديث عن هذا أو ذاك صفة الذريعة لكشف المزاج الخاص، أو الاتجاه الشعري أو الموقف الفكري والأيديولوجي الذي يُنتسب إليه، حيث نجد أنفسنا أمام (ريبرتوار) غنيّ بالمعرفة الجمالية، ونقد الظواهر النصّية، سواء في حديثه عن الرؤيا وعلاقتها بالأسطورة في شعر السياب، أو عن مشروع نازك الملائكة الشعري والنقدي الذي كان يقف عند منتصف الطريق دائما، وعن النزعة الدرامية في شعر بلند الحيدري، وشهوة السرد عند يوسف الصائغ، والصورة الشعرية الغريبة والتشبيهات المتشابكة عند محمد الماغوط، وشعرية المنفى في نصوص سعدي يوسف، والغنائية في شعر محمود درويش، وتعايش المثقف والمسؤول في شخصية عبد العزيز المقالح، والموقف النقدي من الحداثة الشعرية وموضوعاتها لدى فوزي كريم، والسخرية في روايات مؤنس الرزاز. كما لا يخفي إعجابه بالطريقة الفذّة التي كان يُنشد بها الجواهري شعره، وبمنهج محسن إطيمش البارع في دراسة الإيقاع وعلاقته بالشحنة النفسية للنص الشعري. وفي أحايين أخرى، يريد أن ينتصر لمن لحقهم الحيف النقدي، مثل بلند الحيدري ونزار قباني وغيرهما، كما نجد نقدا ضمنيّا لاذعا، في خضمّ المعترك الذي اجتازه الجميع، لأولئك من أدعياء الحداثة الذين ملأوا المشهد وصدعوا بالموضة والإرهاب اللفظي وانتفاخات الذات التي لا حدود لها.
وفي سياق هذه التحليلات والآراء الخاطفة والكاشفة بلغةٍ تسترسل في البوح وتبتهج بالمعرفة، لم يكن العلاق يخفي شعوره بالإعجاب والتأثر والاعتراف بمديونيّته لأصدقائه من الشعراء والكتّاب الذين نذروا أرواحهم لعراء الكتابة ومنفى اللغة، ولا يتنافى ذلك مع رأي صريح يدلي به لا يخلو من صرامة الناقد وقسوته، وحينا يمسح الأذى ويرفع كلفة الحرج. بذاكرةٍ نشيطة ومشتعلة، يتذكّر الأصدقاء بمحبة ووفاء، ويترك كلامه، مسترسلا بتلقائية وحذر في آن، يشتبك مع عشرات عناوين الأعمال الشعرية والسردية والنقدية التي رجع إليها، وعشرات أسماء الأعلام من شعراء وكتّاب وأساتذة جامعيين كان صادقهم أو التقى بهم في الأماسي الشعرية والجلسات الحميمة ببيت أو مطعم أو مقهى، أو داخل أجواء المحاضرات، ومكاتب العمل، والمطارات، وردهات الفنادق، والمنافي، في أكثر من عاصمة ومدينة عربية أو أوروبية (بغداد، صنعاء، عمان، طنجة، لندن، بيروت، دمشق..).
بموازاةٍ مع ذلك، كان يسرد ذاته منذ أن كان طالبا نبيها يكتب الشعر، ويلقى الاحترام من أساتذته في المدرسة أو الجامعة، ويفرح بأوّل قصائده ومقالاته تنشر في مجلتي «العاملون في النفط» و»الأديب» أو هو طالب باحث في جامعة إكستر البريطانية يُحضّر أطروحته حول «المشكلات الفنّية في شعر البياتي» تحت إشراف المستشرق الاسكتلندي جاك سمارت، ويعود إلى بغداد ليعمل محاضرا في جامعتي بغداد والمستنصرية بين أعوام 1985- 1990، ويرأس تحرير مجلة «الأقلام» الأدبية المؤثّرة وذائعة الصيت من 1984 وحتى 1990، ثمّ يجد نفسه في معترك الطوفان السياسي والثقافي الذي كان يجتازه العراق. وبعد الحرب على بلده عام 1991، وعدوى الديكتاتورية التي أصابت الجميع بالتلف والعماء، يغادر العلاق إلى اليمن للتدريس في جامعة صنعاء حتى عام 1997، ثمّ في جامعة الإمارات أستاذا محاضرا للأدب الحديث والنقد إلى حين تقاعده. وفي معترك هذه السيرة، كان يحرص على تجنب الطرق العامة والابتعاد عن أصوات الآخرين أو تقليد تجاربهم، مسكونا بهاجس كتابة قصيدته الخاصّة التي تشبهه.
هو، إذن، كتابٌ في أدب البورتريه، محكم الصنع، بوليفونيٌّ، مُتعدّد الأصوات والأهواء والأمزجة والأساليب. تتداخل فيه ضروب الشجن، والسحر، والتأمل، والمعرفة، والشهادة، والنقد، والاعترافات الحميمة التي لا تخلو من صدق ونبل بالغي التأثير. ينقل أجواء الطوفان السياسي والثقافي الهائج، ويفسح لمختلف أشكال الشعر العمودي والتفعيلي والنثري، الفصيح والشعبي، أن تُعبّر عن نفسها وعصرها بدرجات متفاوتة القيمة والأثر. وهو، قبل هذا وذاك، كتابٌ توثيقيٌّ مثقل بإحالاته المرجعية وشذراته الإيحائيّة المثقّفة التي تتفتق في كل زاويـة منه بالشعر دون أن تخون أو تتخلّى عن أمانتها، وهذا ما يبقى!
عبد اللطيف الوراري

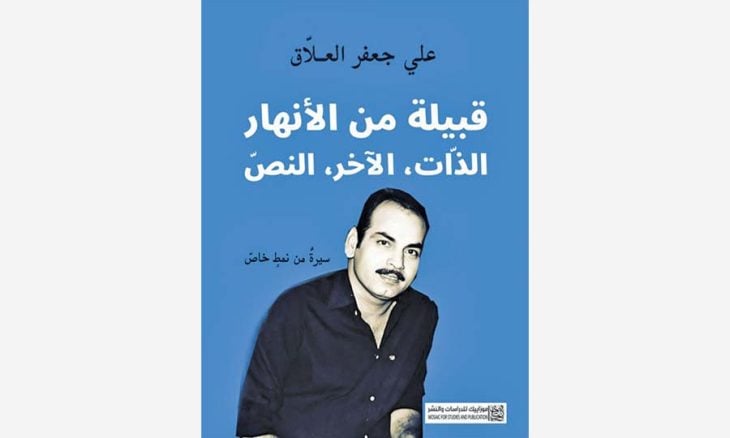
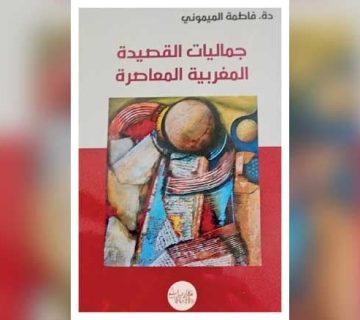
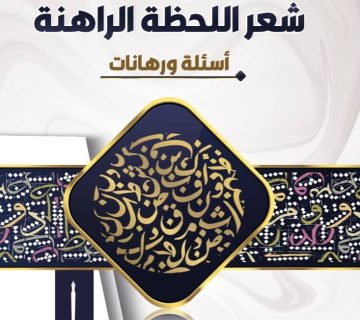

لا تعليق