كنتُ غائبًا حتّى وجدتُ في شغفي بالمطالعة الأدبية، خلال شبابي الأول، حلًّا رائعًا في متناول اليد، بعد الذي غنمتُهُ من سوق الكتب المستعملة، أو أَعَرْتُه من بعض المتأدّبين الشباب. حظّي أَوْفرَ من كتب مصطفى لطفي المنفلوطي، وجبران خليل جبران، ونجيب محفوظ، المنتشرة بطبعاتها التجارية في كلّ مكان. عدا بعض الكتب الفلسفية والفكرية التي كانت مِحكًّا لعقلي قبل الأوان. كما وجدتُ في لعب الكلمات المتقاطعة التي شغفتُ بها هوايةً للتّسلية والتّثقيف الذّهني واللّغوي، بل غنمتُ، بعد جَرْدات القافية، رصيدًا من اللّغة الفصحى لا يُستهان به. وأذكر أنِّي كنْتُ أحمل معي بعض هذه الكتب إلى القرية النّائية على رأس كل عطلة صيف، وكنت أعتكف، طوال العطلة، على قراءة الكتب بنَهمٍ، حتى سمعت من بعضهم أنَّ ولد عبد الله به مسٌّ أو قد جُنّ من فراغ اليد. كما أخذْتُ أتردّد على أكشاك بيع الصّحف والمجلاّت الوطنيّة والعربيّة، وأتصفّحها في غفلةٍ من أصحابها، فأطالع منها على عناوينها الرّئيسية التي تأخذني إلى قضايا قوميّة ووطنيّة، أو أقتنيها إن بدا لي لا بُدّ. وكانت قضيّة فلسطين من العناوين الأكثر بروزًا وإيلامًا، ولاسيما مع انتفاضة أطفال الحجارة التي انطلقت عام سبع وثمانين من جباليا في قطاع غزة، قبل أن تشتعل في كل أرض فلسطين. تأثّرت بما كنت أقرؤه عن فلسطين، وأرى جرحي من جراحها النازفة التي لا تندمل، وكان هذا كافِيًا ليغذي في نفسي شعورًا قوميًّا أصيلًا. وكتبتُ في بداياتي الأولى شعرًا عن فلسطين وأطفال الحجارة، مُتأثِّرًا بما كنت أقرؤه لشعراء من المغرب والمشرق عن الانتفاضة حيث الشِّعر أكثر المُؤبِّنين وأكثرهم هُتافًا. قد أكون سمعتُ عن الشاعر محمود درويش في هذه الفترة، أو بالأحرى سمعتُ شعره المُغنّى بصوتِ مارسيل خليفة، لكن لم أقرأ له بشكل واعٍ إلا بعد سنتين أو ثلاث من هذا التاريخ.
وعلى شاشة التلفزيون كنتُ أتطلع إلى مشاهدة البرامج الثقافية على نُدْرتها، وكان من بينها برنامج « منتدى الثقافة » الذي غلّبت فقراتُه البعدَ الترفيهيَّ على حساب التثقيف الجادّ. لكن البرنامج الذي شدَّني إليه على الإطلاق هو « دفاتر الأيام » الذي آليت على نفسي ألا أحرمها منه، وإن اضطررت إلى أن أشاهد بعض حلقاته واقِفًا بإحدى مقاهي المدينة، أو محشورًا وسط اللّغط. يتحدث هذا البرنامج في كل حلقة منه عن شخصيّة بارزة في عالم الشعر والأدب؛ من أمثال: نجيب محفوظ، مصطفى أمين، توفيق الحكيم، إحسان عبد القدوس، عائشة بنت الرحمن، عمر أبو ريشة، محمد مهدي الجواهري، يوسف إدريس، ميخائيل نعيمة، يحيى حقي، سهير القلماوي، عبد الله البردوني. مرّةً أُخْرى، بعد كتاب حنّا فاخوري « تاريخ الأدب العربي »، لا مغربيًّا بينهم كأنّ ربّة الشّعر والأدب رفعت القلم عن المغاربة. فأنْ يتحدّث شاعر أو أديب عن ماضيه الشّخصي، ويتطرق إلى أطراف من سيرته الذاتية، أو إلى المصادر الأساسية التي ينهل منها، وطقوس كتابته، والمصاعب التي واجهها في بدايات تفتُّق موهبته الأدبية، كان مِمّا يستهويني في البرنامج ويجعلني فاغِرًا فايَ كأنّ بي مَسًّا. ورُبّما رسخت بذاكرتي صورة إحسان عبد القدوس بجسده الغليظ، ووجهه الطفولي المضيء، وهو يتحدث عن علاقته العجيبة بأُمّه روز اليوسف.
بَيْد أنَّ قَـــدَرًا جميلًا كان في انتظاري في زاوية ما من العالم؛ إذ قادَتْني يدايَ -لا أدري إن كان الأمر صُدْفةً أم هِبةً؟ – إلى كتاب « ميزان الذهب في صناعة أشعار العرب » للسّيد أحمد الهاشمي، الذي كان بمثابة كتاب مُقدّس. ظننْتُهُ في الأول كتابًا من كتب السّحر والشّعوذة التي كانت ذائعة بين أيدي الناس، وذلك لكثرة ما فيه من الجدول وأشكال الترميز والتّقسيم والتّقطيع، شبيهًا بـ »كتاب الدمياطي » الشّهير. نعم، إنّه كتابُ سِحْرٍ، لكنّهُ سِحْرُ الشِّعر. سأظلُّ مع هذا الكتاب لوقْتٍ أَنْساني همَّ الوقت، أحفظ ما فيه من أبيات الشّعر المنتقاة بعناية، وأجد ما فيها من القيم الرفيعة سلوى لي. وأتعلّم منه -بشيء من الحرص- قوانين العروض والقافية من خلال التمارين التي تتكرر في نهاية كل بحر شعري، ثُمّ فيما يتعلق منها بالقافية من حيث حروفها وعيوبها. وأنفقْتُ ساعاتٍ أحاول ضبط الأوزان عن طريق تقطيع الأبيات عروضيًّا، وكنت أفعل ذلك بمنأى عن عيون الفضوليّين؛ فلو رآني أحدهم في ما أنا فيه من الأهوال والأحوال، لكان راعه منظري وأنا أتفصّدُ عرقًا وأتمتم بحروف غامضة لا تبين، كأنّي نبيٌّ يتلقّى وَحْيًا من السّماء ويتكتّمُ عليه. سوّدْتُ أوراقًا كثيرةً، وخططتُ خَرْبشاتٍ بِخطّي الغريب، وأنا أركض وراء الكلمات بشُبّاكي حتى تقع على التّفاعيل بِـأيِّ معنى كان. ومُسمِّرًا عينيَّ في المعجم، أدوّن القوافي التي تنتهي بالحرف نفسِه. قافيةً إثر قافية مثل سِكّة حديدٍ بلا مسافرين. وقد أتاح لي التّمْرين العَروضيّ الشّاقّ أن أحوز ثقافة إيقاعيّة، سماعيّة وبصريّة في آنٍ، أوقعتني في مواقف حرج داخل الفصل الدّراسي مع أساتذة لا يعرفون من العروض والقافية إلاّ معلومات عامّة وغابت عنهم دقائق العِلْمين. وأذكر أن أحدهم نهرني بقوّة، وتوعّدني بالطّرد إذا عدْتُ إلى تخطئته بمرأى التلاميذ، كأنّي أهنْتُه في كرامة.
كانت حدود وعيي بالشِّعر، في ذلك الوقت، ما تزال غائمة ومضطربة، بموازاة مع طرق تدريس الأدب العقيمة وما يستتبعها من نزوع مدرسيّ يُشيِّئ القصيدةَ ويُسطِّح عمقها اللّغوي والمجازي إلى حدٍّ فادح. مُعلَّقاتٌ، قصائدُ ومقطوعاتٌ شعريةٌ كانت تمرُّ أمامي عيني دون أن تُثير فيّ إِحْساسًا، ولا أن تحملني إلى مسافةٍ أخرى من الجمال والذوق. فقد كان مُدرّسو العربية يتأفّفون من الشعر، ويُكنّون عَداءً خفيًّا إزاءه. وحتى منهجيّة تدريسهم للنّصوص الأدبية التي تغلب عليها الظروف التاريخية، وبالتالي تحجب ما فيها من صنعة وإبداع، لها يَدٌ طولى في الأمر. ولهذا، كانت حِصّة الشّعر ثقيلةً ومُملّة وبلا معنى يُذكر. نتيجة ذلك كُلِّه، غدا أقراني من التلاميذ يُكنّون العداء نفسَه، بل يُجاهرون به. إنّ أيَّ طالب بينهم يحسن إلقاء قصيدة، أو ينجز عَرْضًا عن الشّعر، أو يتدخّل برأي جمالي فيه كان يضع نفسه في موقف لا يُحسد عليه من السّخرية والتنكيت، فلا يعود إلى ذلك مرّة ثانية. لم يكن الأمر يتعلّق بجيلي، بل بأجيالٍ سبقت وأخرى أتتْ لاحِقًا. عداءٌ مُسْتحكم، بالفعل.
ولولا قدماي اللّتانِ ساقتاني إلى دواوين خارج الفصل الدّراسيّ وإكراهاته، ولولا حاجة إلى تعويض كنْتُ أحِسُّها في داخلي، لَوجدْتُ نفسي بينهم ناقمًا على الشِّعر وأهله. قادَتْني خُطايَ إلى مكتبة هنا، ومكتبة هناك، فاقتنيْتُ دواوينَ من الشّعر مما يدَّخر صاحبها منه: « رباعيات الخيام » بترجمة أحمد رامي، « الملاّح التائه » لعلي محمود طه، « الحياة الحب » لإبراهيم محمد نجا الذي أُعْجِبْتُ بقصائده الرومانسية والذات الأسيانة الشّفيفة التي تخترقها. كما تحايلْتُ على دواوينَ أخرى بإعارة أو إغارة، من مثل: « أغاني الحياة » لأبي القاسم الشابي، و »ديوان إيليا أبي ماضي »، و »ديوان بهاء الدين زهير » و »ديوان أبي تمام ». كانت ساعاتي بين الدّواوين الأولى ساعاتِ حبّ وإصغاء وتعلُّم وصفاء، ثُمّ سرعان ما استحال ذلك إلى أجنحة أطير بها وأُغنّي من الحرمان، وعلى شفاهي هذا البيت الشّعري لإيليا أبي ماضي: الشُّجاعُ الشُّجاعُ عندي من أَمْسَى يُغنّي والدّمْـــعُ في الأجفانِ
شيئًا فشيئًا، صارت قراءاتي للشّعر العربي تتنوَّع بين القديم والحديث، فتعرّفْتُ على سحر الجاهلية، وحداثات المتنبي وأبي تمام والمعري العابرة للأزمنة، ورقّة شعراء الغزل في نسج رؤاهم للحبّ ومعاناته، ثُمّ تعرّفت -تحت شعورٍ بالعجب والصدمة- على حيويّة الشّعر الحر في عبوره إلى العصر وحداثته ونهوضه بِمُتخيّلٍ شعريٍّ جديد. وأما حَظِّي من الشّعر المغربي فكان ضئيلًا، إلّا ما وقع بين يديَّ مما كان مُتاحًا أو كان يُنْشر مُتفرّقًا من شعر شعراء غذّوا في نفسي شعورًا بِهُويّتي الجريحة التي لم تنشأ في بادئ الأمر سوى على بريق أيقونات رياضية (عبد السلام الراضي، سعيد عويطة، نوال المتوكل، محمد التيمومي…). كان أبرز هؤلاء الشّعراء الذين قرأتُ لهم: محمد الحلوي الذي كانت قصائده منتشرة في الكتاب المدرسي، وأحمد المجاطي وعبد الكريم الطبال وحسن الطريبق وأحمد بلحاج آية وارهام وإدريس الملياني ومحمد الطوبي، الذين كنتُ أطالع بانتظام ما ينشرونه في أحد الملحقين الثقافيين لجريدتيْ العلم والاتحاد الاشتراكي، أو في صفحات بعض المجلّات، قبل أن يتاح لي قراءة دواوين « روض الزيتون » لشاعر الحمراء محمد بن إبراهيم، و »آخر أعوام العقم » لمحمد الميموني، و »سيرة المطر » لمحمد الأشعري. كما كانت أشعار فنّيْ « العيطة » و »الملحون » الأصيلين أبلغ في وجداني، ثمّ سرعان ما انفتحتُ على الشعر الفرنسي وسواه من أشعار العالم مُترجمةً إلى العربية من خلال مجلّتيْ « لوتس » و »الكرمل ».
لكن الديوان الذي زلزل فهمي للشِّعر وأراني العالم بوجْهٍ آخَر، هو ديوان « أحلى قصائدي » للشاعر نزار قباني الذي كانت شهرته تطبق الآفاق. والديوان عبارة عن كتاب جيب يسهل عليَّ حمله أنّى حللتُ وارتحلت، وكان بمثابة مختارات شعرية تضمُّ القصائد المفاتيح لشعر هذا الشاعر، التي تركت وراءها أسئلة وحرائقَ ودُخانًا. ما كان يجذبني إليه فيستحوذ على مشاعري هو الموضوعات التي هرّبتْ أحلامي من مقصورة الرومانسيين وجعلتها في تماسّ مع الواقع ومِحَكِّه اللاهب الذي كان يغلي في بداية التسعينات، قبل أن ينصرف اهتمامي إلى اللغة المتوتّرة الجذّابة التي كتب بها نزار، والإيقاع الذي عزف عليه شعره بنمطيه العمودي والتفعيلي مَسْموعًا وقويًّا.
من أمكنةٍ بعيدة، كانت تنادي كتبُ الشِّعر على صبواتي الوليدة من الحبّ إلى معاناته بما في ذلك معاناة صَوْغه لُغَويًّا. فقد فعلت فيَّ الأشعار، على فتراتٍ متعاقبة، فعل السِّحْر وقدحت ذهني، ووشمت وجداني، فصارت رؤيتي للعالم، نتيجةً لمقروئيّـتي وتفاعلي معها، رومانسيّةً وحالمةً قبل أن تصطبغ بشيء من الواقعيّة. وقد أحسسْتُ في قرارة نفسي، بعد سنواتٍ من اغترابي النفسي والوجودي، بأنّي عثرْتُ على أصفيائي من الشعراء من هؤلاء وأولئك، وقد قرأْتُ ما خطُّوه بكلِّ جوارحي، وذرفتُ معهم دموع هذه التجربة أو تلك، وارتفعْتُ وإيّاهُمْ على مدارج الحلم والخيال. كما أحسسْتُ في هذه اللحظة برغبة عارمة وغامضة في التعبير كأيّ شاعرٍ وجد نفسه في حياة صعبة أعزلَ إلّا من أشواق سريرته الّساعية إلى التحرُّر والانطلاق. لا أقول إن المصادفة هي التي قادتني إلى القصيدة، بل الضرورة التي تتغذّى على شرطنا الإنساني، وأفكّر في جان كوكتو وهو يصرخ: « الشّعر ضرورةٌ، وآه لو أعرف لماذا! ».
عبد اللطيف الوراري، ضوء ودخان: شذرات من سيرة ذاتية، طنجة 2016 (بتصرف).



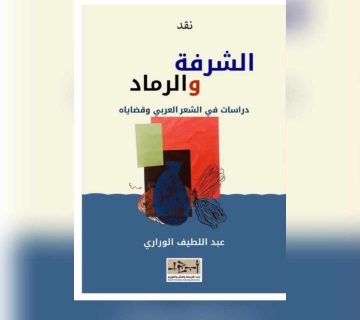

لا تعليق