الاستعارة خطاب قديم وباب طريف استمال إليه المبدعين والمفكّرين في كل الثقافات والعصور بما هي موضوع تفكير لغوي وبلاغي وفلسفي وجمالي ونفسي؛ فأنت تجده في الشعر، والحكايات، والأساطير، والخطب، والمناظرات، والمحاورات الفلسفية، بهذا القدر أو ذاك.
عبد اللطيف الوراري
لقد حار منظّرو الخطاب أمام الاستعارة، فلم يأل جهدًا لبحثها ودراسة وجوهها الفنية، بما في ذلك بلاغيّونا القدامى الذين حازوا فضل الريادة إذ أتوا في تحليلاتهم للاستعارة بالتالد والطريف. وقد انتبه أمبرتو إيكو إلى ما سمّاه «العقدة الاستعارية»؛ بمعنى أن الحديث عن الاستعارة هو بحدّ ذاته حديث عن النشاط البلاغي بكل ما فيه من تعقيد، وما يستوعبه من النماذج الأصلية ومن أفانين الرمز والحلم والأسطورة والرغبة والهذيان والإبداع والتمثيل وغيرها، مستخلصًا «بأنّه من بين آلاف الصفحات التي كتبت عن الاستعارة، نجد القليل منها يضيف شيئًا جديدًا» إلى ما قدّمه أرسطو ووصف به الاستعارة بكونها «حيلةً تمكن من الحديث مجازيًّا». يذكر إيكو أن البيبلوغرافيا التي أعدها شيبلس حول الاستعارة تقارب ثلاثة آلاف عنوان، ويتطرق في الباب الثالث المعنون بـ»الاستعارة وتوليد الدلالة» لجملة من التنويعات التي مثّلت في نظرة «قطيعة معرفية» وانطلقت بالنقاش حول الاستعارة وتصوّراتها نحو آفاق جديدة.
من اللغة إلى الخطاب
بيد أنّ الاستعارة اليوم قد تجاوزت اللغة لتشمل جماع الأنشطة والأعمال التي يقوم بها الإنسان في وقتنا الحالي الذي يضجّ بالصور والعلامات المتنوعة، وهو ما فرض على الدارسين الانطلاق إلى آفاق جديدة وتجديد أدوات تحليلهم لبيان عمل الاستعارة وتفكيك استراتيجياتها الخطابية، وذلك من منظورات معرفية مختلفة؛ بلاغية وفلسفية وبنيوية ولسانية وسيميائية وتداولية وعرفانية (ريتشارد، هايدغر، جان كوهن، غريماس، جماعة مو، بيرلمان، ريكور، إيكو..).
وفي هذا السياق، يأتي كتاب الباحث محمد بازي «البنى الاستعارية، نحو بلاغة موسّعة» (منشورات ضفاف، بيروت، ط.1، 2017)؛ إذ يقترح مفهوم الأنوال لتحليل الاستراتيجيات الاستعارية أو البنى الاستعارية التي تقوم عليها صناعة الخطاب، عابرًا من المنوال التقابلي إلى المنوال الاستعاري، الذي به يوسع النظر لمجال عمل الاستعارات على نحو ما يغني تحليل الخطاب في جانبه الاستعاري بمختلف بناه الخطابية الممكنة من لغوية وتصوّرية ومنوالية. يندرج هذا الكتاب ضمن المشروع التأويلي الذي دشّنه الباحث مع أطروحته الجامعة «التأويلية العربية: نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات» (2010)، وقد سبق في أحد بحوث هذا المشروع «البنى التقابلية، خرائط جديدة لتحليل الخطاب» (2015) أن ناقش تأويلية النسق الاستعاري على مستويي الجملة والنص، وفيه كشف عن الأساس التقابلي للاستعارة. وبما أنّ المشروع، كأيّ سيرورة معرفية تتطلب مزيدًا من البحث والمراجعة والتوسيع باستمرار، فقد عاد الباحث إلى تقديم مقترح جديد ينهض بتوسيع عمل الاستعارة ونسقها التصوُّري على نحو يساهم في فهم وإدراك دينامية الاستعارة في تشكيل الخطابات من جهة، وفي الارتقاء بتأويل الاستعارات عبر ما يسميه بـ»الجريان الاستعاري الجوّال».
هندسة مفاهيمية
في أفق بناء نموذج استعاري مأمول ومفكَّر فيه، يطرح الباحث السؤال التالي: ما البنى الاستعارية التي تقوم عليها صناعة الخطاب؟
يفترض مثل هذا السؤال ابتداءً مراجعة التصورات الأساسية والأطر المرجعية التي ارتبطت بنظريّات الاستعارة، سواء منها التقليدية ذات الصلة بالتراث البلاغي والنقدي عند العرب، أو تلك التي ترفدها النظرية الغربية الحديثة والمعاصرة، وذلك قبل مراجعتها ونقدها وتوسيعها ضمن مشروع تأويلي وتطبيقي يترجّح بين علم التأويل المعاصر، وتحليل الخطاب، الخطاب الاستعاري تحديدًا، منفتحًا على معطيات العصر الثقافية والجمالية قياسًا إلى «الإبستيمي» بتعبير ميشيل فوكو في «الكلمات والأشياء»، ولا علاقة لها بالتصنيفات التاريخية، وإنّما يقصد به جميع العلاقات التي توجد في عصر ما بين مختلف مجالات العلم، أو كلّ هذه الظواهر التي تصل بين العلوم أو بين الخطابات المختلفة في شتى المجالات العلمية. فمن جهة أولى، يراجع الباحث منظومة الاستعارة كما هي متوارثة منذ السكاكي صاحب «مفتاح العلوم»؛ فإذا كانت تقدم إجابات في حدود المعقول بالنظر إلى مجالها الاصطلاحي ومجال اشتغالها الخطابي (قرآن، حديث، شعر)، إلا أنها تعجز عن تقديم رؤى أو تصورات تحليلية لما استجدّ في نظرية الأدب العربي الحديث والمعاصر. ومن جهة ثانية، ينفتح على ما قدّمه الباحثون الغربيّون في مجال عمل الاستعارة، وقد وجد أن هؤلاء منذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين أحدثوا إمكانات جديدة للبحث راهنت على تفسير الأنساق الاستعارية في الفكر والتصور، وعلم النفس، وعمل الذهن، وتأثيرات الجسد، مسنودةً من علوم معاصرة مثل العلم المعرفي، وعلم الحاسوب، وعلم الأعصاب. وفي هذا السياق، يتصادى مشروع البحث مع مقترحات رائدة؛ مثل مقترح لايكوف وجونسون «الاستعارات التي نحيا بها» (1980)، ولاسيما في إقرارهما بأنّ الاستعارة «ليست مقتصرة على اللغة، بل توجد في تفكيرنا وفي الأعمال التي نقوم بها أيضا»، بحيث إنّ قطاعًا هائلًا من تجاربنا وانفعالاتنا وسلوكاتنا اليومية البسيطة بكلّ تفاصيلها هو استعاريٌّ من حيث طبيعته، فلا تكون هذه الاستعارات تعابير مشتقة من «حقائق» أصلية، بل هي بحد ذاتها «حقائق» كاشفة عن نسقنا التصوُّري؛ ومن ثمّة، عملا على استثمار العبارات اللغوية الشائعة لمعرفة التصورات الاستعارية وفهم سلوكاتنا اليومية من خلالها.
كما يتصادى مع مقترح محمد مفتاح باعتباره نتاج هذه النظرية أو امتدادًا لها، ولاسيما في «مجهول البيان» (1990)، الذي عمل بدوره على استنبات نظرية استعارة النص أو استعارة السياق في تحليل الخطاب الاستعاري العربي استنادًا إلى مبدأي المماثلة والقياس ضمن ما يسمى (النظرية التفاعلية). ثُمّ مع مقترح أمبرتو إيكو في «السيميائية وفلسفة اللغة» (1984)، إذ دعا إلى توسيع الاستعارة خارج اللغة، لأنّ حصرها في المجال اللغوي يعطي «شعورًا بالفضيحة»، فأشار إلى استعارات بصرية وأخرى شمّية وموسيقية يمكن تفسيرها بالإحالة على تجارب بصرية وسمعية ولمسية وشمّية، طالما أنّ الاستعارة «آلية سيميائية تتجلّى في جميع أنظمة العلامات». لا يدّعي الباحث إلمامه بكل هذه العلوم المومأ إليها، ولا تجاوزها، وإنما بالأحرى يستأنس بها لصالح إغنائها عبر توسيع نظره المنهجي إلى الخطاب الاستعاري، واستكشاف ميادينه الجديدة؛ أو بعبارة أخرى، «توسيع نطاق عمل بعض المفاهيم البلاغية والتأويلية، إيمانًا بالمرونة والتحوُّل الذي يسمح به الاصطلاح وتغيُّر المفاهيم».
المنوال الاستعاري
بناءً على هذه الأطر المرجعية لعمل الاستعارة التي تتجاوز الجانب اللفظي- اللغوي إلى النسق التصوري، وما رافق ذلك من حيرة وقلق ومضايفة وإصرار في الذهاب والإياب، يحيط الباحث بالإطار النظري والمعرفي الذي يُرتّب عليه مقاطع أطروحته، ويقترح مفهومًا مركزيًّا بإمكانه توسيع مجال عمل التأويل الاستعاري، بل نظرية الاستعارة؛ وهو مفهوم «المنوال الاستعاري». يستعير مصطلح «المنوال» أو «النّوْل» من مجال صناعي أصلي؛ فهو مِنْسَجٌ خشبيٌّ يُنْسَج به وأداتُه المنصوبة تسمى أيضًا مِنْوالًا، أو خشبة الحائك التي يلفُّ عليها الثوب، والمِنْوال الحائك الذي ينسج الوسائد ونحوها، كما تدلُّ على ذلك المعاجم العربية (لسان العرب، الصحاح في اللغة، مقاييس اللغة، القاموس المحيط، جمهرة اللغة)، إلى مجال صناعي فرع يفيد نسيج الخطاب وسَداه من مجموع أفعال الكتابة الصناعية وما تفترضه من محاكاة وخيال وانتقاء واقتباس وتحويل، إلخ.
الخطاب استراتيجية؛ لأنَّ به تتّضح فاعلية المفهوم في تأطير بناه الاستعارية المجاوزة للجملة من جهة، ومن جهة أخرى في تتبُّع حياة الأنوال وحركتها عبر التاريخ الأدبي والثقافي، بسبب ما يتعرض له من تحوُّل وتأثير وتأثر. وإذن، لا معنى لمشمولات المفهوم داخل مجاله الاصطلاحي، إلا في ضوء الفعل بوعي وقصديّة، ولا معنى لكلّ ذلك إلا في سياق الخطاب، باعتباره «صناعة استعاريّة» تتضمن سلسلةً أو سيمياء من الاستعارات اللغوية وغير اللغوية، التصورية والرقمية والثقافية. وعليه، فإن المنظور المنوالي للاستعارة يتجاوز ما كان معروفًا ومعمولًا به: استعارة محسوس لمحسوس، أو استعارة معقول لمحسوس وغير ذلك، إلى استعارة شكل لشكل، وفكرة لفكرة، وإطار جمالي لآخر إلى غير ما يفترضه هذا المنوال، ولكن وفق مبدأ التشابه والملاءمة وليس التناكر والمنافرة، ووفق مبدأ الجدّة والابتكار عن الأصل وليس السلخ والاستنساخ والتشويه.
إنّه يستوعب مجموع الأنوال القولية في الشعر وغيره في مجال الكتابة النثرية والتعبيرية والصناعية والرقمية مما تزخر به حياتنا المعاصرة في كل مظاهرها المادية والمعنوية، وبالتالي يكشف عن حركيّة هذه الأنوال الاستعارية الجوّالة والمتموجة وتحقّقاتها الإجرائية المتعلقة بأصول المستعارات من أفكار، ومفاهيم، وقوانين، وأدوات، وإيقاعات، ورسوم وأشكال، إلخ. للتحقق من فرضية ونجاعة المنظور المنوالي الذي يطمح الباحث في أن يجعل منه نظرية واصفة لمجمل الأفعال الاستعارية تبعًا لعلاقاتها الناظمة (علاقة المشابهة، علاقة التناسب، علاقة الوظيفة المنوالية)، وتبعًا كذلك لمسعى مقصديّتها في توسيع فضاء الاستعارة، وبالتالي للانتقال من النسق التصوري إلى الاشتغال النصي، يهندس الباحث مشروعه وفق مبدأين رئيسين:
مبدأ تصوُّري يقدم الإنجاز الاستعاري باعتباره فعلًا استراتيجيًّا يقوم على اختيار الاستعارة منوالًا للتعبير والإبلاغ، وصناعة الخطابات جزئيا أو كليا.
مبدأ تجريبي وتقريبي يتوقف عند بعض مظاهر استعارة المفاهيم والنظريات، وانتقالها من علم إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، مع ما يفرضه ذلك من إشكالات إبستيمية ونقدية أدبية (مفهوم النصّ مثلًا). وهما مبدآن متساندان يُقوّم كلٌّ منهما الآخر في الذهاب ـ الإياب عبر مفاصل الأطروحة التي يدافع عنها الباحث بلغة دقيقة، تتنفّس عبر مجال مفاهيمي متنوّع وواضح القصديّة، مثلما تتخلّلها – في أحايين غير قليلة – عباراتٌ مجازيّةٌ، ولاسيما أثناء التحليل، تُخفّف من غلواء الاتساع المفاهيمي، بقدر ما تسند المجال التأويلي الذي تضيق عنه العبارات الكمّية الصارمة. ولا تغرب عنه شخصية المجتهد المسكون بهمّ التأصيل بدون إسقاطية أو انتفاء للهويّة وتبعية عمياء للآخر.
استعارات الشعر
ما حظُّ الشعر من هذه المقاربة المنوالية؟
لا خلاف في أنّ الشعر خطاب استعاري، وأكثر الفنون الأدبية احتفاءً بالاستعارة وتقليبًا لوجوهها حالًا ومآلًا، وقد أنزلته البلاغة العربية حظوة خاصّة. يقدَّم الباحث نموذجًا للمنوال الجمالي الفني الذي تمت استعارته في قصيدة «تَذَلّلْتُ في البلدان» لأبي مدين الغوث، التي يقول في مطلعها:
تَذَلّلْتُ في البُلْدانِ حينَ سَبَيْتَني وَبِتُّ بِأَوْجاعِ الْهَوَى أَتَقلَّبُ
تندرج القصيدة في إطار منوال الشعر الغزلي المستعار داخل التجربة الصوفية؛ وقد توقّف لتحليل هذا المنوال الجمالي الخاصّ وبيان مستوياته النصية عند مجموعة أدراج/ مدارج من الظاهري إلى العميق، ومن الفهم إلى التأويل، منفتحًا على تحليل المضمون والتاريخ والمعرفة بأحوال الرجال، ليستخلص أن الشاعر الصوفي استعار أبياتًا من القصيدة الأصل لقيس بن الملوّح، وأنزلها في سياق تداولي جديد ينزاح من الغزل العذري والخمريات إلى الغزل الصوفي، وهو ما تبيّنه على صعد المعجم واللغة والدلالة والمقاصد المرادة.
يبدو لنا من خلال التحليل الاستعاري المنوالي الذي يستثمره الباحث في مقاربة قصيدة أبي مدين الغوت، ما يلي: تبدُّل النّوْل عند تنقيله من حال إلى حال آخر، ومن غرض إلى آخر، ومراعاة شرط التناسب في الأساس الاستعاري المتحكم في تداخل النصوص من غير إسقاطية أو استنساخ، واستناد الاستعارة المنوالية إلى خلفية تتحرك في شكل تموّجات لا حدود لها، على نحو يترك أثرًا نوعيًّا آخر على دوال النص ومعانيه الجديدة.
وقد أدمج الباحثُ التعبيرَ الشعريَّ في صميم مقاربته المنوالية، سواء في إشارته إلى تنقيل الأنوال القولية في الشعر العربي، أو ظهور أنوال جديدة في الشعر تجاوزت منواله النظمي والتصويري المعهود، واقتراحه مدلولًا أداتيًّا موسّعًا للاستعارة يتجاوز مفهوم السرقات الشعرية. وعليه، فإن البلاغة الموسّعة التي يقترحها ستفيد الدارسين في تبيّن استعارات الشعر العربي الحديث والمعاصر، وما أكثرها من كلّ لون ونول، منذ أن انفتح هذا الشعر على الثقافات الأجنبية، واستوعب فلسفات العصر وأفكاره ومضامينه الجديدة، ومنذ أن أصبح الشاعر الحديث يجول في «البحار السبعة» بتعبير صلاح عبد الصبور. تلك الاستعارات لا تتوقّف بالشعر عند استعارة المضامين والأغراض فحسب، بل تتعداه إلى مجال أوسع يتعلق باستعارات القوالب والأشكال النصّية، والأطر الإيقاعية، والمواقف الشعورية والفلسفية، والتقنيات والأساليب الفنية المتنوعة المستعارة من تعبيرات فنية وجمالية وأدبية. وحتى الشعر الذي ينشط اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، إنستغرام، فايسبوك..) له استعاراته الخاصة به من عناصر مرئية وموسيقية ورقمية ضمن ما أصبح يعرف ـ مثلًا- بـ (Twitterature)، مع ما تطرحه حواملها من إشكالات أدبية وإبستيمية متشابكة وغير مسبوقة على مستويي الإنتاج والتلقي.

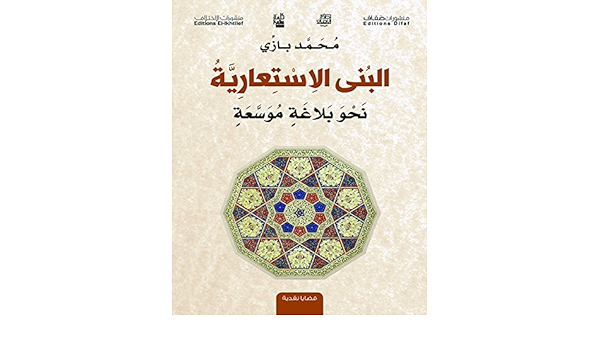
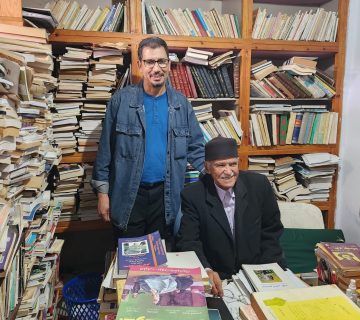
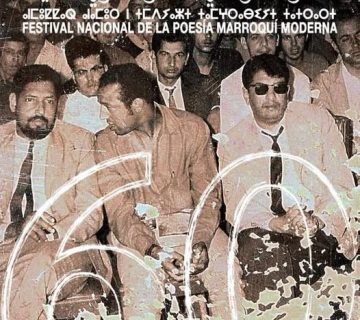

لا تعليق