أقبل معظم شعراء الحداثة المؤسسة في المجال العربي، على الكتابة عن تجربته الشعرية، من خلال ما يُصطلح بـ«السيرة الذاتية الشعرية». إذ شرع يدون نَثْرًا مراحل من هذه التجربة وعوالمها وأسرارها، وكل ما يتعلق بجوانبها المعنوية والفنية، وأطرها العبر نصية، وهو الذي راكم تجربة مهمة ورائدة وخلافية، وأخذ وعيه الكينوني يتغير في علاقته بذاته، ورؤيته وظيفته من جهة، وفي علاقته بفنه ومفهوماته ومراجعه، وأدوات عمله من جهة ثانية. ويأتي بدر شاكر السياب في طليعة الشعراء المحدثين، ممن كان يمتلك حساسية أسلوبية تعكس التوتر بين أناه المحدثة والوعي بواجب التحديث بشكل يعبر عن خصوصية برنامجه الشعري وأسئلته وأفقه المُجاوِز.
عبد اللطيف الوراري
دفاعًا عن الحداثة وبرنامجها الرمزي
ترك لنا السياب كتابات نثرية، هي في مجملها مقدمات لأحد دواوينه أو دواوين شعراء آخرين، ورسائل تبادلها مع أدباء عصره، ومقالات وحوارات وسجالات شارك بها في بعض المؤتمرات، بما في ذلك مؤتمر روما، الذي انعقد سنة 1961. وأكثر من هذا، كتب الشاعر ما يشبه اعترافاتٍ عن واحدةٍ من أصعب مراحل تجربته، عنونها بـ«كنتُ شيوعيا». فإلى جانب رسائله التي صدرت في سنوات متفرقة بعد مماته، ظهر للسياب هذا الكتاب عام 2007، وهو مجموعة أوراق نشرها في جريدة «الحرية» البغدادية عام 1959. وتشكل هذه الاعترافات في حد ذاتها- أيا كان السياق الذي أنتجت فيه- وثيقة من وثائق حياة السياب الأكثر وضوحًا، لأنها تحوي شذرات من يومياته بخط يده، وهي تزداد أهمية حتى في علاقته بالسياسة والسياسي. ومما يذكره السياب في علاقة الحزب الشيوعي بالشعر والشعراء، أن «الكابوس الأحمر» الذي ساد العراق منذ قيام الثورة، نسف كل أسس الشعر ومواضيعه. ويتساءل:»أين هي الشاعرة العربية العظيمة الآنسة نازك الملائكة؟»، فيما يغمز إلى عبد الوهاب البياتي بقوله: «صرنا نقرأ عشرين قصيدة من برلين و51 قصيدة وسواهما من الدواوين الحمراء السخيفة».
وفي المقدمة التي كتبها لديوانه «أساطير»، الثاني بعد ديوان «أزهار ذابلة» الذي بشر بحركة الشعر الحُر، ورغم قصر هذه المقدمة، كثف بدر شاكر السياب وعيه التنظيري، ووعى أهمية ما هو مقبل عليه، إذ ناقش فيها أبرز الملامح الجديدة التي تطبع القصيدة الحديثة، التي يمثلها ويسعى من خلالها إلى إحداث التغيير المنشود في الشعر العربي، ومن ثمة الخروج من النمطية السائدة إلى أفق الحداثة الناشئة.
وفي سياق تلك المقدمة، التداولي بالأحرى، يرسم السياب برنامجه الشعري في بدايات بحثه عن هوية جديدة إيقاعيا وثيماتيا وبنائيا، بعد أن يكون قد شرع في تخليص قصيدته من مؤثرات المناخ الرومانسي الطاغي، وهيأ ذائقة التلقي لاستقباله. وفي نظرنا، فإن هناك ثلاثة أبعاد يعبر عنها هذا البرنامج التأسيسي، لها علاقة بالنزوع السيرذاتي، التفرد والغموض والرغبة في معنى مبحوث عنه.
فمن جهة أولى، يؤكد على خاصية التفرد، ليس بالنسبة إلى وعي الشاعر الحديث بها، بل في علاقتها المتوترة بالمتلقي، وكأن السياب يريد من الأخير التحرر من جهاز القراءة القديم، والارتقاء بذائقته الفنية إلى ما تُمثله القصيدة الحديثة من إمكانات تعبيرية وشعورية خاصة من جهة، ويريد من جهة أخرى أن يرفع سقف انتظاراته بالقياس إلى مضمرات شعريته الذاتية.
ثُم يتطرق إلى مسألة الغموض، الذي لجأ إليه اضطرارًا، وبرره بالتكتم والشعور بالحرج وعدم البوح بكل شيء، وهو ما سيوجه مشروعه نحو الخطاب الرمزي والتباساته (رموز، أقنعة، حكايات خرافية..)، وينعكس من ثمة على أفق كتابته السيرذاتي، إذ كان على وعي بالرمز والرمزية مبكرًا؛ منذ أن اطلع على كتاب فريزر «الغصن الذهبي»، الذي ترجمه جبرا إبراهيم جبرا، ومنذ أن كثف قراءاته لرواد الشعر الرمزي الأورزبي (إليوت، سيتويل..). يقول السياب: «وهناك شيء من الغموض في بعض القصائد» ولكنني لست شاعرًا رمزيا وقد كنت مدفوعًا إلى أن أغشي بعض قصائدي بضباب خفيف، وذلك لأنني كنت مُتكتمًا، لا أريد أن يعرف الناس كل شيء عن حبي الذي كانت كل قصائد هذا الديوان صدىً له، وكثيرًا ما مزقتُ بعض القصائد التي كانت تشير إلى شيء تأبى هي أن يعرفه الناس». وربما لهذا الأمر علاقة بما كان يجمع الشاعر بلميعة عباس عمارة، التي رفضت أن يشير إليها مباشرة في شعره، فما كان منه إلا أن مزق بعض القصائد التي فيها شيء تأبى هي أن يعرفه الناس عن علاقتهما من جهة، ومن جهة أخرى كان عليه أن يغلف قصائد حبه هذه بضباب خفيف وغموض. ففي إحدى رسائله التي كتبها إلى خالد الشواف، التي يرجح أن يعود تأريخها إلى صيف 1946، ينعت السياب الغموض في شعره بـ«العقدة المسحورة التي أوجدتها يد العاطفة، في ساعة جنون، إذا انحلتْ فَقَد الطلسم ما كان يحمل من تمتمات عبقر».
وعدا الشعور بالحرج، لم يغفل أن يورد تفصيلةً مهمة تحمل القارئ على التعاطف معه، إذ قال: «فقدت أمي وما زلت طفلًا صغيرًا، فنشأت محرومًا من عطف المرأة وحنانها. وكانت حياتي، وما تزال كلها، بحثًا عمن تسد هذا الفراغ». وقد بقي السياب، طوال عقد الخمسينيات، يشعر بهذا الفراغ رغم زواجه، وبنفسه «رئة تتمزق» وقواه يتأكلها المرض، فيما كانت قصيدته تمتلئ بالرموز والأقنعة والوجوه الأسطورية، التي يحلم عبرها بالعود الأبدي، كأنها تعويض له عن ذلك الفراغ وقسوته في النفس والواقع معًا. وفي هذا السياق، لا نجد دارسًا تناول شعر السياب لا يشير إلى أنه «عقد العلاقة، في أعلى ما لها من المراتب الشعرية، بين «أبدية الرمز» الأسطوري، على نحو خاص، وحركية الحياة المندفعة بفعل الإنسان الحامل مصيره أنى اتجه، أو توجه»، على حد تعبير ماجد صالح السامرائي.
الأسطورة الشخصية
 اصطبغت تجربة السياب الشعرية، على غنى مصادرها وتنوع منحنياتها، بكل هذا المزيج المتنافر، وارتقت تعبيريا في مرحلتها الأخيرة إلى ما نصطلح عليه بـ«شخصنة الأسطورة»، إذ كانت أنا الشاعر منشغلة بخلق الأسطورة ونحت عوالمها الشخصية، ولم يكن وعي النهاية الحتمية الضاغط عليه بمنأى عما يكتبه ويتخيله، فانعكس ذلك على السجل التعبيري الذي طبعته حالات الأنا الذاتية بين الغناء والتفجع. فلم يكن بين الشاعر وما يحلم به إلا ما بين الأسطورة وظلالها من رماد الرمز وكثافة المعنى، ولاسيما أثناء «تجربة المرض» الذي فُجِع به وواجهَهُ بصبر أيوب.
اصطبغت تجربة السياب الشعرية، على غنى مصادرها وتنوع منحنياتها، بكل هذا المزيج المتنافر، وارتقت تعبيريا في مرحلتها الأخيرة إلى ما نصطلح عليه بـ«شخصنة الأسطورة»، إذ كانت أنا الشاعر منشغلة بخلق الأسطورة ونحت عوالمها الشخصية، ولم يكن وعي النهاية الحتمية الضاغط عليه بمنأى عما يكتبه ويتخيله، فانعكس ذلك على السجل التعبيري الذي طبعته حالات الأنا الذاتية بين الغناء والتفجع. فلم يكن بين الشاعر وما يحلم به إلا ما بين الأسطورة وظلالها من رماد الرمز وكثافة المعنى، ولاسيما أثناء «تجربة المرض» الذي فُجِع به وواجهَهُ بصبر أيوب.
وهكذا اعتكف مُبكرًا على الرمز الشخصي، وجعل له مدلولًا ذاتيا يعبر من خلاله عن معاناته التي واجهها في الحياة، ويداري به شقوته في الحاضر وعدم رضاه، مع ما كان يصاحب هذا الرمز من تناقضات، تترجح بين أضداد الصور، وتنم عن «هذيانات» المرض، بعضها يعود به إلى الطفولة والأم وجيكور وبويب، وثانيها يشده إلى شبح الموت وقوى الشر وهاوية العدم. بيد أن هذا الرمز الذي يصدر عن أنا الشاعر ويتلون برؤيا تراجيدية في وعيها بالتاريخ، كان في حقيقة الأمر يُعوض عن فراغ الشخص الواقعي لهذا الأنا في أواخر حياته، المفجوع بأثر المرض الجارف؛ فينقل التجربة الذاتية إلى تخوم اللاتشخصن، الذي يعبر عن تقلبات صميم الأنا الداخلي، إلى حد التشكيك في مدى تمثيله بوضوح لحياة الشاعر نفسه. لكن بدون افتراض غياب «الصدق التعبيري» لديه، فقد كانت تتردد، في كثير من المرات، صور الماضي وذكريات الذات والمعيش، التي كانت تُداخل وظيفية الرمز وتُخفف من تجريديته. بعبارة أخرى، يمكن القول إن السياب وإنْ كان يصر على التأريخ لقصائده، وكان ضمير المتكلم يهيمن عليها، فهو بميله إلى الرمز واستخذام الأسطورة، بدا كأنه يضع نفسه على مسافة واعية ومتوترة، تسمح له بالسخرية من ذاته، والحد من زخمها العاطفي كما عُرف به في مرحلته الرومانسية. وبالتدريج، أخذ يطفو على قصائده نوعٌ من التوازي بين حياة الشاعر وشعره، الذي ينعكس في أشكالٍ متنوعة من التعالق المباشر والضمني، بالنظر إلى خصوبة ثقافته وعالمه التخييلي وطول نفسه الملحمي، وهو ما كان ـ بتعبير صلاح فضل- «يباعد بينه وبين الطابع الغنائي السهل المنبثق من قرب الشعر من أحداث الحياة».
بحثًا عن السيرة الشعرية
في هذا السياق، تمثل «أنشودة المطر» (1960) لسان حال هذا الطور من التجربة السيابية، الذي أخذ يقطع مع الحساسية الرومانسية، وينفتح على السرد وينخرط أكثر في الوعي بحداثة العمل الشعري المفتوح، الذي وسم قصائده الذاتية، لكن ديوانيه «المعبد الغريق» (1962) و«منزل الأقنان» (1963) هما اللذان يُدشنان، بوضوح، طَوْرًا سيرذاتيا تزامن مع عودة الشاعر إلى جيكور، بعد خيبة أمله من رؤى المدينة، ومع تجربة المرض بما فيها من تألم ذاتي وشكوى مباشرة واقتيات على تداعيات الذكرى، وقد تخففت تجليات الرمز والأسطورة من بعدها الجماعي لتُعبر عن العذاب الفردي، الذي ابتلي به الشاعر، وتنقل العادي والمهمش إلى جوهر الخطاب، في ما هي تنزع ببنية القصيدة في توالي مقاطعها المرقمة أو المتوازية إلى السرد، الذي ينجز البعد الدرامي للخطاب ويواكبه. وقد شكل هذا الطور بعدًا آخر في تجربة الشاعر، بحيث «انفتحت فيها قصيدته على زمنين: زمن الحلم الذاهب متمثلًا بالماضي المستعاد، وزمن المعاناة حيث الألم الجسدي والوجع الروحي.
ففي قصائد دالة مثل «الأم والطفلة الضائعة»، «سفر أيوب»، «رحل النهار»، «الوصية»، «شباك وفيقة» وغيرها، إنما كانت تُشكل، بنسب رمزية متفاوتة، مراجع لحياة السياب وطفولته الماضية وتاريخ مشرط الداء اللعين الذي كان ينخر جسده من جهة. ولهذا السبب، ربما، آثر السياب في هذه المرحلة أسطورة «عوليس» أو «أوديسيوس» بطل الأوديسة الذي ضل طريقه إلى وطنه، وهو على ظهر سفينة في عرض البحر بقدر ما ضلها هو في مستشفيات لندن وبيروت والكويت. وفي مكان آخر، كانت هذه القصائد تعمل على بلورة «الأسطورة الشخصية» لأنا الشاعر، بعد أن تحول كثيرٌ من ذكرياته وأطوار حياته إلى رموزٍ كُليةٍ (بويب، غيلان، جيكور، وفيقة) ظهرت من خلال آليات اشتغالها أقل تجريدًا وأكثر شفافيةً، لأنه «ارتفع بحياته الشخصية إلى مستوى الأسطورة، حتى صار الشاعر والرمز، في فترته المأساوية خاصة، شيئًا واحدًا لا يمكن تجزئته»، وهو ما يُمثل «تلاحمًا نادرًا بين شعره وحياته» كما يقول علي جعفر العلاق.
وباصطلاحات فيليب لوجون، تشكل النوستالجيا، أو «القيمة في الماضي من أجل العثور عليها»، أبرز الحوافز التي دفعت الشاعر إلى كتابة سيرته شعرًا، وبالتالي عملت على تخييلها ليس فقط في عمر الشاعر الفيزيقي الذي توقف في يوم (24 ديسمبر/كانون الأول)، بل في كل أزمنة تلقي قصيدته، وذلك بعد أن يصير ذلك الماضي ضَرْبًا من الفردوس المحلوم به والآتي من المستقبل.


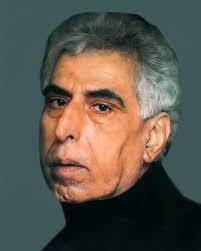


لا تعليق